الدولة والعولمة ماذا عن المستقبل ؟
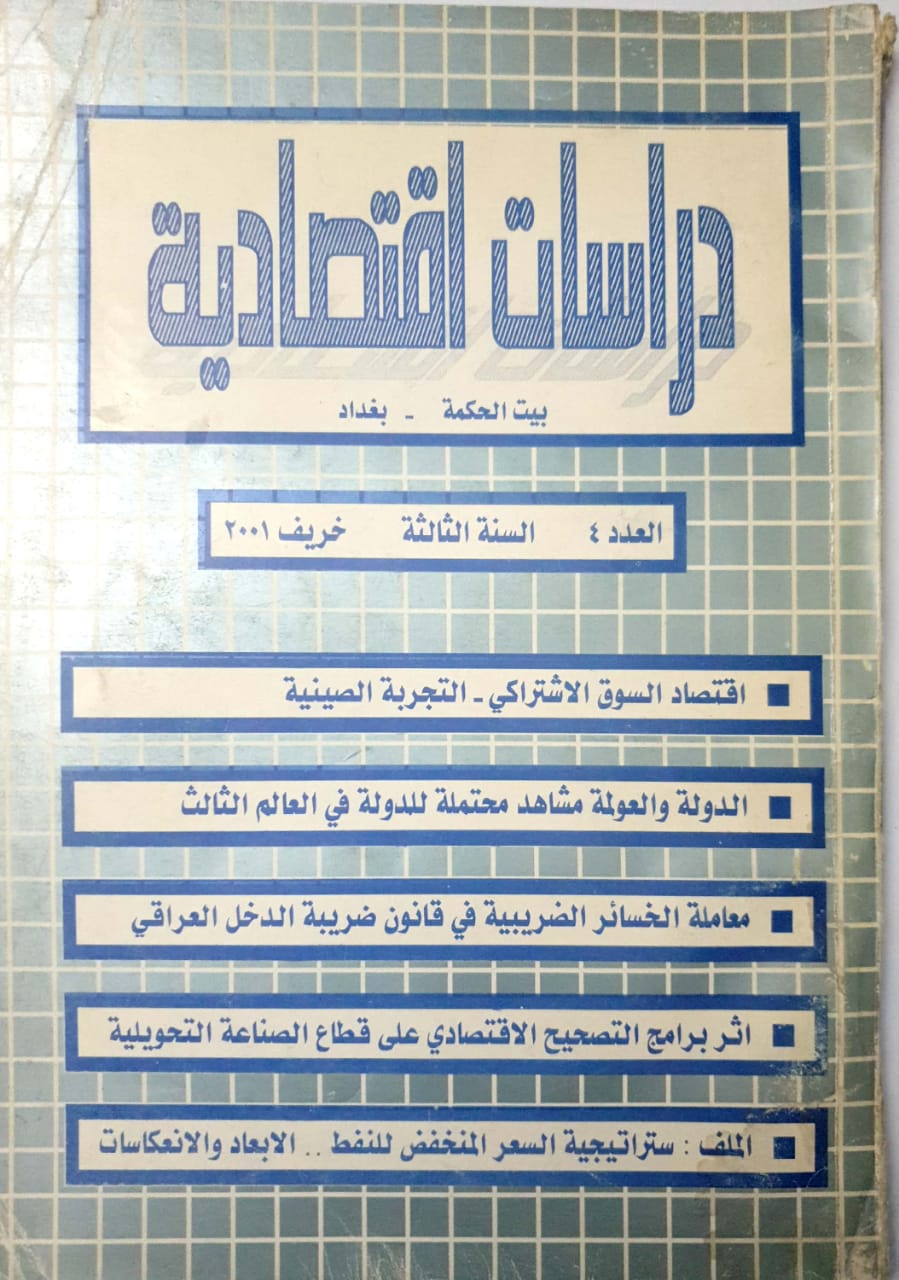
(1) مقدمة
حتى وقت قريب، كانت الدولة تعتبر القوة المحركة في النظام الدولي، بعدما شهد العالم نمواً ملحوظاً لدور الدولة سواء في البلدان المتقدمة أم في بـلدان العالم الثالث. وبالفعل كانت الدولة تشارك في صنع الأحداث والتحولات الحضارية والمادية الكبرى، وتمكنت الدولة عبر سيطرتها على موارد طبيعية هائلة من أن تسيطر على أهم النشاطات والمؤسسات الاقتصادية والأيديولوجية والاجتماعية في معظم المجتمعات، حتى قيل أن الدولة هي المسؤولة وحدها عن قضايا التنمية والأمن القومي والدولي. لكن الصورة اختلفت اليوم، فالدولة لم تعد ذلك الجهاز الكفء والوديع الذي يحمل مصالح الجميع على كتفيه، وفقدت الكثير من قواها وأسس السيطرة السابقة، وباتت اضعف من أن تواجه رياح العولمة، فانحنت لمطالب مؤسساتها وقبلت بشروطها، وسارت في الطريق الذي رسمه لها دعاة العولمة ومريدوها.
أن الهدف الأساسي لهذا البحث هو تبيان العلاقة ما بين مفهومي الدولة والعولمة. فالسؤال الأساسي الذي نحاول طرحه والإجابة عنه، عن العلاقة بين المفهومين، هل هما متفقان، سائران معاً ؟ أم هما متقاطعان، يتعارضان مع بعضهما ؟ وان كان ذلك، فما هي نقاط التعارض؟.. ومن الواضح أن السؤال المثار الدولة والعولمة منفصل فيما يتعلق بكل من نمط الدولة الرأسمالية أو ما يدعى بالدولة القومية، ونمط الدولة في العالم الثالث الذي تطلق عليه تسميات متعــددة منها التابعــة، الطرفيـة، الريعية، التحديثية، القطرية، غير المستقرة، الضعيفة… الخ. ولهذا سنحاول إثارة التساؤلات حول كلا النمطين ارتباطا بفهوم العولمة وآثارها عبر أقسام البحث التالية.
(2) حــول مفهوم الدولـة
ينبغي لنا ابتداء أن تشير إلى أن الدولة، اصطلاحاً، تنصرف لمعنيين متداخلين، ذلك الجهاز التنظيمي الذي تلجا إليه الحكومة أو السلطة كي تمارس احتكارها الاستعمال الشرعي للعنف، في حين يكاد يكون المعنى الثاني مرادفا لمفهوم المجتمع، وهو بذلك يعني إن المنظومة الاجتماعية كلها خاضعة للحكومة أو السلطة(1). و بهذا لا يتوافق المعنى الأول بما يحمله المعنى الثاني.
وعموما يمكن النظر إلى الدولة على أنها مجموعة من الأجهزة والمؤسسات المركزية تمارس سلـطتها طبقا لمــفهوم السيادة عــلى الإقليم الذي تدعي فيه لنفسها بالشرعية وبناء الأمة، وتطبيق القوانين المعايير والمعتقدات التي تربط هذه الأمة. والأصل التاريخي للدولة الحديثة هو ذلك النموذج الذي ظهر مع نشوء الرأسمالية في أوروبا، أما مفهوم الدولة في العالم الثالث فقد ظُهر بشكل عشوائي وانتقائي، وارتبط بتطور الرأسمالية «الطرفية» التي اجتاحت مجتمعات العالم الثالث مع الحركة الاستعمارية و بروز ظاهرة الإمبريالية ، فتزامنت عملية بناء الدولة في هذه المجتمعات مع تعميق تبعيتها. ويتفق معظم الباحثين على أن هذه المجتمعات لم تتمكن، بفعل الهيمنة والتبعية، من أن تصل إلى مستوى النضج المؤسسي الذي يهيـئ لــها خلق الجهاز السيــاسي الكفء، وعــجزت عـــن صياغة مشروعها التنموي المستقـل، فوقفت حيث هي من التخلف والتبعية.
يتسم هذا النمط من الدولة بسمات محددة تميزه عن نمط الدولة في المجتمعات الرأسمالية ، وتؤثر في الوقت نفسه في طبيعة الدولة ، وفي فعلها الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي، وتفرز عددا من المشاكل تحول دون قيام التوازن بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعية الأخرى، وتخلخل شبكات الضبط والمساءلة.
لقد نشطت خلال العقد التسعيني دراسات اهتمت بمسالة الحاكمية Governance، التي تعود إلى الفكر الليبرالي الجديد، والتي تنظر إلى الحكومة التقليدية نظرة شك متطرفة ترجع أصولها إلى ادموند برك (1730 – 1798) مؤسس النزعة المعادية للدولة. وقالت الليبرالية بغياب كفاءة الدولة في بيئة اجتماعية واقتصادية سريعة التغير، وهي السمة الأبرز للعولمة، وهنا ينبغي وفقا لهذه الرؤية أن تتحول الدولة إلى دور تنسيقي وتحكيمي في مجتمع يعمل وفقا لآليات السوق، والاستقلالية الذاتية للمجتمع المدني كآلية قادرة على توليد التضامن الاجتماعي. ولهذا قالت أن دولة الرفاهة هي مصدر الشرور، وأنها – أي الدولة – تؤدي إلى تكبيل روح المبادرة والاعتماد على الذات.
على هذه الرؤية استندت القوى الساعية إلى تقليص حجم القطاع العام، وتحديد دور الدولة، فعبرت التاتشرية والريغانية عن صعود اليمين المحافظ الذي عمل على إنجاز عملية التحول نحو القطاع الخاص من خلال خصخصة المشروعات العامة وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة وتدخلها. فجرت الخصخصة تحت شعارات سياسية واقتصادية. وتولت المؤسسات الدولية نقل عدواها إلى بلدان العالم الثالث. إلى جانب ذلك كانت هناك عمليات التكييف الاقتصادي التي يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فشكلت هذه المكونات الثلاثة – الفكر الليبرالي الجديد، الخصخصة، والتكييف الاقتصادي – نظرية العولمة، التي تتكامل مع بناء مؤسسي موجه وداعم لاتجاهاتها…
(3) حـول مفهـوم العولمـة
منذ عقدين أو يزيد قليلاً، دخلت العولمة مجال الفكر الاقتصادي والسياسي الدولي، وتأكد حضورها خلال التسعينات، فراح كل متحدث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الدولية يستخدم هذا الاصطلاح لتأشير خصائص بنيوية جديدة على المستويات كافة. لقد ظهر اصطلاح العولمة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت كمفهوم جديد إطار الفكر السياسي في كتابات الكندي مارشال ماك لوهن(2) و زبينغيو بريجنسكي(3) اللذين يصوران عالما تتقارب أجزاؤه لتغدو كـ«قرية عالمية» بفضل الثورة العلمية والتقانية (التكنولوجية ) أو كما ينحتها بريجنسكي «العصر التكنتروني».
إن نسبة الاصطلاح المكانية تؤشر حقيقتين أساسيتين هما: مشروعية دعوى البعض بان هذه الظاهرة تعادل معنى الأمركة، و كذلك تفسر الجو الفكري الذي ولدت فيه، ذلك أن الولايات المتحدة صانعة الثقافة المعاصرة، الثقافة الاستهلاكية أو المتدنية، ومنبع الفلسفة البراجماتية، ورمز الرأسمالية وأنموذجها الفريد . والتي تتكامل مع الفكر الليبرالي الجديد كناظم جوهري لها.
يمكن اعتبار العولمة نتيجة حتمية لاتساع مجال التعاملات الدولية حتى باتت الاقتصاديات الوطنية اكثر اعتمادا على الأسواق الخارجية(4). الأمر الذي يفرض قيودا عديدة، أهمها تلك المفروضة على السيادة الوطنية – كمسالة سياسية – فغدت السيادة مقيدة بمجموعة متشابكة من الالتزامات السياسية والاقتصادية للتجارة التابعة تدفقات رأس المال (5). لهذا يرى البعض أن التاريخ الاقتصادي ينبئ عن تماثلات ما بين العولمة والحوادث الاقتصادية المهمة قبل الحرب العالمية الأولى، حيث ازدهرت صلات الاقتصاد الدولي مع تدفق الاستثمار من العالم الجديد إلى العالم القديم(6). ووصل الأمر إلى الادعاء بان النشاط الإنساني المترابط يضرب بجذوره عبر القرون المختلفة، وان مدياته عبرها قد اتسعت ما بين البلدان المختلفة. غير أن الشكل الحالي للعولمة – حسب هذا الادعاء – قد اتسم بتشتت الإنتاج بين بلدان عديدة تبدو وكأنها مكان واحد ترتبط معا في الزمن الحقيقي(7). غير أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من موجات متزايدة باتجاه عولمة الاقتصاديات الوطنية ، في مجالات التجارة والمال والاستخدام المتزايد للتقنية وتغير مواقع الإنتاج ، إنما هو ناجم عن الثورة المتصاعدة في تقنيات الاتصالات وتزايد الاتجاه نحو تحرير الاقتصاديات بينما كانت العولمة في القرن التاسع عشر تتضح معالمها في التدفقات الهامشية للسلع و رؤوس ألا موال وانتقال الاستثمار بين الحدود في ظل رقابة محدودة عليه يمكن اعتبار أن العولمة في ذلك القرن كانت غير خاضعة لتشريع قانوني أو موافقة حكومية وبالتالي تختلف في إطارها المؤسسي عن ذلك الذي تشهده العولمة المعاصرة(8).
وبناءاً على ما تقدم، نجد الكثيرين يؤيدون اعتبار أن ظاهرة العولمة في مضامينها ليست أمرا جديداً ، سيما إذا نظرنا إليها من زاوية العلاقات الاقتصادية الدولية عبر الاتفاقيات التجارية والمعاملات التجارية والمالية وما يرافقها من التحالفات السياسية والعسكرية والتي كثيراً ما تصاحب مثل هذه العلاقات إن لم تكن الممهد لعقدها في تلك الأوقات. غير أن الأهمية النسبية لهذه الظاهر بدأت تبرز وبشكل واضح مع بداية العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي نتيجة قوة الدفع التي أصبحت تسير عمليات الترابط والاعتماد المتبادل والتي يسرتها ثورة الاتصالات وثقانة المعلومات التي اختزلت الأوقات وسهلت عملية الحصول على المعرفة، فأصبح الكل يتحدث عن «قرية عالمية» وعن اقتصاد عالمي، وغدت العولمة رؤية لعالم بلا حدود، تنظمه بدرجة رئيسية مفاهيم السوق وإلغاء القيود على تحركات رؤوس الأموال والبضائع والتقانة. وهذا هو المفهوم الاقتصادي للعولمة.
وعلى الصعيد الثقافي يرتبط مفهوم العولمة بفكرة التنميط Uniformalisation أو التوحيد Unification الثقـافي للعالم مــن اجــل التنمية . عبر استغلال ثــورة الاتصالات وهيكلها الاقتصادي ـ الإنتاجي المتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس الأموال الذي يجعل المفهوم الثقافي للعولمة بعداً اقتصادياً وإعلاميا، والشيء البارز الثقافة الأمريكية وهيمنتها على شتى صور الحياة والسلوك الإنساني(9).
أما على الصعيد السياسي فالعولمة تعني إن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد في السياسة العالمية بل توجد إلى جانبها مؤسسات ومنظمات عالمية وأخرى متعددة الجنسيات وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق الترابط والتداخل التعاون والاندماج، ويخضع مفهوم السيادة للتآكل تحت تأثير حاجة الدولة إلى التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والبنية الثقافية.
العولمة ظاهرة مركبة، وان كانت ذات بعد اقتصادي من الدرجة الأولى، كما أنها معقدة يتمازج فيها الاقتصاد والسياسة والأيديولوجية والثقافة والجغرافيا والتفكير المؤسسي والسكاني، يراد بها تحقيق التشابك على المستوى الدولي على حدودها بعد تذويب الأخيرة أمام الشركات متعددة الجنسية التي تؤلف العنصر الفاعل في الاقتصاد المعولم. كما يتم تحقيق التشابك والاندماج والتكامل عن طريق خلق علاقات دولية قائمة على تحرير التجارة والمعاملات المالية الدولية وانفتاح الأسواق الوطنية وربطها بالسوق العالمية، مع تبني استراتيجيات ذات أبعاد عالمية تعتمد التطورات العلمية والتقانية وبذا لم يعد خيار فك ارتباط بلدان العالم الثالث بالبلدان المتقدمة مطروحا كخيار قابل للتطبيق.
(4) العولمة والاعتداء على السيادة
يرتبط مفهوم الدولة بمفهوم السيادة التي تعني القدرة الكاملة للدولة على فرض سلطانها على أراضيها، والقدرة على وضع القرارات الملزمة للجميع، بما يهيئ لها أن تكون قوة فاعلة في السياسة الدولية، فلا سلطة تعلو عليها ما لم تكن قد قبلتها بإرادتها. وفي الوقت الحاضر، تسود وجهة النظر القائلة بان الدولة لم تعد تتمتع بالسيادة المطلقة كما كانت في السابق، بل أصبح التنظيم الدولي يحد بشكل كبير من حريتها، وبالتالي أضحى مفهوم السيادة مثار جدل و خلاف كبيرين(10).
إن فكرة السيادة تواجه اليوم تحديات هامة تعود إلى ظهور التجمعات الإقليمية والحاجة إلى تبني منهج مشترك في معالجة القضايا العالمية، وما أفرزته الثورة العلمية والتقانية وبخاصة ثورة الاتصالات والمعلومات، ونشاط الشركات متعدية الجنسيات، وظهور المنظمات الدولية والشبكة الواسعة من الاتفاقات وغيرها من العناصر التي تشكل شبكة الارتباط المتبادل(11) الآخذة في الانتشار مع تصاعد صيحات العولمة التي يحاول أنصارها من الليبراليين التقليل من أهمية السيــادة عبر تتبعهم التطــورات السريعة التــي طرأت علـى النظام السياسي العالمي، والذي تتفاعل فيه الدولة مع عالم تكون عناصره خاضعة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي توجه وتقيد سلوكياتها، وهو ما يجعلها تفقد دورها المؤثر في العلاقات الدولية. مقابل ذلك ، ينمو بشكل واضح نشاط المنظمات والهيئات الدولية. فالسيادة عند منظري الاعتماد المتبادل من الليبراليين باتت قضية غير مهمة طالما أنها لا تنطوي على انعزال أثرها عن آثار غيرها، فقد تكون دولة ذات سيادة لكنها تعتمد على غيرها من الدول. إن هذا الامتهان المقصود لمفهوم السيادة و التشكيك في أبعاده هو تقليل من شأن المفاهيم التي تشكل أبنية مفهومية منتجة تشكل وتحكم و تضبط السلوك الاجتماعي.
لكن الأمر الواضح في ظل العولمة أن طبيعة السيادة وأهميتها لابد وان تتغير وان ظلت بعض أركانها ثابتة. وعلى سبيل المثال، نجد أن ثورة الاتصالات و المعلومات تجعل تأكيد السيطرة الإقليمية أصعب في حالات معينة، واقل صلة بالموضوع في حالات أخرى، فلم تعد الحدود تحول دون انتقال المعلومات، التي تحطم الحدود السياسية وتعمل على توحيد السوق الخاص بالمعلومات فتعاظمت قوة الشركات التي لا تنفك تخرب سيادة الدول(12)، وبدا تسارع التطور التقاني أسرع من تطور الأجراء الأمني الذي قـــد تتخذه الدولة لصيانة سيــادتها، وهذا ما جعــل والتر ب. رستون يتكلم عن أفول السيادة .
أما إذا نظرنا من زاوية الدور الذي تلعبه الدولة ذات السيادة في العلاقات الدولية، لوجدنا هذا الدور يتعرض لمنافسة من قبل قوى أخرى هي الوحدات الاقتصادية الدولية والشركات متعدية الجنسيات والحركات الاثنيـة والـدينية وما شابه(13). وهذه المؤسسات الدولية وان لم تصل بعد إلى إلغاء الدولة فإنها تشكل مؤسسات جنينيه للنظام الدولي المطلوب من الرأسمالية العالمية، كما أنها لا تملك قوة فوق الدول التي تكونها، ومع ذلك فقد أصبح هذه المؤسسات قوة ذات تأثير متزايد في العالم، بحيث يمكن القول بان الدولة لم تعد القوة الوحيدة التي تحتكر صناعة القرارات في العلاقات الدولية كما كانت تفعل خلال القرون الأربعة الماضية(14) . مع ذلك نجد البعض يتحدث عن ظهور بنية جديدة لحكم عالمي، ويدعو آخرون من أنصار العولمة إلى حكومة دستورية شاملة وعالمية Global polity والى كيان سياسي أو مجتمع عالمي يعمه الاستقرار والرفاهية تختفي فيه الروح القومية والعرقية والاثنية والمصلحة القومية للدول، و تبرز مكانها روح «المواطنة القومية». هذه الرؤى – كما يرى نايف علي عبيد – تبقى تصورات طوباوية تقترب من جمهورية أفلاطون و المدينة الفاضلة للفارابي وأعمال توماس مور وفرانسوا رايليه (( لأنها تتجاهل ديناميكيات الصراع الدولي الذي تفرزه مختلف التناقضات الدولية، إن كان من حيث المصالح الذاتية، أو من حيث الهويات القومية وغيرها.. فالدولة الوطنية ما زالت قوية وان ضعفت سيطرتها على الأفكار، ولكنها تظل مسيطرة على حدودها و حركة الناس عبرها)) (15).
على الرغم من أن الذين تتبعوا ” دراما ” تفتت الدول خلال العقد الماضي كانوا محقين في أن العولمة فتحت زمن الانفصالات على أساس أن المتغير الاقتصادي العالمي هو الدافع وراء هذه الحركة ، فان القضية لا تعدو أن تكون تكريسا لمفهوم الدولة. إن العولمة فيما تعنيه من زيادة الاتصال بين الأمم تؤدي حسب ما يرى باسكال يونيفاس إلى عدم الاستقرار بسبب الانفتاح بحيث يجري البحث عن الهوية والجماعة، لكن ومع أن التأكيد غالبا ما يجري لهوية يعتقد أنها ضائعة وسط تجمع دولي كبير إلا أن السبب في رأيه يبدو اقتصاديا أكثر منه الدفاع عن هوية مهددة بل ((الرغبة في عدم تحمل الحياة المشتركة مع الآخرين لان الجماعة تعتقد بأنه من الأفضل لها أن تعيش وحدها لتستمتع بثروتها التي يشاركها فيها الآخرين دون وجه حق))(16) و يسوق هذا الكاتب عددا من الأمثلة للتدليل على صحة رؤياه فيما جرى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و يوغسلافيا حيث تفتّت إلى أمم متنافسة . وطبقا لهذا الرأي تصبح العولمة قوة دافعة باتجاه انتشار ظاهرة الدولة ، وتصبح الرغبة في البحث عن المقربين والجماعة الأقرب بدفع المصلحة الاقتصادية تياراً يعم العالم مُمثلا في السباق نحو الحجم الأصغر والنظام السياسي الرشيق(17)، لضمان موضع منافس على الساحة العالمية(18) .
ولا يختلف الأمر بالنسبة للتجمع ذلك ((إن التفكك مثل التجمع يحكمهما السبب نفسه أي المصلحة))(19).. ((فمن بولندا إلى المغرب ومن تركيا إلى الجمهورية التشيكية تسود الرغبة في الانتماء إلى أوروبا ورغم الاختلافات التي بينهم فإنهم يجمعهم سبب واحد وهو أنهم يأملون جميعا بان يؤدي انضمامهم حالا إلى نتائج مفيدة بالنسبة إلى الإنتاج الوطني)) (20). وعليه يمكن أن نستنتج إن التجمع أو اتجاه التكامل يدعم قدرة الدولة في أداء وظائفها من خلال ضم قدرة غيرها إليها وان كان يقلل من عدد الدول على خارطة العالم.
إن منظمة التجارة العالمية تواجه تحديا أساسيا عندما تريد التعامل مع مسائل تعتبرها الحكومات خاصة، مثل حقوق العمال وحماية البيئة وقيود الاستثمار وقواعد الاحتكار والمنافسة، كلها قضايا مثيرة للجدل السياسي لان المنظمة تعي تماما بأنها تتطفل على ما تعتبره الحكومات سياسة داخلية. وهنا يكمن المأزق الأساسي الذي تعاني منه المنظمة وهو صعوبة التوفيق بين ما تعتبره منافي لقواعد المنافسة الدولية وما تعتبره الحكومات تعديا لمفهوم السيادة الوطنية.
أما منظمة الدول السبع الصناعية فقـد طرحها البعض كإحدى المؤسسات المرشحة لأخذ وظيفة الدولة(21). فهي وكما أشرنا لا تعد إلا تكريسا لمفهوم الدولة في وحدات اكبر أقوى، وان هذه المؤسسة وان شكلت كتلة إقليمية ضخمة تحت قيادة مؤسسة جديدة هي مؤتمرات الدول السبع فأنها خاضعة لصياغات تناسب ميزان القوى داخلها لصالح الولايات المتحدة. هذه المؤسسة لا يمكنها أن تكون بأي حال من الأحوال إطارا سياسيا وقانونيا يحظى بالشعبية التي تؤهلها لتحقيق المساعي الحقيقية للنظام الدولي الجديد الذي يستهدف حماية رأس المال المسيطر على الصعيد العالمي.
وقريب من ذلك، ادعى البعض أن المنظمات العالمية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها هي بداية تكوين مثل هذا الإطار، بل إن سلسلة المؤتمرات التي نظمتها المنظمة اتخذت فيها السياسات الوطنية أبعادا دولية متزايدة التأثير بحيث اخذ يتبلور ما يمكن اعتباره تنسيقا حكوميا على المستوى العالمي. وفي دراسة أعدتها الأمم المتحدة عام 1995 قدمت برنامجا مسهبا للسبل التي يمكن من خلالها تحقيق إدارة شمولية مثلى للعالم ، كان جوهر هذا البرنامج قائما على إصلاح مجلس الأمن الدولي ، وخلق مجلس للأمن الاقتصادي كمؤسسة تكمل عمل الأول، إضافة إلى جعل منظمة الأمم المتحدة أكثر ديمقراطية وأكثر قدرة على اخذ زمام المبادرة على المستوى الدولي(22).
وبحسب ما نرى أن مثل هذا التقنين يصطدم بحواجز يتعذر تجاوزها ، بل إن الأمر الأكثر احتمالا أن المصلحة العامة العالمية قد تتوافر بصورة فاعلة ليس في ظل حكومة عالمية، وإنما بمجرد اتفاق بشان مجموعة مناسبة من أنظمة الاستقرار السياسي التي تكون عادلة لجميع الأطراف وتوفير الآليات المناسبة لتطبيقها بعدما يتم تعديل ميزان القوى داخل المنظمة وجعله أكثر عدلا في تمثيل مصالح بلدان العالم الثالث، إن فكرة الحكومة العالمية تبدو براقة حد الإبهار، رغم إنها تواجه مشاكل مع الواقعية و إن كان البعض يتصورها ممكنة التطبيق(*) .
(5) اوهماي والدولة المناطقية
مع اقتراب نهاية الألفية الثانية كثرت التخمينات والتكهنات عن نهاية الأشياء، وربما تكون أطروحتا فرانسيس فوكوياما عن «نهاية التاريخ»(1992) و كينيشي اوهماي عن « نهاية الـدولة القـومية» (1995) الأبرز من بين سيل النبوءات المبالغ فيها عن نهاية كل ظاهرة أو مؤسسة أُنشأت بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى قدر تعلق الأمر بالدولة وجدنا من الضرورة التعرض لأطروحة اوهماي، وسنعتمد على كتابه «نهاية الدولة الإقليمية وبزوغ الاقتصاديات القومية»(23) .
يدعي اوهماي أن العالم يعيش نهاية الدولة القومية التي أضحت بفعل قوى العولمة محض خرافة بالية فقد معها رجال السياسة كل قوة مؤثرة لصالح القوى المعولمة. فعلى سبيل المثال تتوافر لدى الشركات إمكانية التأثير في السيادة بفعل تفوقها الاقتصادي على الدولة، والأخيرة لم تعد سوى صغيرة جدا (أو قزمية)، فتقهقرت إلى ما كانت عليه في العصر التجاري (الماركنتيلي)، وبدت في ظل العولمة قليلة الكفاءة بعد أن تبين عجزها من الناحية الاقتصادية تحت وطأة تسارع التغيرات وبخاصة اعتبارات المصلحة الفردية، ثورة المعلومات، خيارات الاستهلاك، المطالب الشعبية، الاعتبارات السياسية، هذه المتغيرات جعلتها اقل استجابة للتحديات الجديدة.
إن القضية الأساسية بالنسبة للدولة القومية هي قضية السيادة، وبالنسبة لعالم بات كقرية عالمية فان المناطق الاقتصادية الطبيعية التي يسميها اوهماي دولا مناطقية Regional State (مثل تايوان، سنغافورة، هونغ كونك، جنوب الصين، وادي السليكون، جنوا، مثلث البحوث في كوريا، سان دييغو …..الخ ) تعتبر محدودة الحجم جغرافيا وسكانيا، إذ يتوقع أن تضم ما بين (5-20 ) مليون نسمة، إلا أنها ضخمة اقتصاديا، ولكن لا تسمح بان يتقاسم المستهلكون والمواطنون العوائد المتحققة فيها ، هذه الدول قد تقع أو لا تقع داخل حدود دولة معينة، وان كان ذلك، فانه راجع إلى الصدفة التاريخية.
ويصل بنا اوهماي إلى القول بان الدولة القومية تواجه ضعفا في قدرتها على التحكم في الاقتصاد بالشكل الذي يضيق عليها هامش الخيار الاقتصادي، الذي بات يُفرض من قبل وحدات اقتصادية (شركات أو دول مناطقية) موجودة داخل حدودها بحيث باتت الدولة أسطورة تفقد كثيرا من صور الماضي. فتنتهي الدولة القومية غير القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي ، على اعتبار ان الشعوب تتسابق لرفع نصيب الفرد من الناتج القومي، ويتوقع أن يتزايد عدد الدول المناطقية في إندونيسيا بفعل تفتتها إلى دول عديدة.
وفي معرض اعتراضه على أفكار اوهماي هذه، يؤكد انتوني جيدنز(24) أن اعتبار الدولة القومية والحكومة فكرتان باليتان أمر يجانب الصحة ، فـما يحـدث الآن أن كلا المفهـومين يتغير بفعل قوى العولمة ، ويتخذ هذا التغير المسارات التالية التي تؤثر في النظام العالمي:
– المسار الأول: ينأى بعيدا عن الدولة القومية التي تمارس إدارة اقتصادية قوية نابعة من أفكار الاقتصادي جون مينارد كينز .
– المسار الثاني: يتقهقر بالدولة تحت تأثير العولمة نحو أشكال جديدة وإمكانيات مستحدثة لتجديد الهويات المحلية، ومن دون اعتبار أن القوميات المحلية تفتيتية بالضرورة، فقد تتحول إلى كيانات مستقلة داخل الكيان القومي الأكبر.
– المسار الثالث: يبدو أفقيا بحيث تعمل قوى العولمة على خلق مناطق ثقافية واقتصادية جديدة تتقاطع مع الحدود القومية، فتندمج أجزاء من قطا لونيا وأجزاء أخرى من أسبانيا (برشلونة) في منطقة تمتد حتى جنوب فرنسا.
و النتيجة التي يصل إليها جيدنز هي أن السيادة أصبحت مسالة نسبية لان الحدود باتت أكثر تداخلا من أي وقت مضى، على الرغم من عدم اختفاء الدولة القومية.
ويمكن أن نضيف ، إن العولمة تتقاطع مع مفهوم الدولة من دون أن تصل إلى نفيها، فالخطاب الأساسي للعولمة هو نقل اختصاصات وسلطاتها إلى مؤسسات تفترض عالميتها. إن اتجاهات العولمة ومؤسساتها تقود إلى تقليص وظائف الدولة بشكل واضح، من دون أن تعني خلق هوية وشرعية ما فوق قومية فكلا المكونين لا يزالان مفقودين على الصعيد العالمي .
(6)الشركات متعدية الجنسيات : الفاعل الجديد
قد يبدو القول اقل من الحقيقة، أن الشركات متعدية الجنسيات هي الداعمة لاتجاهات العولمة والمنتفع من مساراتها، لأنها القابضة على كافة مجالاتها، فتطرحها كبضاعة تروجها ضمن بضائعها التي تحمل وبقوة علامة لحرية فوق قومية، بدلا من نموذج اقتصاد الدولة -الأمة القائم على بنى هرمية قومية لاتخاذ القرارات الصناعية وحلقات الإنتاج ، مستفيدة في ذلك ، بل مستغلة فيه، قدرتها على التكيف مع المعطيات التقانية وبخاصة في مجال تجزئة عمليات الإنتاج في الزمان والمكان لتتخذ لها موقع دائم في التشريعات الوطنية عبر دفع السلطة للمساهمة معها في خفض الكلفة والتوفير في الضرائب وتفادي ضغوطات النقابات من دون أن تتعرض هذه الشركات لأية محاسبة وطنية أو عالمية.
تظهر بيانات المنظمات الدولية تعاظم عدد هذه الشركات واتساع هيمنتها فقد ارتفع عددها من 11000 شركة تتحكم بـ 82000 شركة فرعية، تهيمن على 25%من حجم التجارة عام 1970 ، إلى 37500 شركة تتحكم بـ 207000 شركة فرعية تتعامل بأكثر من التجارة الدولية عام 1990 . وطبقا لتقرير الاستثمار لعام 2000 فان عددها يربو على 63000 شركة تدير 690000 شركة فرعية، وان اكبر مائة شركة عالمية وظفت أكثر من ستة ملايين شخص وتجاوزت مبيعاتها ترليون دولار ، تركزت في الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية والسيارات والبترول والكيماويات والمستلزمات الطبية(25) .
. إن هذا الازدهار هيأ للشركات متعدية الجنسيات أن توسع من سيطرتها على الإنتاج والتسويق على نطاق عالمي(26) . بحيث دفع هذا البعض إلى القول بان ((نشاط الشركات متعددة الجنسيات يؤدي إلى إقامة نظام إمبريالي عن طريق نظام مركزي لإصدار القرارات، وخلق تقسيم للعمل بين الأمم يناظر تقسيم العمل الموجود بين مستويات مختلفة من الجماعات داخل المجتمع الواحد )) (27) فتبلورت فكرة مؤداها (( وجود نسق سياسي عالمي يحمي الرأسمالية العالمية … وقد صاحب ذلك ظهور سوق عالمي … وخلق طبقة عالمية لديها وعي عالمي …إن روابط قوية تظهر بين رأس المال هنا و هناك من اجل إقامة بناء فوقي للنظام العالمي))(28) هذه الطبقة أو الفئات فوق القومية في العالم الثالث لها سمات مختلفة تماما وان تعمقت حدة التناقضات الطبقية و تمايز وضع الطبقات (30)، بحيث تتضاءل إمكانية التعميم .
ليس جديدا القول أننا في الوقت الحاضر نعيش عصر الشركات بفعل تحول ميزان القوى لصالحها ، الذي يتأتى – وبشكل أساسي – نتيجة قدرة الشركات على فرض عقوبات اقتصادية على بلاد بعينها ، وبناء أحلاف فوق قومية بين مختلف الشركات . وبفضل الثورة العلمية والتقانية توافرت لها القدرة على وضع إستراتيجياتها على نطاق كوني ، ومكنتها من استحداث وتوجيه التقانة، وتشتيت الإنتاج. ولعل من ابرز المتغيرات المعززة لقوة الشركات نجاحها في إقرار اتفاقية الاستثمار الدولية بدفع ومباركة منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD . وبفضل هذه الاتفاقية جرى تسهيل الاستثمار الدولي للشركات في كل مكان في العالم ، وتقليل حجم المخاطر التي قد تصيبها في حالات التأميم ، ووفرت إمكانية وقوفها والدول على قدم المساواة أمام المحاكم الدولية. أضف إلى ذلك ، ما تحظى به الشركات من دعم وإسناد يوفره صندوق النقد الدولي حيث يقدم الضمانات لنشاطها فضلا عن تلك الأطر المستحدثة في ظل جولة أورغواي ومنظمة التجارة العالمية .
إن الشركات متعدية الجنسيات تهدد الدول القومية الضعيفة ، فتتدخل في شؤونها الداخلية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد تصل حد إنجاح أو إسقاط هذه الحكومة أو تلك .لكن يبقى التهديد الأكثر خطرا في مجال عمل السياسات الاقتصادية، فشعارات الخصخصة والليبرالية والسوق العالمية الواحدة ورفع القيود والحواجز الجمركية، كلها مرتكزات نظرية لتبرير نظام اقتصادي تكون فيه الشركات لاعبا وحكما .
(7) ما قبل الخاتمة : ماذا عن المستقبل ؟
إن ابرز مظاهر العولمة هي محاولة إسقاط نظام غربي من القيم والمعايير والأنماط الثقافية والسياسية والاجتماعية على العالم. وإذا ما تم اعتبار الأخير وحدة اقتصادية واحدة فان مركزها سيكون حتما مجموعة البلدان المتقدمة القابضة على عملية التراكم الرأسمالي ، وتتراتب بقية البلدان بعدا عن المركز يحكمها في موقعها مدى ما يلعبه اقتصادها في الاقتصاد العالمي ومستوى نموها الاقتصادي ، ولهذا تحتل الولايات المتحدة مركز المنظومة، فباقي الدول السبع الصناعية، فالدول الصناعية الأخرى التي تتميز بنمو رأسمالي عالي، ثم تأتى البلدان الصناعية الجديدة (كبلدان النمور الآسيوية) واخيرا تتحولق المجموعة الأكبر من بلدان العالم الثالث فتكون أبعدها عن المركز أكثرها تخلفا وفقرا . في هذه المنظومة تلعب المؤسسات الدولية والشركات دورا حيويا كونها تمثل أدوات الرأسمالية في تحريك هذه المنظومة. وفقا لهذا النظام المعولم تتحدد مواقف الأعضاء المنظوين فيه طبقا لاعتبارات عديدة خاصة بكل منهم يتحدد بموجبها موقع الدول والشركات متعدية الجنسيات داخل المنظومة المحكومة بعلاقات التبعية واعتبارات القوة والتنافس بينها، واليّة التوسع الرأسمالي المتسم بعدم التكافؤ. وحتى لو اعتمدنا أي من وجهتي النظر الأكثر تباينا، ونعني بهما مدرستي الاعتماد المتبادل والمدرسة الماركسية المحدثة، فان الربط الإيجابي أو السلبي بين مصالح الدول يعني نظاما تميل فيه الدول لان تصعد أو تهبط سلم الوضع الدولي طبقا لاعتبارات خارجة عن إرادتها ، تخدم في مجملها حركية النظام .
إن وعي الماضي واستقراء مضموناته، يشكل عاملا أساسيا في فهم الحاضر واستشراف المستقبل ، وبالقدر الذي يتم فيه إدراك ذلك تتوكد رؤية الحاضر والمستقبل معا . إن المشاهد المؤملة للمستقبل عديدة ومتباينة، وعموما يمكن تصور أربعة مشاهد (سيناريوهات) لاستشراف مستقبل الدولة في ظل العولمة والتي تعرضنا لمعظمها صراحة أو ضمنا فيما سبق.
المشهد الأول (مشهد التـفتت): الذي يري أن الدول سوف تتفكك إلى دول قزميه في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، وهذا المشهد اقرب إلى تصورات تيار ما بعد الحداثة.
المشهد الثاني (مشهد اللادولة): الذي يعتمد رؤى و تصورات مبالغ فيها عن قدرة المنظمات الدولية – وبخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن – على الحلول محل الدولة ذات السيادة التي ستذوي. هذا المشهد يتجاهل حقيقة أن هذه المؤسسات تستمد وجودها من الإجماع الدولي حولها لا من ذاتها ، وتفتقد لأهم مكونات الدولة أي الهوية والشرعية.
المشهد الثالث (الدولة المعولمة): الذي يرى تضاؤل أهمية الدولة ووظائفها بفعل تسارع خطى التغير التقاني وما تفرزه العولمة أو تعزز اتجاهه.
المشهد الرابع (المشهد الواقعي): الذي يرصد تغيرا في طبيعة الدولة في ظل العولمة، وهذه المقاربة المستقبلية هي الأقرب احتمالا – من وجهة نظرنا – فالعولمة ، فيما تعنيه أو تفرضه إن الدولة لم تعد الفاعل الوحيد على الساحة الدولية فإلى جانبها نجد مؤسسات وجماعات دولية تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والاندماج، وهذا ما يدفعنا إلى القبول بفكرة إن مبدأ السيادة قد تعرض للتغير ، لكن الثابت لنا أن العولمة لا تستهدف بالضرورة نفي الدولة ، فالخطاب الأساسي لها هو اعتماد الاختيار الخاص بدلا من الاختيار العام ،أو اختيار السوق بدلا من اختيار الحكومة. وهي بذلك تفرض نمطا جديدا من الدولة يقوم على فكرتين أساسيتين هما:- إلغاء القيود مع السوق العالمية والقبول بمضامين تحرير التجارة، وتحرير الدولة من التزاماتها الاجتماعية. أن الفكرتين مترابطتان، ذلك أن السير في ركب العولمة يفرض على الحكومات المحافظة على مكانها المنظومة المعولمة عبر التنافس والاقتراب من المركز. فهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال التخفيف من سيطرتها على اقتصادياتها فتتراجع الكثير من أدوارها وبخاصة في تامين شبكات الضمان الاجتماعي ومعالجة فشل السوق.
هذا المشهد هو ما نشهده الآن، لكن وماذا عن ما بعد العولمة ؟ إن التهديد الذي أصاب دولة الرفاهة في العالم المتقدم من خلال تركيز مجهودات الدولة على القبول بفروض المشهد السابق قد اقلق الناخبين في تلك البلدان، فعبر هؤلاء عن حرصهم على دولة الرفاهة من خلال حجب تأييدهم عن الأحزاب الليبرالية و الرجوع إلى الأحزاب ذات الميول الاشتراكية و العمالية. وفي هذا الحدث المهم سيناريو جديد يتداخل مع السيناريو الرابع يدعي بان الدولة في البلدان المتقدمة ستتبنى سياسات جديدة تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ، وستعتمد السياسة الاقتصادية على نوع هذا التوازن.
أما الدولة في العالم الثالث فإنها ستسير في المشهد الرابع وتستمر في تفكيك نفسها وتبني قواعد العولمة وتسمح للمؤسسات الدولية بالعمل داخلها وتوفر البيئة المناسبة لعمل الشركات متعدية الجنسيات. لهذا ستدنى قدرة الدولة على استشراف المستقبل واختيار البديل الأمثل لموجهة تحديات العولمة ، والمحصلة النهائية انها ستظل تابعة، خاضعة لراس المال الأجنبي، عاملة على إدامة هيمنته، تماما كما تريدها قوى العولمة. لكن دون أن ننفي احتمال قيام بعض المبادرات لتغيير الوضع، وان كان فالأمر لا يتجاوز المستويات القطرية.
الهوامش والمصادر
(1) جياكومو لوشيا ني ، مقدمة القسم الثاني من كتاب ( الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي ) ج 1 ، غسان سلامة ( محرر) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1989 ، ص 238
(2) Marshal H. Mcluhan, Understanding Media. The Extensions of Man, McGraw Hill, New York, 1964.
(3) زبيغنيو بريجنسكي ، بين عصرين : أمريكا والعصر التكنتروني ، ترجمة محجوب عمر . دار الطليعة ، بيروت . 1980 .
(4) Douglas Johnston (ed..) : foreign policy into the 2lst century : The U.S. Leadership challenge , CSIS ,Washington D.C. ,1996 p.126.
(5) Op.Cit. P. 129
(6) Barbara Parken , Globalization and Business Practice , SAGE publications , London , 1998 ,P . 7.
(7) Kofi A.Annan, Partnerships for Global Community, annual Report on the work for Organization, New York, UN, 1998 , P. 52 .
(8) M.Sakbani, Regionalization and Globalization, in: UNDP, Cooperation South, No. 1, 1998, P. 6 .
(9) السيد احمد عمر ، إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (256) ، حزيران . 2000 , ص 74-75 .
(10) سعد حقي ،خيارات العرب حيال العولمة ، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر الاقتصاد الخامس :العولمة وآثارها المحتملة على الاقتصاد الأردني والعربي ، عمان( 23-24 ) أيار ، 1999 ، ص 5 .
(11) الكسند كينج ، وبراتراند شنيدر ، الثورة العالمية الأولى ، ترجمة وفاء عبد الاله ، مركز دراسات الوحدةٍ العربية ، بيروت ، 1992 ، ص 47 .
(12) سعد حقي ، المصدر السابق نفسه ، ص 6 .
(13) عدي صدام حسين ، عالم ما بعد الحرب الباردة : دراسة مستقبلية ، أطروحة دكتوراه ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1998 ، ص 128 .
(14) عبد الخالق عبد الله ، العالم المعاصر والصراعات الدولية ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 1989 ، ص 30 .
(15) نايف علي عبيد ، القرية الكونية : واقع أم خيال ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (260) ، تشرين الأول ، 2000 ، ص 145 .
(16) باسكال يونيفاس ، إرادة العجز : نهاية الطموحات العالمية والاستراتيجية ، ترجمة : صالح السنوسي ،منشورات جامعة فان يونس ، بنغازي ، 1998 ص 105 .
(17) المصدر السابق نفسه ، ص 121 .
(18) المصدر السابق نفسه، ص 122 .
(19) المصدر السابق نفسه، ص 136 .
(20) المصدر السابق نفسه، ص 138 .
(21) رسلان شرف الدين ، موقع الدولة الوطنية في ظل النظام العالمي الجديد ، مجلة بحوث عربية العدد (3-4) كانون الثاني – شباط ، 1998 ، ص 2 .
(22)هانس بيترمارتين وهارالد شومان ، فخ العولمة ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 1998 ، ص 375-376 .
(*) يؤكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ميشيل كا مديسو ، بانه على قادة العالم ان يتقبلوا فكرة الحكومة العالمية قبل ان يتوقعوا قيام المؤسسات الدولية بتكريس الوقت اللازم لممارسة سلطاتها على المستوى الدولي ..
ورد في :ـ مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، المعهد للدراسات المالية والمصرفية المجلد الثالث ، العدد الثالث ، السنة الثانية ، سبتمبر ،1994 ، ص 36.
(23)Kenici Ohmae : The End of Nation – State : The Rise of Regional Economies ,The Era Press ,New York , 1995 .
(24) انتوني جيدنز، الطريق الثالث : تجديد الديمقراطية الاجتماعية ، ترجمة : احمد زايد ومحمد محي الدين ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة 1999 ، ص 65
(25) UN, Transnational Corporations, Vol.9 , No.3 , December 2000 , pp.99
(26) هاري ماجدوف ، الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم ،مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، 1981 ، ص 172 .
(27) احمد زيد الدولة في العالم الثالث ، الرؤية السوسيولوجية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،ا لقاهرة ، ص ص 220-221 .
(28) المصدر السابق نفسه ، ص 222 .
(29) انظر:- زبيغنيو بريجنسكي ، المصدر السابق ، ص ص 77-78 .