الفقر وسط الغنى في العراق
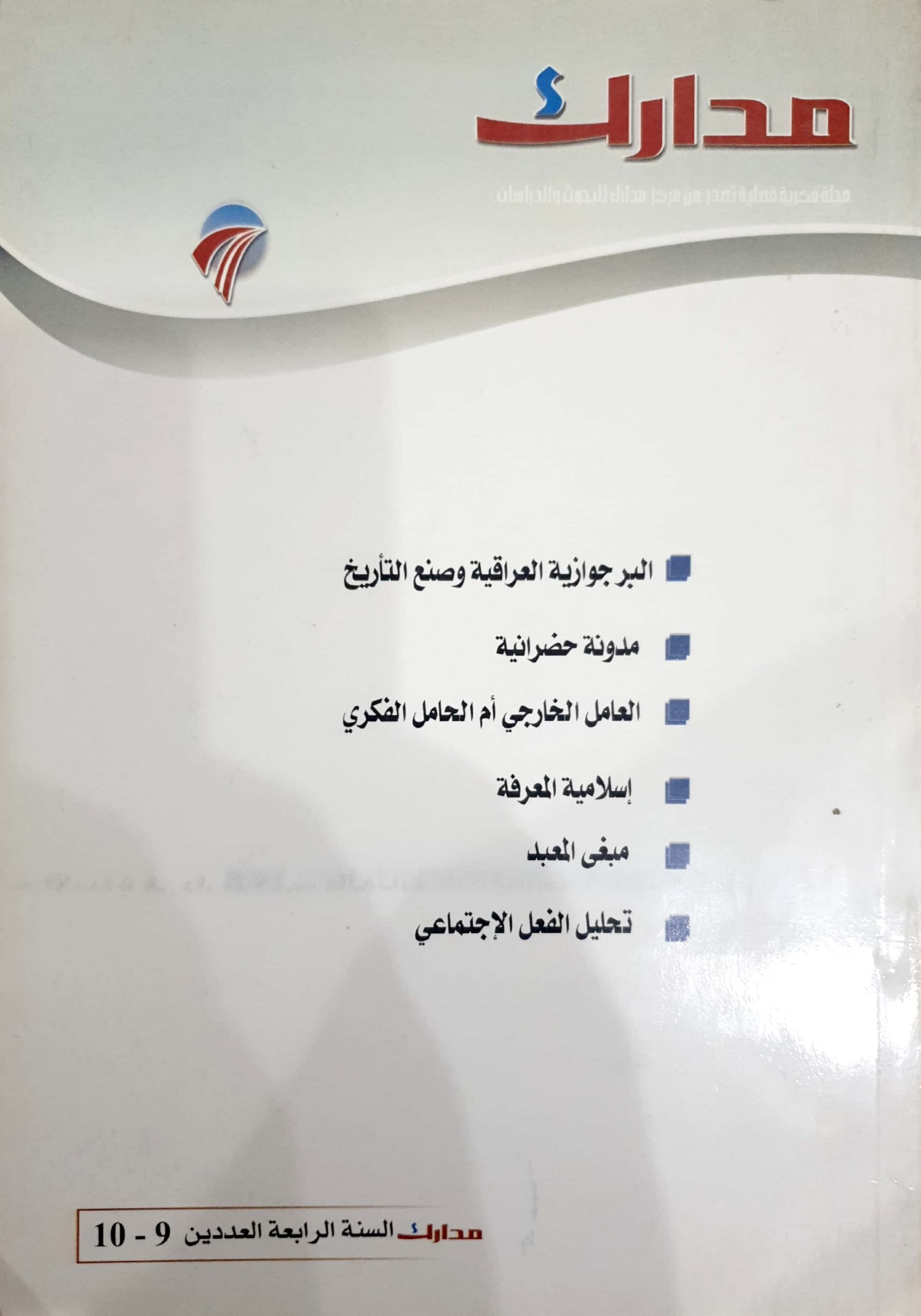
تسعى هذه الورقة إلى مناقشة أسباب الفقر وآثاره المدمرة على المجتمع، ومتابعة التبدلات في حجم الظاهرة بعد عام 2003.
حال الفقر
إن مقارنة نتائج مسح ميزانية الأسر عام 1993 مع مثيلاتها عام 1988 تكشف تحولا في نسبة الأسر في كل الفئات الدخلية الثلاث ، حيث انخفضت نسبتها من 7.9% إلى 6.3%. هذا التحول في التوزيع النسبي للأسر من فئة الدخل المتوسط وفوق المتوسط إلى فئة الدخل دون المتوسط يعني أن هذه الفئة باتت تمثل 62.7% من مجموع الأسر قياسا إلى 56 في المائة لعام 1988. فقد انخفض دخل الأسر ذات الدخل المتوسط (بأسعار عام 1988) من 418 دينار شهريا عام 1988 إلى 145 دينار عام 1993، أي أصبح ما يقارب الثلث. أما الأسر ذات الدخل دون المتوسط فقد كان الانخفاض شديدا حيث أصبح حوالي 74 دينارا عام 1993 وهو ما يعادل 22% عما كان عليه عام 1988. ويمكن توقع تفاقم الأوضاع بعد عام 1993، والأزمة الاقتصادية التي أجبرت الحكومة على تخفيض حجم الحصة التموينية الموزعة باستخدام نظام البطاقة التموينية، وتصاعد مستويات التضخم.
طبقا لبعض للمسوحات الأحدث التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط، فقد بلغ متوسط حجم الأسرة (6.8) أفراد. فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري على السلع والخدمات الاستهلاكية 52213 ديناراً. وهو ما يشير إلى إن نسبة الفقر المطلق تبلغ 40 % مقارنة بالمتوسط العام لخط الفقر المطلق الذي بلغ (46496) ديناراً شهرياًَ().
وطبقاً لنتائج الدراسة الموسومة «خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق»، فإن 31 % من الأسر و34 % من الأفراد يعانون من الحرمان. كما أكدت الدراسة الاتجاهات العامة التي سلكها الفقر في الماضي حيث ينتشر الفقر في محافظات الجنوب: السماوة، بابل، القادسية، ذي قار، ديالى، كربلاء، واسط، النجف، وميسان.
أسباب الفقر
تقف عوامل عديدة كأسباب للفقر في العراق منها():
- الحروب الداخلية والخارجية (حرب الشمال، الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، حرب الخليج 1991، حرب الخليج الثالثة 2003)؛ فقد أدت حرب السنوات الثمان إلى تدهور في أوضاع السكان وبخاصة في المناطق الحدودية في الوسط والجنوب. وقلبت تلك السنوات المجتمع العراقي والأسس التي انبنت عليها الدولة والاقتصاد رأسا على عقب، وعُسكر المجتمع بصورة مكثفة، بل بالكامل. وأصبح الفقر والحاجة المتزايدة السمتين الأساسيتين للعوائل والأفراد العراقيين.
- الحصار الاقتصادي (1990-2003)؛ فبعد عام 1990 تدهورت وتراجعت فاعلية مؤسسات الدولة وتعرضت للاهتزاز والضعف. فقد شحت موارد الدولة على الإنفاق الاجتماعي والخدمات، وتحديدا في موضوع الغذاء والدواء، واتسعت دائرة الفقر وتدهورت البيئة الاجتماعية، وتفشت أجواء عدم الأمان والاستقرار على المستويين الفردي والعام. من جهة أخرى، فاقمت حقبة الحصار من حالة الخلل في توزيع الدخل القومي، ووسعت الفروق الدخلية بين مجموعات السكان، وازدادت الفجوة اتساعا بين الفقراء والأغنياء. إذ يتلقى أفقر 20 في المائة من الأسر أقل من 7 في المائة من إجمالي دخل الأسرة العراقية، في حين يتلقى أغنى 20 في المائة ما نسبته 44 في المائة من الدخل، أو 6 أضعاف ما تتلقاه الأسر الفقيرة.
- طبيعة النظام السياسي ونمط تعامله مع مجتمعه وسوء تصرفه بموارد المجتمع الاقتصادية. وفي كل تلك الظروف كان النظام السياسي يركز أكثر على حماية نفسه واتخاذ المزيد من إجراءات الوقاية. وأفضت تلك الأجواء إلى تحول أفراد المجتمع إلى ما يشبه نزلاء المعسكرات الذين يتقدمون يوميا أو أسبوعيا أو شهريا لطلب الغذاء والدواء، وهم محرومون من أي حقوق مدنية().
التغيير السياسي مزيد من الصعوبات
فرض الاحتلال الأمريكي للعراق صعوبات جديدة في مجال الفقر، واتخاذه اتجاهات جديدة، وعلى الرغم من أن الاستنتاج العام يشير إلى تحسن في عموم المستويات المعيشية ، إلا إن مظهرا آخر برز في ظل عدم الاستقرار السياسي، وتردي الوضع الأمني فيما باتت تعرف الآن بالمناطق الساخنة.
وتختلف التقديرات المتاحة حول أعداد العوائل المهجرة من تلك المناطق إلى مناطق أكثر أمنا، وطبقا لمنظمة الهجرة الدولية يصل عدد النازحين داخليا إلى 45029 عائلة. أي نحو 270202 نازح، ثلثهم من بغداد(). أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقد تحدثت في تقريرها الخاص بحالة العراق الذي صدر في تشرين الأول (اكتوبر) 2006 عن 1.5 مليون نازح داخلي، منهم 425000 نازحا بعد أحداث تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء، أي 71 ألف عائلة تقريبا. وطبقا للمصادر الرسمية العراقية فقد بلغ عدد المهجرين في الداخل بعد أحداث سامراء ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، نحو 163574 عائلة، أي حوالي 999772 فردا(). وأيا كان الرقم الحقيقي فان مئات الآلاف قد ادخلوا عنوة في فقر مدقع تحت وطأة التهجير القسري، والاضطرار إلى النزوح تاركين أملاكهم ومنازلهم ومقتنياتهم، لينفذوا بحياتهم.
وفي مقصدهم بعد التهجير، يجبرون في الغالب على السكن في مخيمات تضم في المتوسط (45-100) خيمة، تنتشر في بغداد (2)، النجف (2)، الأنبار (2)، القادسية (1) ، كربلاء (1). أو في بنايات عامة مهجورة، بدأت الإدارات المحلية مؤخرا باسترجاعها، وطرد العوائل التي تسكنها.
من جهة أخرى، فرض العنف المتصاعد، سقوط عشرات آلاف الضحايا، وهم في الغالب من أرباب الأسر، ليتركوا أسرهم دون معيل، تضطر الأم فيها للعمل، أو يتنادى الأطفال إلى العمل بعد تركهم الدراسة.
بإزاء ذلك يمكن التعرف على تواضع البيانات التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 25 كانون الثاني/ يناير 2006 إن نسبة الفقر قد بلغت حوالي 20% من إجمالي عدد السكان. وأن حوالي مليوني عائلة عراقية تعيش دون مستوى خط الفقر(أقل من دولار للفرد الواحد يوميا) ().
وحيث أن آثار الفقر كبيرة وعميقة، ومن الصعب تجاوزها بمجرد زيادة الدخل، فان ارتفاع معدلات سوء التغذية وهو من أمراض الفقر، يعد مؤشرا دلالا على انتشار الفقر واتساع نطاقه وصعوبة محو آثاره. فقد أظهرت دراسات حديثة() ان سوء التغذية ما يزال متفشيا بين الأطفال، أن معدلات التقزم (الطول نسبة إلى العمر) تعتبر الأعلى بين أطفال العراق مقارنة بقرانهم في الجوار العراقي لا تزال معدلاتها عالية، إذ بلغت نسب التقزم لدى الأطفال دون الخامسة. ذلك أن هناك طفلاً من بين كل خمس أطفال في العراق يُعاني من التقزم.
الفقر والبطالة
هناك علاقة واضحة ومؤكدة بين البطالة والفقر، ذلك إن الأسباب الهيكلية للبطالة في البلد تكمن في:
- نمط النمو الاقتصادي المتمحور حول استغلال النفط، حيث يوفر النفط أكثر من 90 من الإيرادات العامة، وأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا انه لا يشغل سوى 1% من القوة العاملة. فالاقتصاد العراقي يقدم صورة متطرفة للكيفية التي أدت فيها عائدات النفط في زيادة تخلف بينية القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وفي تشويه هيكل التجارة الخارجية.
- خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل، الذي يعاني من الاعتماد شبه التام على القطاع العام في خلق فرص عمل جديدة.
- آثار الحرب وفقدان الأمن، وتوقف عمل الاقتصاد، وتدهور النشاط الخاص. إن التدمير الهائل الذي أصاب الاقتصاد بفعل الحروب وسنوات الحصار العجاف، وتوقف عمليات الإنتاج، والتدهور الأمني أدى إلى توقف شبه كامل للإنتاج القومي، كلها أثرت سلبا على نشاط الأعمال في اقتصاد استمرت الفرص والمبادرات الخاصة تضيق وتتقلص فيه باستمرار.
منذ عام 2003 أجريت أربعة مسوحات للبطالة أشارت إلى انخفاض معدل البطالة العام في البلد من حوالي 28% عام 2003 إلى 17.5% عام 2006. لكن هذه الأرقام تخفي تباينات مرعبة بين المناطق الحضرية والريفية وبين المحافظات، تبعا لمدى تأثر هذه المنطقة أو تلك بمفاعيل توليد البطالة، وطبيعة اقتصادها. لكن تبقى تلك الفروقات وعدم المساواة بين المناطق أكثر خطورة من انعدام المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية بكل ما يحمله تعبير «المرحلة الانتقالية» معنى يؤشر التحول العميق في البنى والمؤسسات والقيم.
جدول (1)
معدلات البطالة في العراق مقارنة بالمعدل العام حسب البيئة والجنس للسنوات (2003-2006)
* باستثناء إقليم كردستان.
**بأستثناء الأنبار وأربيل ودهوك.
*** بيانات الحضر للمراكز الحضرية.
المصادر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقرير حول نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003، كانون الثاني، 2004، جدول (1)، ص16؛ جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية الإحصاء الاجتماعي، نتائج مسح التشغيل والبطالة/ المرحلة الثانية، النصف الأول لسنة 2004، كانون الأول 2004، جدول (1)، ص12؛ الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، تموز/ 2007، جدول(3-1)، ص25
تتميز معدلات البطالة في العراق طبقا لأحدث المسوحات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها():
- تتباين معدلات البطالة بين المحافظات التي شملتها المسوحات فقد سجلت بعض المحافظات معدلات منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، في وقت استمرت محافظات تتصدر قائمة المحافظات الأعلى بطالة. إذ نجد إن ذي قار استمرت تتصدر المحافظات من حيث ارتفاع معدل البطالة، تليها الأنبار ونينوى والمثنى والقادسية. فيما حققت البصرة أدنى المعدلات ثم واسط فالسليمانية وبابل وكربلاء وكركوك.
2. غالبا ما تتركز البطالة بالفئة العمرية (15-24) ثم تبدأ بالانخفاض في الفئات العمرية اللاحقة، وبسبب الحجم الذي تشكله هذه الفئة العمرية من إجمالي قوة العمل (حوالي 30%) فإنها تحوز الحصة الأكبر من إجمالي العاطلين عن العمل. ففي عام 2004 بلغ معدل البطالة لهذه الشريحة 43.8 % منها 46% بالنسبة للذكور، و 37.2 % للإناث(). انخفضت النسبة إلى 34.89 % عام 2006، منها 36.91% للذكور و 27.37% للإناث. كما يلاحظ تركزها في المناطق الحضرية. في حين إن سلوك مؤشرات البطالة لهذه الفئة العمرية يكاد يطابق سلوك معدلات البطالة العامة. ويعود السبب في ارتفاع البطالة في هذه الشريحة العمرية ارتفاع البطالة بين الإناث بما يفوق مشاركتهن في قوة العمل بنحو ثلاثة أضعاف، في ظل انعدام فرص العمل في القطاع العام الذي كان يشكل الفرصة المثالية للعمل بالنسبة للمرأة.
- تتركز أزمة البطالة في المناطق الحضرية عنها في الريف، وهو ما يعود جزئيا إلى انخفاض بطالة الإناث في المناطق الريفية والذي سجل معدلات أدنى من 10 % للسنوات (2003-2006) مقارنة بمعدل يزيد عن 22% للسنوات 2003-2005 وعن 37 % لسنة 2006 بين الإناث في المناطق الحضرية. ويعود ذلك إلى شدة تزاحم العاملين في المناطق الحضرية على فرص العمل المتاحة للجنسين في وقت تتزايد أعداد المشاركات في سوق العمل من النساء. وفي الريف حيث تعمل النساء في القطاع الزراعي بأجور متدنية أو يعملن لدى أسرهن بدون أجر فانه يصبح لدى الرجال مجالات أوسع للعمل خارج القطاع الزراعي مما يوفر فرص لهم أكثر بكثير من تلك المتوفرة بالنسبة للحضر.
- تفاوت معدلات البطالة حسب الجنس حيث إنها مرتفعة بين الإناث، وهو ما يعود إلى سلوك مؤشرات البطالة وتركزها في الفئة العمرية دون (25) سنة، حيث تزداد كثافة مشاركة المرأة في قوة العمل مع انعدام فرص عملها في القطاع العام.
- تتناسب البطالة عكسيا مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث تتزايد في فئات الحاصلين على تعليم منخفض.
- أما من الحالة العلمية للبطالة في الفئات التعليمية الأعلى من المرحلة الإعدادية فإنها تتركز عموما عند بعض الاختصاصات المهمة كالحاسبات والإدارة والاقتصاد بفروعها واللغات والقانون والسياسة فيما سجلت أدنى معدلاتها في التخصصات الطبية والفنون. وهو ما يعكس هيكل الطلب على هذه الاختصاصات والتزام الدولة بتعيين بعضها. لذا فان أكثر من نصف الأفراد النشطين اقتصاديا والحاصلين على شهادة الإعدادية فأعلى بينما يوظف أقل من خُمس قوة العمل غير المتعلمة. فيما يعمل حوالي نصف غير المتعلمين في الزراعة.
- أما من حيث معدل النشاط الاقتصادي أي مساهمة السكان في قوة العمل، فانه يعد متوسطا منخفضا في كربلاء قياسا بمحافظات العراق الأخرى حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للذكور (77.88%) وللإناث (13.32%) في حين بلغ معدل المشاركة في قوة العمل الكلي (46.13%). وهذه الأرقام هي أدنى من المعدلات العامة البالغة (78.30% و 20.69% و49.72% على التوالي).
إن الخصائص السابقة للبطالة، تؤشر طبيعة سلوك الفقر أيضا، فالمحافظات التي تنتشر فيها البطالة، تعتبر أكثر فقرا، والفئات العمرية الأكثر تعرضا للبطالة، تعد الأكثر فقرا.
التعليم والفقر: جدليات التناقض
هناك عداء صريح بين الفقر والتعليم، فحيث ينتشر الفقر، تنتشر مظاهر الأمية والتسرب من الدراسة. وتظهر الدراسات الخاصة بالموضوع إن هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومستوى التسرب، فكلما انخفض الدخل، ازدادت إمكانية تسرب الطلبة.
لقد قضت سنوات العقوبات الاقتصادية على تلك المكاسب التي تحققت طوال عقدي السبعينات والثمانينات، والمرتبطة بارتفاع معدلات معرفة القراءة والكتابة وزيادة نسبة المسجلين في الدراسة، وانخفاض معدلات التسرب، وفرضت الصعوبات الاقتصادية على العوائل الدفع بالأطفال للعمل لإعالة أسرهم أو لان التعليم لم يعد جذابا مع تدني العائد من الوظائف العامة.فلا غرابة أن تتدنى نسبة التسجيل في جميع مراحل التعليم، لكافة الأعمار (6-23 سنة) إلى 53%. وبرزت الأمية بين الشباب والنساء بحدود مستويات منتصف الثمانينيات. وتشير أرقام اليونسكو إلى أن معدلات التسرب من المدارس الابتدائية ازدادت من 95692 عام 1990 إلى 131658 عام 1999. كما تسرب 26394 معلم ومدرس وموظف. وعانت الأبنية المدرسية، سواء خلال التشييد أو الصيانة، نقصا خطيرا. ويشير الواقع إلى نقص حاد في احتياجات المدارس من الأثاث والتجهيزات والمواد التعليمية والتقنية، الأمر الذي أدى إلى تردي مريع في المستوى التعليمي، وزيادة المشكلات السلوكية غير المرغوبة، وضعف دافع التعليم للطلبة ومتابعة أوليائهم، وضعف شديد في مستوى الكادر التعليمي(). وتعتبر معدلات رسوب الأطفال العالية (20%) دليلا على سوء نوعية التعليم(). وأخذت اتجاهات معرفة القراءة والكتابة منحى مقلقا، حيث إن معدلات تلك المعرفة في الفئة العمرية بين (15-24 سنة) أدنى منها في الفئة (25-34 سنة)، بالرغم من التوسع الظاهر في التعليم الأساسي في العراق خلال السنوات الثلاثين الماضية. وهو ما يعود إلى تدهور النظام التعليمي خلال حقبة الحصار. وعلى الرغم من أن الفجوة بين الجنسين قد تناقصت إلا إن ذلك يعود إلى تدني معدلات معرفة الذكور بالقراءة والكتابة. أما الفئات العمرية التي تتجاوز 65 سنة فإنها تبلغ 39 و 14 للرجال والنساء على التوالي().
بين عامي 1987 و 2002 انخفض معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي بنسبة 2.941، وعاد للزيادة في عام 2004 إلى 50.051(). من جهة أخرى، تراجعت نوعية التعليم في العراق بشكل مستمر سيما خلال ربع القرن الماضي، مدفوعة بظروف الحروب والحصار. ومع جمود المؤسسات التي تحكم نظام التعليم فانه قد فشل حتى في الحفاظ على مستويات هيئات التدريس ونوعيتها وتدهورت بشكل ملحوظ، فتدني الأجور، وقلة الاستثمارات في مجال التدريب، والاعتماد على معلمين غير مؤهلين، وتدهور البنية التحتية المادية للمؤسسات التعليمية كلها أثرت سلبا على جودة التعليم في العراق. لقد فشل نظام التعليم في الاستجابة لاحتياجات الجيلين الأخيرين. وبات قلة من الطلاب يتاح لهم فرص اكتساب المهارات اللازمة لتأمين الحصول على عمل مجزٍّ ومتناسب مع مهاراتهم. لذا فان أعدادا متزايدة من الخريجين كانت تدخل في دائرة البطالة والفقر. والمحصلة أن عجز نظام التعليم عن إنتاج خريجين مؤهلين للعمل، ولم يفلح في إكساب الطلاب المهارات التي يحتاج إليها القطاعين العام والخاص بالتوافق مع مقتضيات التنمية الاقتصادية. وابتعد كثيرا عن تعزيز القدرات الإبداعية. وتمظهر ذلك الفشل في صورة معدلات عالية للبطالة والعمالة الناقصة، وبخاصة بين الخريجين والداخلين الجدد في سوق العمل، والنقص الواضح في المهارات وهبوط الإنتاجية. وفي ظل معدلات النمو السكاني العالية وزيادة عمالة النساء فان جانب العرض من سوق العمل يميل إلى الزيادة بما يفاقم مشكلة الخريجين الجدد. لذا فان معالجة هذا الواقع تعد أمرا ضروريا في إطار البناء المقصود.
إن أهمية هذه البيانات تكمن في أنها تؤشر إن مئات الآلاف من العراقيين قد اجبروا على الولوج في معترك الحياة دون تعليم كاف، وبالتالي دون مهارات مناسبة لاحتياجات سوق العمل.
إن العمالة هي الآلية التي تترجم التعليم إلى نمو منصف موزع بشكل جيد، وبانقطاع الصلات بين التعليم والعمالة، تُهدر موارد هامة وتتضاءل العوائد من التعليم. لذا فارتفاع نسبة البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية يعكس أزمة التعليم العالي في العراق. فنوعية التعليم في تراجع منذ الثمانينيات مع فشل المؤسسات التي تحكم نظام التعليم في تطوير مستويات هيئات التدريس والبنية التحتية المتعلقة بالتعلم والمناهج، أو حتى الحفاظ على المستويات نفسها ومنع تدهورها. والواقع أن حوافز هيئات التدريس ونوعيتها قد تدهورت مع اشتداد سنوات الحصار وما رافقها من موجات من التضخم الجامح وتدني مستويات الأجور الحقيقية وانعدام الاستثمار في مجال التدريب. فمعظم القوى العاملة العراقية كانت تلقت تعليما غير جيد، فباتوا غير قادرين على الاستقلال الفكري، ولم يتمكنوا من مواصلة التعلم إلى ما بعد الحدود التقليدية للتعليم المدرسي. كما أن التعليم في العراق فشل في تقديم مهارات سوق غير أكاديمية (كالتفكير الإبداعي، الابتكار، العمل الجماعي، الثقة بالذات، المبادرة، تحمل المسؤولية، الالتزام بالمواعيد، الأمانة…). لذا فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى طرق غير تقليدية في التدريس تضمن غرس هذه المهارات في مراحل مبكرة من عملية التعلم. إن عدم توفر المهارات الجيدة، يعني استمرار تخلف رأس المال البشري في العراق، الأمر يمكن أن ينعكس على عمليات البناء وإعادة الإعمار من خلال الفشل في اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وزيادة في حدة البطالة والفقر والتوتر الاجتماعي().
يتوجب على النظام التعليمي استهداف العاطلين عن العمل إضافة إلى الفئات المهمشة الأخرى. ولهذا يجب تنفيذ برامج لإعادة تدريب العمال وإعادة تأهيلهم. ويجب أن تركز هذه البرامج على الفئات المعرضة لخطر الفقر، أي العمال غير المهرة والنساء. فهذه الفئات لا تملك المهارات التي تمكنها من المنافسة في سوق العمل.
الفقر ومسؤولية الحكومة
كانت الحكومة ما قبل عام 2003 تحاول أن تتجنب الحديث عن الفقر، وترفض الاعتراف بوجوده. فعندما اعد تقرير التنمية البشرية لعام 2000، رفضت القيادة آنذاك نشره، بحجة أن لا فقر ولا تدهور في أوضاع التنمية في البلد بعد عقد من العقوبات. وما بعد التغيير يبدو أن الفقر وأعراضه لم يحظيا بالجهد المناسب، فالحكومة ومع ضخامة الملفات التي تواجهها، تراجع اهتمامها بالشأن الاجتماعي، وباتت تولي اهتماما أقل بمسألة القضاء على الفقر.
ان عدم الاهتمام الذي تبديه الحكومة لا يعود إلى مجرد عدم الرغبة في المعالجة، بل إلى قصور الرؤية، والى قصور الأدوات. ينبغي أن يترسخ إدراك عام أن زيادة غنى أي مجتمع تزيد من عوامل الاستقرار داخله، فالبلدان الأكثر غنى هي الأكثر استقرارا، وحيث تسود الدخول المرتفعة، ويتأمن الوصول إلى الموارد، وترتفع معدلات التعليم، وتنتشر الرعاية الصحية الجيدة، وتنخفض معدلات الفقر، يسود جو من الرغبة في الحفاظ على تلك النعم. وفي أجواء الفقر، والحرمان، تسود الرغبة في التغيير. لذا فان القضاء على الإرهاب، لا يتناقض مع القضاء على الفقر، كما أنهما يتسايران معا، فالقضاء على الفقر، باب من أبواب محاصرة الإرهاب وتفكيك البيئة الخصبة لانتشاره.
وأما من جهة الأدوات الكفيلة بمعالجة الفقر، فان الاقتصاد العراقي لا يمنح صانعي القرار الكثير من أدوات السياسة الاقتصادية، وفي عدم قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، فان الحكومة بادرت إلى خلق الوظائف في القطاع العام، وبالفعل فقد ارتفع عدد موظفي هذا القطاع من 1.047 مليونا عام 2004 إلى 1.143 مليونا عام 2005 ثم إلى 1.913 مليون موظف عام 2006. وبما يفوق المليونين عام 2007. وهذا يؤشر رغبة الحكومة في انتهاج الحلول السهلة لاستيعاب العاطلين عن العمل، وإيجاد حل مقبول سياسيا واجتماعيا للمشكلة.
ومن وجهة نظر الاقتصاد السياسي، فان الدولة سعت إلى الحفاظ على دورها كأداة للتوزيع في المجتمع الريعي، وبادرت إلى تعديل رواتب موظفي القطاع العام، لكن هذه الزيادات جاءت في غير صالح الفقراء، الذين أصبحوا على هامش مؤسسات القطاع العام، فالسلم الجديد للرواتب لا يحابي الفقراء، ذلك أن معدلات الزيادة في أجور ومرتبات الدراجات المنخفضة (التاسعة والعاشرة) هي أدنى معدلات الزيادة، فالموظف الذي يقع في تلك الدرجتين وهو فقير بطبيعة الحال، يمكن الادعاء انه لم ينل زيادة تذكر.
إن هذا الاتجاه في تعديل أسس التوزيع، يرتبط بعدم نجاح الحكومة في تأمين الخدمات الأساسية للمجتمع، ومحاولة منها لتوفير تكاليف تلك الخدمات إلى الأفراد ليقوموا هم بتأمين احتياجاتهم منها. فالتحسن في الأجور والرواتب لم يرافقه تحسن ملموس في أداء المؤسسات الخدمية، وهنا بات حصول الفقراء على الخدمات العامة أصعب من ذي قبل، مع توقع تراجع أداء الدولة في هذا المجال.
وتبرز على الصعيد الاقتصادي صعوبات جديدة ترتبط بارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات الغلاء داخليا وخارجيا، واحتمالات تأثيرها على أوضاع الفقراء في البلد. ذلك إن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، يهدد جميع فقراء العالم، الذين يعتمدون على رخص الوقود والغذاء لتأمين حاجاتهم اليومية.
إن هذه الأوضاع تهدد نظام البطاقة التموينية، ويدفع أنصار الاقتصاد الحر باتجاه إلغائه أو إصلاحه، وطبقا لدراسة أعدها البنك الدولي عام 2005 فان إيصال دولار واحد من المواد الغذائية يكلف 6.30 دولار. لكن لم تفلح تلك الدعوات في تقليل إغراء المواطنين تجاه تفضيل نظام البطاقة التموينية، فعقب سقوط حكم البعث طرح البعض استبدال الحصة التموينية ببديل مالي يقدم إلى الأسر المستفيدة من النظام، وكانت وزارة التجارة قد عارضت بشدة هذه الدعوات. وقد أثبتت دراسة أجريت عام 2005 إن أكثر من 95% من الأسر العراقية ترغب في استمرار حصولها على مواد البطاقة التموينية على استبدالها بالنقود.
وفي أب (أغسطس) 2005 شكلت حكومة إبراهيم الجعفري لجنة وزارية لبحث موضوع استبدال نظام البطاقة التموينية ببديل نقدي، وقد رفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق على عدد من الإجراءات منها: الشروع في عام 2006 بتطبيق محدود لنظام التحويل النقدي يشمل ثلاث محافظات هي دهوك والسماوة وأجزاء من محافظة صلاح الدين في ظل احتفاظ الأسر بحرية الاختيار بين استمرار الحصول على المواد الغذائية أو استلام البدل النقدي. كما أوصت اللجنة بالتطبيق الدوري لهذا القرار مع الأخذ بنظر الاعتبار تأثيراته على أسعار السوق واتجاهات تفضيل الأسر لأي من البديلين. ويجادل خبراء البنك الدولي بضرورة تقليص عدد المواد التي توزع من خلال نظام البطاقة التموينية، بالتزامن مع زيادة الكمية الموزعة من مواد أخرى. على أن يجري حذف المواد رخيصة الثمن (أي التي لا تخفض بشكل حاد القدرة الشرائية للأسرة) والمواد غير الأساسية للتغذية الجيدة(). مع ملاحظة أن هذه الاقتراحات تؤيد اطروحتنا حول رغبة الدولة في التخلي عن التزاماتها واستبدالها بالمنح النقدية.
ويدور الحديث عن إقامة شبكة للحماية الاجتماعية تتكفل استيعاب الآثار السلبية للانتقال نحو اقتصاد السوق، وما رافق التحول السياسي في البلد، إلا انه وفي ظل انتشار الفساد المالي والإداري، وعدم توفر نظام فاعل للمعلومات، يصعب الاعتقاد بنجاح هذه التجربة، التي ما تزال محدودة.
الخاتمة
لم يشهد العراق حتى الآن محاولات جادة لإيجاد حل لمشكلة الفقر، بل إن كل ما يجري هو محاولات للتعامل مع أعراض المشكلة من خلال تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية دون التوجه إلى أسباب المشكلة. إن تطبيق السياسات الكفيلة بالقضاء على الفقر؛ ووضع السياسات بغية معالجة البطالة، وتوفير التدريب والوصول إلى الموارد الإنتاجية؛ اعتماد إجراءات كفيلة بزيادة الدخل، تعتبر أولويات للعمل المستقبلي في سبيل القضاء على الفقر في العراق.
إن مكافحة الفقر تمثل تحديا حاسما في عمليات البناء وإعادة الإعمار في العراق. ويمكن القيام بذلك عن طريق ضمان النمو الاقتصادي وخلق فرص العمالة. إن تحقيق الترابط بين الأنظمة التعليمية واحتياجات أسواق العمل لا يمكن حله إلا عن طريق صياغة برامج التنمية البشرية وتنفيذ سياسات محلية تتعلق بسوق العمل تعتمد على اكتساب المهارات. لذا فلا مناص من إنشاء نظام لتقييم العملية التعليمية والبرامج المتصلة بها.
أولا: ينبغي أن تنصب جهود التخفيف من حدة الفقر على معالجة الأسباب البنيوية للبطالة، ومعالجة أسباب نقص فرص العمل أمام القوى العاملة. على أن يجري العمل على تنويع الاقتصاد العراقي ليمتد إلى قطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة. وينبغي أن تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض، وتوليد فرص اقتصادية أفضل في المناطق الريفية الفقيرة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص. كما يجب على الحكومة أن تبادر إلى وضع وتنفيذ إستراتيجية تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل. تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على أن تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ثانيا: إن التعامل مع مستقبل البطاقة التموينية يجب أن لا ينبني على الاعتبارات الاقتصادية الصرفة، كما أنه ينبغي أن لا يخضع تماما للاعتبارات السياسية، لذا فان القرار بشأنها ينبغي أن ينبني على كلا الاعتبارين الاقتصادي والسياسي مضافا إليه البعد الاجتماعي المتمثل في دور هذا النظام في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وينبغي للإجراءات الأولى أن تتجه نحو تحسين هذا النظام وتوجيهه نحو تحسين ظروف هذه الأسر، ومكافحة الفساد المتنامي فيه، قبل الحديث عن إلغائه أو استبداله بشكل عشوائي ببدل نقدي.
ثالثا: على النظام التعليمي في العراق أن يصل إلى شمولية التعليم الأساسي، كما يجب على الحكومة تسهيل الوصول إلى المدارس في المناطق الريفية، وتحسين نوعية التعليم بزيادة رواتب المعلمين وتعزيز تدريب المعلمين، وتجديد المناهج في جميع المراحل. كما يجب إعطاء أهمية خاصة لتعليم الفتيات خاصة القاطنات في المناطق الريفية والمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية لدى النساء(). على إن الاستجابة الحاسمة للتعليم في العراق لا تقتصر على إشاعة المعرفة بالقراءة والكتابة فقط، وإنما يتعين أن تعطى الأولوية للأهداف التالية: (1) القضاء على الأمية؛ (2) رفع جودة التعليم؛ (3) توفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع الناس.
الهوامش والمراجع
([1]) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج المسح السريع لميزانية الأسرة المنفذ عام 2005
([2]) حسن لطيف كاظم الزبيدي، الفقر في العراق: مقاربة من منظور التنمية البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية (الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية: بيروت)، السنة (18)، العدد (38)، ربيع 2007، ص 101-102
([3]) علي حنوش، العراق: مشكلات الحاضر وخيارات المستقبل (دراسة تحليلية عن مستويات تلوث البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية)، دار الكنوز الأدبية، بيروت، 2000، ص 206
([4]) منظمة الهجرة الدولية، تقرير المنظمة في 7 كانون الثاني(يناير) 2007
([5]) وزارة المهجرين والمهاجرين، قسم المعلومات، النشرة الشهرية، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.
([6]) الشرق الأوسط، العدد (9920)، الأربعاء 25 ذو الحجـة 1426 هـ 25 يناير 2006 (www.aawsat.com)
([7]) الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS3 لعام 2006
كذلك: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، ومسح الحالة التغذوية لعام 2005
([8]) انظر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، تموز/ 2007
([9]) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج مسح التشغيل والبطالة 2004، ص 10
([10]) جمعية الأمل العراقية من أجل خير الإنسان، لمحات عن أوضاع الفقر في العراق، في: التنمية الاجتماعية: الخطوة التالية في جنيف 2000، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت، 2000، ص 82
([11]) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، المصدر السابق، ص 91
([13]) من حسابات الباحث بالاعتماد على بيانات: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية، سنوات متفرقة.
([14]) حسن لطيف كاظم، الفقر في العراق: مقاربة من منظور التنمية البشرية، المصدر السابق
([15]) انظر، حسن لطيف كاظم، نظام البطاقة التموينية: 95 % من العراقيين يريدونها، مقال منشور على موقع نقاش (www.niqash.org)
([16]) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، المصدر السابق، ص 105