المرأة والتنمية البشرية في العراق الجديد
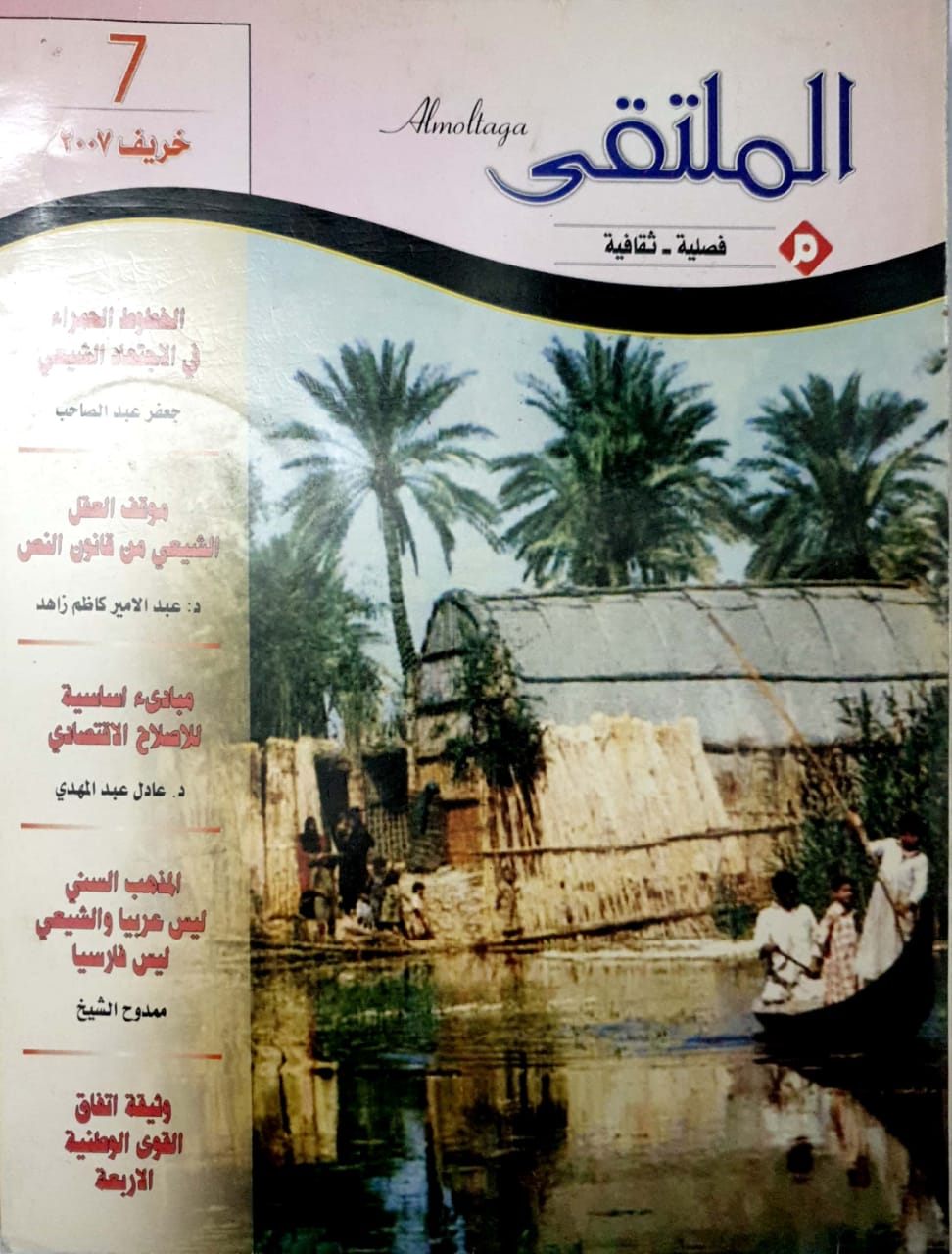
خلق الله الإنسان في أحسن صورة وجعله خليفته في الأرض، وائتمنه على إعمارها وحضَّه على العيش بسلام مع أقرانه على أسس المحبة والسلام والكرامة والحرية. وهذه الخلافة ليست خلافة للرجل دون المرأة، فهما يحملان مسؤولية الخلافة معا. وُكلَّفا برعاية الكون وتدبير أمر الإنسان، والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الإلهية. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم، وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعيا، وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله. لذا فان على المرأة والرجل أن يتشاركا في حمل الأمانة، وممارسة الحكم، ليس فقط لأنهما يتحملان عبء الأمانة، بل لان عليهما أن يتعاونا على حملها والنهوض بالمسؤولية.
تقدم هذه الورقة محاولة لتناول دور المرأة المسلمة في العراق في ظل مفهوم التنمية البشرية. وقد قسمت الورقة لتعالج مجموعة من المفاهيم والموضوعات، وعلى النحو التالي:
- في مفهوم التنمية البشرية
- في مفهوم النوع الاجتماعي
- التنمية البشرية في المرجعية الإسلامية
- الآفاق الرحبة لتنمية المرأة في الإسلام
- حال المرأة في العراق
- الخاتمة: سبل النهوض
في مفهوم التنمية البشرية
يهتم منظور التنمية البشرية بقدرة الإنسان على الخلق والإبداع للمستقبل. وليس مجرد استيعابهم للمعارف السابقة وتحويلها إلى إنتاج مادي عبر العمل. كما أنه يرفض التسليم لمعطيات وقيود الواقع المعاش، وينبني على رؤية تغييرية لهذا الواقع.
إن كل فرد إذا ما أعطي الخيار فسيُفضل بلا شك حياة أطول ومستوى أعلى من التعليم ودخلاً اكبر. وهذه الأبعاد الثلاثة تعكس مَديات من الإمكانات والقدرات البشرية أوسع مما تدل عليه تعريفاتها. والقدرات الأكثر أساسية التي تتيحها التنمية البشرية هي عيش حياة مديدة، والحصول على التعليم، وضمان موارد كافية للتمتع بمستوى حياة لائق، فيما تشتمل القدرات الأخرى على المشاركة الاجتماعية والسياسية في المجتمع().
تعتبر التنمية البشرية عملية ذات بعدين، الأول هو، تكوين للقدرات البشرية: الطبيعية والنفسية والعقلية والمهنية، والثاني، توفير الفرص للناس على استخدام هذه القدرات. وبهذا يتمايز مفهوم التنمية البشرية عن مفاهيم رأس المال البشري والموارد البشرية التي تختزل التنمية البشرية في جانب واحد هو تكوين موارد للأنشطة الإنتاجية.
والتنمية البشرية هي عملية ذات خيارات متعددة يكمن الهدف النهائي منها في توسيع وتنويع الخيارات التي يملكها الناس. وهي عملية (process) لأنها تعنى بالإجراءات التي يتم عبرها توسيع الخيارات كما أنها تهتم بنتيجة تلك الخيارات المتوسعة. وبهذا المعنى فهي تفترض تأثير الناس على العمليات التي تصوغ حياتهم، لذا يتعين عليهم المشاركة في القرارات وتطبيقها ومراقبة تنفيذها.
ومن المنظور نفسه، نجد أنه هناك عدداً من أبعاد التنمية البشرية، التي لا تدخل بصورة مباشرة ضمن النموذج الأساسي. ويرجع سبب ذلك بدرجة كبيرة إلى الشكوك حول جودة المؤشرات التي توصفها والمدى الذي تُفلح فيه بعكس هذه الأبعاد. فالحرية الإنسانية وظروف الحياة البيئية. رغم أنها لا تدخل في النموذج الأساسي إلا أنها تدرس بصورة مستقلة.
إن منظور التنمية البشرية يجمع بين أبعاد عديدة، ومن خلال متابعة تقارير التنمية البشرية يمكن تحديد العناصر أو الأبعاد الأساسية لمفهوم التنمية البشرية وهي:
التمكين (Empowerment): إن قدرة الناس على التصرف لصالحهم ولصالح غيرهم أمر مهم لتحقيق التنمية البشرية. والتمكين مهم لان الناس يطورون به إمكاناتهم كأفراد وكأعضاء في مجتمعاتهم. فالناس المُمَكنون يُمكنهم أن يرفعوا أصواتهم بأعلى من غيرهم للمطالبة بفرص العمل والتعليم والصحة والدخل والأمن والحقوق… وهم أقدر على التصدي للمشكلات التي تواجههم. كما أنهم أقدر على تجنب المخاطر والمطالبة بتحسين أوضاعهم.() إن تحقيق التمكين لا يمكن أن يتأتى إلا في ظل بيئة ديمقراطية سياسية مؤسساتية تعمل بصورة صحيحة. مثلما أن اتخاذ القرارات التي تَمسُ حياة الناس بما يستجيب لحاجاتهم يتطلب ديمقراطية اقتصادية. وفي كلا الحالتين يبرز دور المجتمع المدني بمعناه الواسع (المؤسسات التي تقع بين العائلة والدولة).
التعاون (Cooperation): أي الاعتراف بان الانتماء للجماعة يشكل مصدر انجاز وراحة وسعادة وهدف ومعنى على المستوى الشخصي. وعليه فالتنمية البشرية تهتم بإيجاد السبل التي توفر التعاون والتفاعل بين أفراد المجتمع.()
المشاركة (Participation): تعني المشاركة أن الناس يساهمون بفعالية في العمليات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والسياسية التي تؤثر في حياتهم. والشيء المهم أن يتمكن الناس وعلى نحو ثابت من الوصول إلى عملية صنع القرار والقوة. وفي هذه الحالة تصبح المشاركة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية. وجديرٌ بالذكر أن المشاركة واحدة من مفردات التنمية منذ الستينات، وحتى قبلها. لكنها كانت تشير فقط إلى مشاركة الناس في مشروعات أو برامج محددة. لكن منظور التنمية البشرية يضع المشاركة في محور إستراتيجية التنمية وما ينبغي على الناس أن يمارسوه من دور طوال حياتهم. فالتنمية البشرية توسع خياراتهم، وتمكنهم من المشاركة وزيادة فرصهم وتوسيع نطاق تلك الفرص. ويمكن للناس المشاركة كأفراد وكمجموعات، فالأفراد في ظل النظام الديمقراطي يمكن أن يكونوا ناخبين أو نُشطاء سياسيين، أو في السوق بوصفهم منظمين أو عمال. وكمجموعات يمكن أن يكونوا أكثر فاعلية بوصفهم أعضاء في المنظمات الاجتماعية، وربما في الاتحادات التجارية أو الأحزاب السياسية. والمشاركة من منظور التنمية البشرية هي وسيلة وغاية في الوقت نفسه.()
الإنصاف (Equity): تحتل الشواغل المتعلقة بالإنصاف مركز الصدارة في منظور التنمية البشرية. وغالبا ما تطبق فكرة الإنصاف على الثروة أو الدخل. لكن منظور التنمية البشرية يؤكد على الإنصاف في القدرات والفرص الأساسية للجميع.() والتي ينبغي أن لا تقتصر على الدخل المادي، بل تتسع لتشمل أكثر من مجرد توسيع القدرات والخيارات الأساسية. فينبغي أن تتوفر للجميع فرص متكافئة، وأن تُلغى كافة العوائق القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو العنصر أو القومية أو الانتماء الطبقي أو الخلفية العرقية، أو مستوى الدخل أو العوامل الأخرى والتي تحول دون الحصول على الفرص الاقتصادية والسياسية والثقافية.
الاستدامة (Sustainability): وتعني توفير حاجات الجيل الحاضر، من دون المساومة على مقدرة الأجيال القادمة في أن تتحرر من الفقر والحرمان وتمارس قدراتها الأساسية.() كما تعني تحقيق التوازن بين النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
الأمن (Security): ويتركز مفهوم الأمن من منظور التنمية البشرية على أمن البقاء على قيد الحياة، وتجاوز أخطار الأوبئة والأمراض والقمع السياسي أو الأحداث التي تصدع الحياة اليومية وتؤدي إلى الاضطرابات والتشوش والتشرد(). وللأمن الإنساني وجهان، هما: المَنجاة من التهديدات المزمنة، مثل الجوع والمرض والقمع، والحماية من التعطيلات الفجائية في أنماط الحياة اليومية. والتنمية البشرية كعملية لتوسيع خيارات الناس، يعني الأمن الإنساني في ظلها أن بإمكان الناس اختبار خياراتهم بأمان وحرية.()
الحرية (Freedom): إن التنمية البشرية تعنى أساسا بالحرية وبناء قدرات البشر. لكن الناس مقيدون بما يمكنهم فعله بتلك الحرية إذا كانوا فقراء أو مرضى أو أميين أو ضحايا التمييز، أو مهددين بنزاعات عنيفة، أو محرومين من الصوت السياسي.() وعليه يمكن النظر إلى التنمية باعتبارها عملية توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس.() وتتضمن الحريات: الحرية ضد التمييز، التحرر من العوز، التحرر لتحقيق ذاته الإنسانية، التحرر من الخوف، التحرر من الظلم، حرية المشاركة والتعبير والانتماء السياسي، وحرية الحصول على عمل دون الوقوع فريسة الاستغلال.()
في مفهوم النوع الاجتماعي
يعتبر النوع الاجتماعي Genderمن المفاهيم الحديثة الذي راج في الاستخدام في أدبيات العلوم الاجتماعية في العقد الأخير من القرن العشرين مع زيادة استعماله في أدبيات المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويركز المفهوم على علاقات القوة والفروقات بين المرأة والرجل وتأثير ذلك على الأدوار النوعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بافتراض إن هذه الأدوار هي متغيرة مع الزمن. ويركز مفهوم النوع الاجتماعي على أهمية استخدام البيانات والإحصاءات المفصلة حسب النوع الاجتماعي Sex- disaggregated data عند رسم السياسات والإجراءات على المستوى الكلي وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في إطار تلك السياسات.
وجدير بالذكر أن النوع يستخدم أحياناً بديلاً بسيطاً عن «الجنس» لكن مفهوم النوع أوسع لأنه عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع التي تحددها وتحكمها عوامل مختلفة: اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل. وعادة ما تسود تلك العلاقة عدم الاتزان على حساب المرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجة احتلال الرجل مكانة فوقية بينما تأخذ المرأة وضعا ثانوياً في المجتمع.
إن مكانة المرأة والرجل يجب أن تخلق مناخاً مناسباً للتنمية الفعالة في المجتمع، ويمكن لعلاقة النوع الاجتماعي أن تكون متوازنة إذا ما احل مفهوم «التمكين» أي القوة لإنجاز شيء ما بدل مفهوم القوة السائد. والتمكين يهدف لخلق الظروف التي تساعد الرجل والمرأة على سواء أن يوجها احتياجاتهما اليومية والمستقبلية.
التنمية البشرية في المرجعية الإسلامية
إذا كانت التنمية البشرية في الفكر الوضعي تعني تحرير الإنسان مما يعوقه اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بما يمكنه من العمل والمشاركة الفعالة على المستوى الوطني والعالمي، فان الإسلام ينفرد في أنه يقدم نظرة أوسع مدى وأرحب نطاقا، فيحرص على أن تكون التنمية البشرية شاملة لكل جوانب الإنسان البدنية والعقلية والروحية، ولذلك نراه يضع الأسس الفعالة لسلامة بدنه من الأسقام والأمراض، والحفاظ عليه من كل ما يؤذيه أو يوهن قواه أو يعرقل نموه. فالإسلام يطلق لعقل الإنسان العنان ليفكر ويتعلم ويبحث ويهتدي ويكتشف ويخترع ويؤلف ويملأ قلبه بحب الإنسانية والعمل لخير البشرية، وينقي روحه بالعبادات والقيم الفاضلة().
عند مناقشة مفهوم ومضمون التنمية البشرية في المرجعية الإسلامية ينبغي التأكيد على إن هذا الذي سنفهمه من الآيات التي سنوردها كان دائما حاسرا فيها، بمعنى انه كان «قابلا للتفكير فيه» بل إن المفسرين القدماء قد فكروا فيه بالفعل بطريقتهم الخاصة وعلى ضوء مشاغلهم. ومع ذلك فإننا موجهون في قراءتنا للنصوص القرآنية ستكون موجهة في تأسيس مفهوم الإنسان وحقوقه في التنمية على جميع المستويات تأسيسا يجعلها ذات جذور في تراثنا وحضارتنا().
إن ابرز نص يفرض نفسه كنص تأسيسي في إطار ما نفكر فيه الآن هو قوله تعالى ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) (سورة الإسراء/ 70) لقد وردت تلك الآية في سياق مجادلة مشركي مكة الذين امتنعوا عن تلبية دعوة الإسلام وترك عبادة الأصنام، وفي إطار إقامة الحجة عليهم يذكرهم القرآن بجملة من الظواهر والأحداث التي تدل على إن الله وحده الإله وانه واحد لا شريك له. ومن جملة الوقائع التي يذكرها القران في هذا السياق والتي لها علاقة مباشرة بأية (تكريم الإنسان) واقعة امتناع إبليس عن السجود لآدم (( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا )) (سورة الإسراء/ 61-62) ويورد القران هذه القصة بعيدا عن هاجس الخطيئة الذي هيمن على الفكر الأوروبي في القرون الوسطى. كما يشتمل مفهوم الإنسان أبعادا عقلية وحضارية إضافة إلى أبعاد أخرى أبرزها استخلاف الله في الأرض وتعليمه الأسماء كلها والتوبة عليه ((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ))، ثم ((وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)) (البقرة، /30 -32، و34 -37) أما الخلافة في الأرض فتعني إعمارها، أي إقامة العمران والحضارة فيها، وأما الخطيئة فقد محتها توبة آدم فتحرر منها هو وذريته، ويبقى بعد ذلك عمله في الأرض التي أمر بالهبوط إليها لعمارتها هو وذريته وليحاسبوا على عملهم فيها إن خيرا فخير وان شرا فشر.
إن الإنسان في القران روح وجسم ولم يرد في القران قط ما يحط من قدر الجسم، بل بالعكس يذكر الجسم في القران في معرض الأمور التي بها يكون الفضل والتفوق، ومن ذلك قوله تعالى (( لقد خلنا الإنسان في أحسن تقويم ))( التين/ 4) وأيضا: (( وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات )) (غافر/ 64). وبهذا المعنى فتكريم الإنسان يعني تمتيعه بجملة من الحقوق، للجسد حق وللنفس حق، ولكن ما هي هذه الحقوق، حقوق الإنسان في التصور الإسلامي؟ إن الجواب على هذا السؤال يمكن إيجازه بالقول: إن حقوق الإنسان في الإسلام هي جميع الأمور المادية والمعنوية التي تجب له بموجب تكريم الله له وتفضيله إياه على سائر خلقه. وفيما يلي عرض موجز لهذه الحقوق.
أولا: الحقوق العامة(): حقوق الإنسان بالإطلاق
1. حق الحياة: فالحياة هي هبة من الله إلى الإنسان فهي حق له (( وهو الذي أحياكم ثم يميتكم … )) (الحج/ 66) يجب عليه الحفاظ على مقوماته الجسمية والنفسية، إذ ليس لأحد أن يمس حياته لا في جسمه ولا في روحه.
2. حق التمتع بالحياة: منح الله الإنسان الحياة ليحياها ويتمتع بها، وقد سخر له ما فيها وفسح له المجال لإشباع رغباته وحاجاته منها ما عدا ما فيه ضرر له أو يتسبب بإلحاق الأذى بالمخلوقات، جمادا كانت أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا، ويعبر القران عما يحق للإنسان أن يتمتع به بلفظ « الطيبات » وهي كل ما لم يحرمه الله وكل ما هو صالح لا ضرر فيه ولا إفساد. (( قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق )) (الأعراف/ 32)
الحق في حرية الاعتقاد: تعد الحرية أهم قيم الحياة السياسية في المجتمع الإسلامي. وهي التي يعدها الكثيرون الوجه الآخر للتوحيد، لان التعبد لله وحده يحرر الفرد من أي عبودية لأي إنسان آخر مهما علا مقامه. وللحرية وجهان: حرية الاعتقاد وحرية التعبير والاختيار. وقد بين القرآن أنه لا سبيل إلى الحجر على حرية الناس في الاعتقاد والتفكير(). ذلك الله خلق الإنسان وزوده بالعقل والقدرة على التمييز وأبان له السبل ثم ترك له حرية الاختيار. ((إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا))(الإنسان/ 2-3)
وتسير حرية الاعتقاد جنبا إلى جنب مع حرية التعبير، التي لا يحكمها سوى إطار واحد، يتمثل في ألا يكون التعبير طعنا في الدين أو خروجا عليه، حيث يعد ذلك مخالفا للنظام العام في الدولة الإسلامية، فضلا عن أنه يشكل عدوانا على حق والتزام جماهير المتدينين().
3. الحق في المعرفة: على إن إقرار القران حق الإنسان في حرية الاعتقاد لا يعني أن العقائد عند الله متساوية. لان الإسلام دين، وكجميع الأديان والمذاهب فان العقيدة الصحيحة هي التي يقررها ويدعو إليها: عقيدة التوحيد، وإذا كان القران يتوعد المشركين بالعذاب فانه يقرر من جهة أخرى إن الله لا يعذب من لم تبلغه الرسالة والدعوة، ومن هنا كانت المعرفة حقا من حقوق الإنسان فلا يؤاخذ ولا يعاقب عما لا معرفة له به، يقول تعالى (( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ))( الإسراء/ 15)
4. الحق في الاختلاف: يقرر القران الاختلاف كحقيقة وجودية، وكعنصر من عناصر الطبيعة البشرية، فاختلاف ألوان البشر ولغاتهم وجنسياتهم وتوزعهم إلى أمم وشعوب وقبائل، وكل ذلك أراده الله تعالى، تماما مثلما أراد الاختلاف في عناصر الكون ليجعل منه علامة على وجوده. هذا على الصعيد الطبيعي، أما على الصعيد العقيدي فان القران يقرر تعدد الأديان واختلافها في آيات عديدة. إن حق الاختلاف الذي يضمنه الإسلام لا يعني تشجيع الناس على الفرقة والتنازع، بل العكس، فالإسلام يحرص على وحدة الأمة ويشجب بقوة الاختلاف في الدين الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة، يقول تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا …))( آل عمران/ 103)
5. الحق في الشورى: ويرتبط بحق الاختلاف الحق في الشورى وهو حق يقرره القران والحديث وتشهد له سيرة النبي وأعمال الصحابة. والشورى إحدى الصفات الجوهرية في المؤمن ويضعها القران في مستوى واحد مع اجتناب الكبائر والقيام بالواجبات الدينية. يقول تعالى (( فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون )) (الشورى/ 36 – 39) والواقع إن نقاشا طويلا جرى بين الفقهاء والمفسرين حول ما إذا كانت الشورى ملزمة، أي يجب على الحاكم العمل بالرأي الذي تفضي إليه أم أنها معلمة فقط بمعنى أن الحاكم إنما يستشير للاستنارة والاسترشاد لا غير وانه حر في أن يأخذ برأي من استشارهم أو لا يأخذ به.
إن الشورى جزء من منظومة فكرية تعلن حضور الإنسان ومسؤوليته عن التغيير، ومن ثم مشاركته في صناعة حاضره ومستقبله، وبهذا المعنى فهي منتج طبيعي لتلك المنظومة. ويذهب احد الكتاب إلى اعتبار الشورى أوسع نطاقا من الديمقراطية، وأنها أعلى مراحل الديمقراطية.. لان «الشورى تعني أن يكون لك قول ورأي، أما الديمقراطية فهي أن يكون لك صوت. والفرق بين الاثنتين أنك في ظل الشورى ينبغي أن تكون لك كلمة في كل ما يجري في البلد ومصالحه، أما في الديمقراطية فأنت تدلي بصوتك لصالح مرشح معين…»()
6. الحق في المساواة: يقرر القرآن المساواة بين الناس في آية شهيرة محكمة قاطعة هي قوله تعالى: (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ))(الحجرات/ 13) ويعرف المفسرون معنى المساواة من هذه الآية إلى نفي التفاوت والتفاضل في الأنساب، مركزين انتباههم على الألفاظ التالية الواردة في الآية المذكورة: ذكر وأنثى، شعوب وقبائل. لكن سياق الآية يؤكد النفي العام لجميع أنواع التفاوت والتفاضل غير التقوى، والنهي عن التفاخر. وثمة قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها هي أهمية المساواة بين الرجل والمرأة حيث إن النص يكشف بما لا لبس فيه «أن المرأة المتمتعة بالقيم الأخلاقية في معاملتها وعبادتها أفضل من الرجل حكما، فقد وضع اله سبحانه وتعالى مقياسا محددا للتفاضل هو التقوى»().
كما يؤكد القرآن المساواة بين الأفراد يقررها بين الأمم الشعوب فلم يفضل أمة الإسلام إلا بما تقوم من خير وأعمال معروفة عند الناس كافة بصلاحها واندراجها في دائرة الخير العام. يقول تعالى: ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون))( آل عمران/ 104).
7. الحق في العدل: شغل العدل حيزا هاما في القرآن والحديث، وعند المفسرين والفقهاء والمتكلمين ولدى الكتاب والمؤلفين في الآداب السلطانية. ففي القران يتكرر الأمر بالعدل على جميع المستويات: فالرسول مأمور بالعدل ليس بين المسلمين وحسب، بل حتى بين غير المسلمين إذا احتكموا أليه (( وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأُمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم )) (الشورى/ 15). ويأتي الأمر بالعدل بصورة عامة ومطلقة في آيات عديدة مثل قوله تعالى : (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي )) (النحل/ 90) أما الأحاديث التي تروى في العدل فكثيرة ومتنوعة منها قول النبي (ص) «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر في مقدمتهم (الإمام العادل). أما كتب الآداب السلطانية فإنها تكرر عبارة «العدل أساس الملك» وتورد في شرحها وتأكيد معناها أقوالا منسوبة إلى فلاسفة اليونان وحكماء الفرس والهند ورجالات الإسلام.
ثانيا: الحقوق الخاصة
هناك إلى جانب الحقوق العامة حقوق خاصة بفئة معينة من الناس هم: المستضعفون، المرأة، وحقوق الله وحقوق الناس. وهي لا تقل أهمية، إذ عليها تتوقف الممارسة الكاملة للحقوق العامة الأساسية().
1. حقوق المستضعفين، الضمان الاجتماعي: وقد سمى القران أصنافا كثيرة من المستضعفين، بل لقد أحصاهم إحصاء، فهم الضعفاء من ذوي القربى (العجزة من الآباء والأمهات وبقية الأقارب) والفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل والسائلين والعبيد والأسرى… وقد خص القران هؤلاء بعناية بالغة فأكد مرارا وتكرارا حقوقهم وأوصى بالوفاء بها وتوعد كل من مسها أو هضمها. (( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ))(البقرة/ 177). والمستضعفون الذين ذكرتهم الآية هم: ذوي القربى (والمقصود المحتاجون منهم)؛ اليتامــى؛ المساكـين (وهم الذين لا يملكون ما به يعيشون، وهو بالاصطلاح المعاصر العاطل الذي لا يجد عملا يكسب منه قوته وقوت عياله)؛ ابن السبيل (هو المسافر الذي تقطعت به الطريق، ويمكن أن يحمل عليه «اللاجئ السياسي» بالمعنى المعاصر)؛ السائلــين (الذين يسألون الناس الصدقة سواء بسبب فقر أو بسبب ظرف طارئ)؛ الرقــاب (أي العبيد، فقال بعض المفسرين إن المقصود هو شراء العبيد وعتقهم).
إضافة إلى الأصناف المذكورة وردت في القرآن أصناف أخرى من المستضعفين مثل قوله تعالى (( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ))(الحج/ 28). فالبائس هو الذي أصابه عسر وشدة، أما الفقير فهو الذي لا يكفيه ما في يده لقوته وقوت عياله. وأما الزكاة فهي لأصناف ثمانية ذكرهم القرآن في قوله تعالى: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله))( التوبة/ 60). أما المساكين والرقاب وابن السبيل فقد سبق ذكرهم. ويبقى ذكر العاملين عليها أي الذين يقبضونها ويجمعونها ويأتون بها إلى ولي الأمر، وهؤلاء تدفع لهم الزكاة تعويضا لعملهم. وأما المؤلفة قلوبهم فهم بعض أشراف العرب كان الرسول يستألفهم بها ترغيبا لهم في الإسلام. وأما الغارمين فهم الذين كثرت عليهم الديون فأصبحوا لا يملكون شيئا بعدها. أما في سبيل الله فهم فقراء المجاهدين والحجاج الذين تقطعت بهم الطريق. وهكذا نرى إن «حقوق المستضعفين» صنفان: حق في الزكاة، وحق في البر. والفرق بينهما هو أن الزكاة جعلها الله ركنا من أركان الإسلام مثل الشهادة والصلاة والصيام والحج، بمعنى أن إسلام المرء لا يكتمل إلا بالإقرار بها كفريضة من الله، وهي رمز لولاء الفرد المسلم نحو المجتمع الإسلامي ككل.
2. حقوق الله وحقوق الناس: تطبيق الشريعة. فالأولى تشمل الإيمان وسائر الفرائض والسنن التي لها مظهر تعبدي. أما حقوق الناس فهي تنحصر في حق أولياء المقتول (قتل القاتل أو الدية)، حق الجروح في القصاص، حق الرجل لما يمس عرضه كاللعن والشتم، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، وحقوق الورثة.
3. حقوق المرأة: فالإسلام يقرر مبدأيا، وكحكم عام ومطلق، المساواة بين الرجل والمرأة(). ينفرد الإسلام عن غيره من الأديان في أنه يضع المرأة في مكانة مرموقة، ويقيم توازنا منسجما بينها وبين الرجل. فلكل دوره في بناء الحياة الإنسانية، ولكل مجاله واختصاصاته التي يتمايز بها عن غيره. يقول تعالى في كتابه العزيز (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم )) (الحجرات/ 13) فالقرآن والسنة النبوية حررا النساء من الظروف غير المقبولة التي سادت في الجزيرة العربية قبل الإسلام، وان الأخير منح النساء موقعا يفوق ما منحته لهن التعاليم الدينية الأخرى، إذ كان عليهن في الديانات الأخرى بذل مجهود عظيم لإحراز المستوى والوضع العالي الذي ضمنه لهن القرآن قبل أربعة عشر قرنا. ومن ناحية الحقوق التي ضمنها الإسلام للنساء، حق الحياة، التعليم، إدارة الأعمال، الإرث، الاحتفاظ بالملكية، المحافظة على أسمائهن، في وقت ما زالت في العادات الاجتماعية السائدة تمنع الحصول على تلك الحقوق().
الآفاق الرحبة لتنمية المرأة في الإسلام
لقد انتقل الإسلام بوضع المرأة من العدم إلى الوجود، ومن الشك إلى اليقين، ومن المهانة إلى الكرامة. فقد أعلن لها إنسانية كاملة، وأهلية كاملة للحقوق، ومسؤولية كاملة. لذا فقد أوقفها الإسلام إلى جانب الرجل(). ويعترف القرآن الكريم للمرأة المسلمة بكفايات وحقوق في كل مظاهر التصرف والتدبير وخاصة في ميدان الاقتصاد وميدان الأحوال الشخصية. فللمرأة حق الإرث والهبة والوصية والتملك والحيازة وإمضاء العقود والتعرض أمام القضاء والتصرف الكامل في أموالها، ولها أن تسهم في أي شركة مالية مع زوجها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى خلل البيت، كما تتمتع بحق الاختيار الحر لشريكها، حتى لو كانت بكرا، أو لتجديد زواجها عند الترمل (وهذا الحق الأخير لم تحصل عليه المرأة الأوروبية إلا في عهد متأخر)().
إن الإسلام يضع المرأة والرجل معا في مقام الاستخلاف على رعاية الأمانة الإلهية في تطبيق الشريعة وفق حدود الله. لذا فقد أفتى الفقهاء الشيعة بجواز ترشح المرأة للدخول في البرلمان وسائر المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي وكرامتها كامرأة مسلمة().
وتختلف وجهة نظر الفقهاء تبعا للمذهب الذي ينتمون عليه، وفي الوقت الذي يذهب الفقهاء السنة إلى القول بعدم جواز تقلد المرأة رئاسة الدولة لان هذا المنصب يتضمن اختصاصات دينية وسلطات سياسية تخرج عن قدرتها، كما لا يجوز أن تولى الإدارة على البلاد ولا على الجهاد ولا على ولاية المظالم أو الحسبة. محتجين في ذلك بقول الرسول لما بلغه أن أهل فارس ولوا عليهم بنت كسرى: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وأما الوزارة فهي الأخرى لا تجوز للمرأة لان الوزارة تعتبر من الولايات المصروفة عن النساء. كما أن النيابة ولاية عامة ولا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي خاصة أن النيابة تقتضي التشريع في كل شيء، والمرأة ليست قادرة على ذلك بطبيعتها. فيما اتفق فقهاء المالكية والحنبلية والشافعية على شرط الذكورة بالنسبة للقاضي. أما فقهاء المذهب الحنفي فإنهم وان لم يشترطوا الذكورة إلا في الحدود، فإنهم يرون مع ذلك عدم توليها القضاء، فان وليت القضاء في غير الحدود نفذ قضاؤها وأثم موليها().
أما الفقهاء الشيعة فإنهم ينقسمون على مدرستين تذهب الأولى إلى اتخاذ الموقف الذي عليه أغلب الفقهاء المسلمين من رفض أحقية المرأة بالحكم والقضاء(). فيما تذهب المدرسة الثانية إلى جواز ترشح المرأة لشغل المناصب السياسية المرموقة. لان قوامة الرجل على المرأة «الرجال قوامون على النساء» (النساء/34) تقتصر على الحياة الأسرية، وأما في الحياة العامة، فلا فرق بين الرجل والمرأة(). لذا لا فرق بينهما في إطار النظام الإسلامي العام بكافة أشكاله وألوانه من العقائدي والعملي والسياسي والاقتصادي والحقوقي وغيرها، مع استثناءات قليلة().
فيما يذهب الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى ابعد من ذلك عندما توصل إلى أن الأدلة المعتمدة من الفقهاء في شأن عدم أهلية المرأة للسلطة ورئاسة الدولة، واشتراطهم الذكورة «ليست معتبرة» وان أهليتها كاملة في تولي الكثير من المسؤوليات السياسية().
لقد عزز الإسلام مبدأ مسؤولية المرأة إلى جانب الرجل، فقد قال رسول الله (ص): «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه، وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». ومؤدى ذلك أن الإسلام وزع المسؤولية بين كل مسؤول تبعا للولاية الثابتة للجميع على اختلاف أعمالهم في المجتمع، وعلى أساس أن كلا منهم مسخر للآخر من غير تمييز بينهم، فولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذاً ثابتة للجميع، ممن ثم لم تقتصر هذه الولاية على فريق دون أخر، ولا لجنس دون جنس آخر().
لكن ينبغي الالتفات إلى الافتراق البين بين النظرية الإسلامية والواقع المعاش في المجتمعات الإسلامية، فالظلم والإجحاف الذي يقع على المرأة ليس نتاج التبرير الذي يعطيه الإسلام لظلمها، حاشى ذلك، فالنظرية الإسلامية حول المرأة ترفض كل صور الظلم والإجحاف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعاتنا انطلاقا من منظومة الحقوق الواسعة التي منحتها للرجل والمرأة. فالمسؤولية تقع على النظم السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة التي تنتهك حقوق الرجل والمرأة على حد سواء. فمبادئ الإسلام وتعاليمه أحدثت تغييرا جذريا في مكانة المرأة، من خلال ما منحها من حقوق لم تعرفها في الجاهلية، وأول تلك الحقوق الحق في الحياة عندما حرم وأد البنات، كما ألغى المعايير الاجتماعية المزدوجة التي تبيح للرجل وتمنع المرأة، وساوى بينهما في الأحكام الإسلامية، فاقر لها شخصية معنوية كاملة. ولا ننسى أن ذلك قد حصل منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا. لقد وضع الإسلام التشريعات التي تضمن حقوق المرأة وتمنع استغلالها من قبل الرجال، واتجه نحو تغيير صورتها ومكانتها في المجتمع على نحو ثوري، أكسبها صفة الإنسانية التي كانت المجتمعات الجاهلية تنفيها عن المرأة. لكن مصدر الإجحاف بحقها إنما جاء نتيجة ابتعاد المسلمين، في نظرتهم للمرأة، عن تعاليم الإسلام، وتفضيلهم الأعراف والتقاليد والعادات التي عادت للازدهار في ظل تشجيع الدول الاستبدادية التي ظهرت بعد انتهاء الخلافة الراشدة.
بناءً على ما تقدم نجد إن منظومة حقوق الإنسان في الإسلام هي منظومة متكاملة، تلحظ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة من حياة الإنسان وعلاقاته في إطار الجماعة التي يعيشها، والطبيعة المتغيرة والمتطورة للمجتمعات مع تقدم الزمن وتعقد جوانب الحياة.
حال المرأة في العراق
يمنى العراق بأفدح الخسائر في تاريخه التنموي، فخلال سنوات الاحتلال الماضية أُزهفت أرواح 655 ألف نسمة،() وخُلف ستة أضعاف هذا العدد يعانون من تبعات هذا الفقدان (يتامى، أرامل، مفجوعون،..). إن السنوات الحالية هي الأكثر دموية في تاريخ العراق رغم أن البلد شهد عبر تاريخه الضارب في القدم حروبا ومواجهات عنيفة. فتقديرات الضحايا تفوق ما فقده العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية وحرب عاصفة الصحراء.
كان العراق من أوائل البلدان التي حصلت فيها النساء على فرص للعمل في مجالي التعليم والتمريض وبخاصة بعد تأسيس الدولة العراقية. وخلال الثلاثينات نشطت الحركات النسوية الداعية إلى تحرير المرأة متأثرة بالحركة الشيوعية التي طغت على تلك الحقبة. وفي عام 1959 شغلت أول امرأة في العراق منصبا وزاريا. وفي السبعينات بادرت سلطة البعث إلى زج المرأة في خططها السياسية وشهد العراق صعودا في الحركة النسوية في حدود ما سمحت به الدولة. وفي سنوات الثمانينات ومع انشغال الرجل بالحرب كان للمرأة أن تملأ الكثير من الفراغات التي خلفها الرجل بعد انخراط ما يزيد على مليون رجل في القوات المسلحة إبان تلك الحرب. مع ذلك ظلت مساهمة النساء في سوق العمل خلال الثمانينات منخفضة، زادت تدهورا خلال التسعينات الذي اتسمت سنواته بانخفاض حاد في الأجور الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إن تزايدت انسحابات النساء من العمل.
وإذا تفحصنا جميع الدساتير العراقية بدءً بالقانون الأساسي (1925) وحتى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية نجدها جميعا قد نصت على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو القومية. إلا أنها جميعا فيما عدا قانون إدارة الدولة، لم تضع آلية لتفعيل هذه المساواة(). وهي الآلية التي امتدت إلى الدستور الدائم عبر المادة (47)/ رابعا والتي نصت على أن «يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب» واعتبرت هذه الكوتا Quota مكسبا للمرأة العراقية وخطوة مهمة في اتجاه حصولها على المشاركة الفعلية في جميع السلطات ودوائر صناعة القرار. وهو أمر تعزز بالمادة (20) التي نصت «للمواطنين رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح» وبفضل قانون الانتخابات فقد حصلت المرأة على الأرقام 3، 5، 8، 12 في القائمة الانتخابية وبهذا فان القانون يمكن أن يؤمن لها نسبة تقترب من الثلث. وبالفعل فقد تم انتخاب 86 امرأة في الجمعية الوطنية الانتقالية أي حوالي 31 في المائة من مقاعد الجمعية البالغة (275) مقعدا. لكن النسبة تراجعت إلى حوالي 25 في المائة في مجلس النواب الحالي.
وفي السلطة التنفيذية فان المرأة حصلت على 6 وزارات في حكومتي إياد علاوي (28 حزيران/ يونيو 2004-3 أيار/ مايو 2005) وإبراهيم الجعفري (3 أيار/ مايو 2005-20 أيار/ مايو 2006)، وتقلصت الحصة إلى أربع وزارات فقط في حكومة نوري المالكي الحالية. والحصة هي اقل بالنسبة لحكومة إقليم كردستان إذ لم تحصل النساء إلا على 4 وزارات في حكومة نيجيرفان بارزاني الحالية من أصل 41 منصبا وزاريا.
جدول رقم (1)
حصة المرأة من الوزارات العراقية بعد الاحتلال
| الوزارة | عدد المناصب الوزارية | حصة النساء | |
| العدد | النسبة المئوية | ||
| الوزارات الاتحادية | |||
| وزارة أياد علاوي | 32 | 6 | 18.75 |
| وزارة إبراهيم الجعفري | 34 | 6 | 17.64 |
| وزارة نوري المالكي | 37 | 4 | 10.81 |
| وزارة إقليم كردستان | |||
| وزارة نيجيرفان البارزاني | 41 | 4 |
9.75 |
المصدر: حسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة الأحزاب العراقية، دار العارف للمطبوعات، بيروت، 2007، الملحق رقم 2
بالرغم من تغير الواقع الاقتصادي للبلد، فان ممارسات العقود الماضية مستمرة في التأثير على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة. وعلى الرغم من أن التغيرات التي تلت التاسع من نيسان/ ابريل 2003 في تحسين حقوق ومكانة المرأة في المجتمع. لكن تلك التبدلات أعادت الاعتبار إلى مسألة التمييز بين الجنسين، وأعطت زخما قويا لإعادة الاعتبار للمرأة العراقية.
ما يزال العراق يعاني من محدودية مشاركة المرأة رغم أن الدولة كانت قد استثمرت الكثير من الموارد للاستثمار في مجال تعليم الإناث، الأمر الذي يجعل نسبة مشاركة المرأة في البلد أقل بكثير من إمكانياته الفعلية.
تعتبر العقبات المرتبطة بالنوع الاجتماعي مظهرا مهما للفقر في العراق، ذلك انه من المهم أن يكون كل فرد قادراً على الوصول إلى تملك الأرض والى القرض والتعليم والسكن وخاصة في حالة النساء الفقيرات. ذلك أن تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين النساء يعد من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية البشرية. لكن هذه القضية تكتسب خصوصية تنبني على طبيعة المجتمع العراقي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي أثرت وتؤثر في صياغة شكل وطبيعة العلاقة الجندرية. ومهما يكن من أمر فان للنوع الاجتماعي أثره في توصيف المشهد التنموي في العراق وبخاصة وانه لم يجر حتى الآن تفحص وتحليل نظري وعملي شامل ومعمق لقضايا النوع الاجتماعي في البلد، ولم تول أدبيات التنمية البشرية في العراق اهتماما ذا بال بمقولة النوع الاجتماعي واختلطت بالتحليل على أساس الجنس وهو تحليل أدنى من تحليل النوع الاجتماعي واقل سعة وشمولا(). وجدير بالذكر أن الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع العراقي تشكل حوالي 11 في المائة من مجموع الأسر المسجلة في دراسة مسح الأحوال المعيشية في العراق. ومن بين تلك الأسر هناك 73 في المائة تعيلها الأرامل()، تتفاقم بين صفوفها ظاهرة الفقر.
ويظهر مؤشر النوع الاجتماعي بوضوح الفجوة في مؤشر التعليم بين الإناث والذكور، وما يتعلق بالتمكين السياسي والمشاركة الاقتصادية. وهو ما يتطلب وضع السياسات الكفيلة بتضييق هذه الفجوة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادي