البطالة في العراق: المظاهر، الآثار وسبل المعالجة
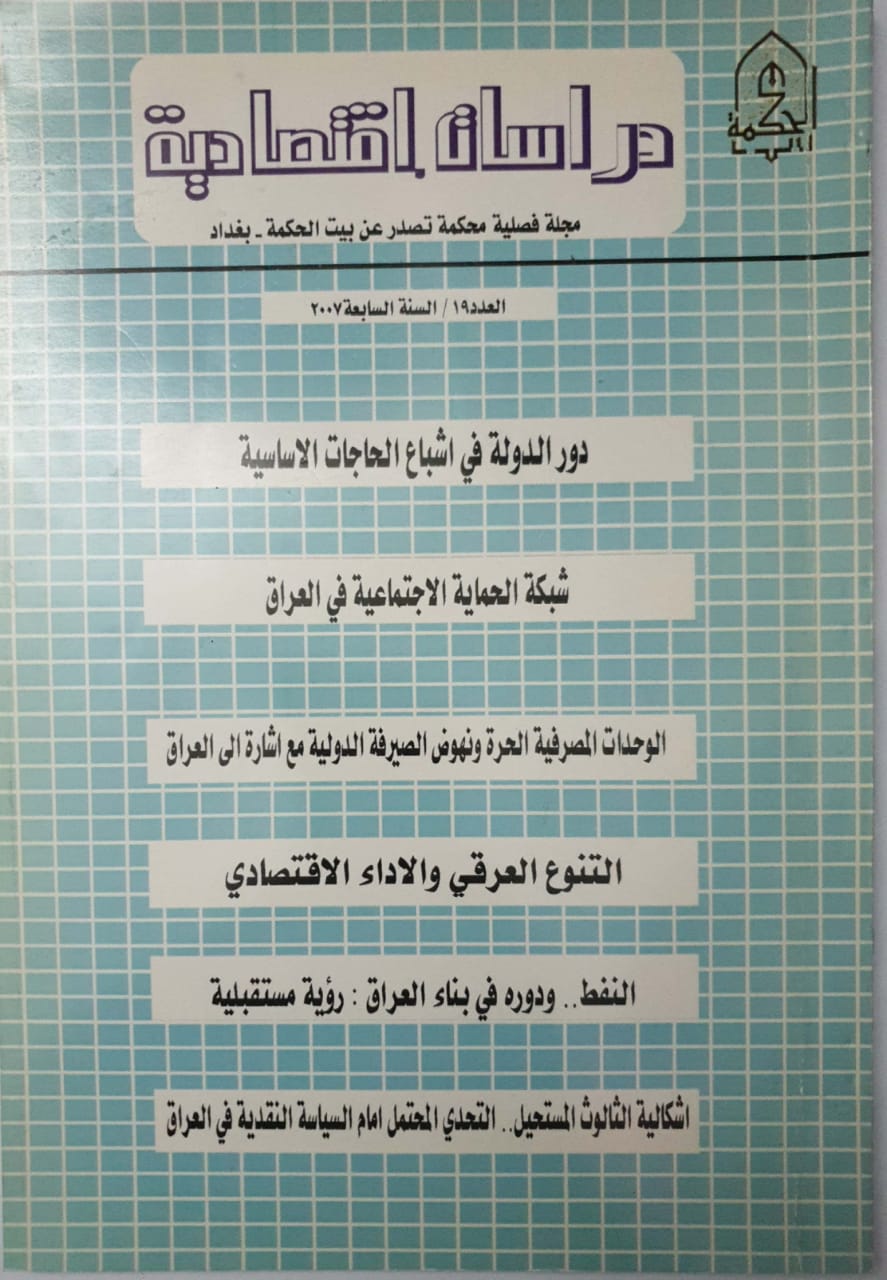
البطالة في العراق: المظاهر، الآثار وسبل المعالجة
أ.م. د. حسن لطيف كاظم الزبيدي*
أولا: الخلاصة والمقدمة
لم تحقق السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الحد من ظاهرة البطالة إلا القليل من النجاحات والكثير من الإخفاق، فقد أدت سياسة توسيع القطاع العام واستيعاب نسبة مرتفعة من قوة العمل، إلى ترهل هذا القطاع واستفحال ظاهرة البطالة المقنعة. كما إن رسم السياسات وتنفيذها كان في الغالب دون تقويم جدي ومتابعة دقيقة ومراجعة لنتائجها. إن اتجاه الدولة نحو تعزيز القطاع الخاص ومنحه محفزات ومناسبات للعمل والنمو في ظل اقتصاد مضطرب يتزايد إلحاح المؤسسات الدولية لتحريره بحجة جدولة الديون وخفضها تقلل من الأدوات المتاحة لمعالجة البطالة، كما إنها تفرض صعوبات حقيقية فيما يتصل بنتائجها وآثارها على المشمولين بها.
تعتبر البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي يواجهها العراق فعلى رغم إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يمثل هدرا في عنصر العمل البشري، فإن للبطالة نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة.
إن خصوصية ظاهرة البطالة وفرادتها تأسيسا على فرادة الوضع العراقي، تفرض على صانع القرار الاقتصادي إيجاد حلول استثنائية للتعامل مع الظاهرة، لأنها تتعلق بالواقع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلد، فضلا عن تعلقها، كظاهرة اقتصادية- اجتماعية، بالبنى الاقتصادية الاجتماعية السائدة، وهيكل الاقتصاد وأهمية القطاعات وأنماط التعليم والتدريب والفنون التكنولوجية.
يسعى هذا البحث إلى تحديد إطار سياسي لمعالجة البطالة يقوم على أساس حزمة من السياسات الهادفة إلى إصلاح سوق العمل، وتعزيز النشاط الخاص المستوعب للمزيد من العمالة، وتقليل وطأة ما يمكن تسميته الآليات المولدة للبطالة وهي: التدهور الأمني، تباطؤ الإعمار، محدودية النشاط الخاص، ضخامة حجم الدولة. وترتكز المعالجة على دعم القطاعات المستوعبة للعمالة وإصلاح القطاعين الزراعي والصناعي باتجاه زيادة نسبة مساهمتهما في الناتج والتشغيل.
ثانيا: نظرة إلى أوضاع الاقتصاد العراقي
منذ ثمانينات القرن الماضي تزايد اعتماد العراق على قطاع النفط، والتوسع غير المستدام لقطاع الخدمات غير المنتجة وبخاصة تلك المتصلة بالمؤسسة العسكرية، مترافقا مع إهمال القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة، وإهمال الاستثمار الإنتاجي في النشاطات المدنية وتزايد سيطرة النخبة الحاكمة على مؤسسات الدولة. وقد تفجرت مشكلة البطالة مباشرة عقب انتهاء الحرب العراقية -الإيرانية مع تسريح ما يقرب من مليون مجند، ليدخلوا سوق العمل دون مهارات تؤهلهم للحصول على عمل ذي دخل مجز.
وفي ظل العقوبات الاقتصادية تقيدت قدرة الاقتصاد العراقي على توليد فرص عمل كافية لتشغيل العرض الكبير من القوة العاملة مما أنتج معدل بطالة أخذ يرتفع باستمرار مع فقدان القطاع العام لجاذبيته في التوظيف خلال السنوات (1991-2002).
كان الاقتصاد العراقي عشية الغزو الأمريكي يئن تحت وطأة الظروف القاسية ويعيش في أسوأ حالاته. فقد كان اقتصاد محطما بفعل سنوات من الحروب الداخلية والخارجية والعقوبات والإدارة السيئة وتوقف عملية التنمية وإهتراء البنى التحتية ومؤسسات القطاع العام وتضاؤل الفرص أمام النشاط الخاص. وبعد سقوط النظام السابق تفاقمت الأوضاع الاقتصادية وخلق العنف وسيادة الفوضى الأمنية في أنحاء مختلفة من البلد تعطيلا شبه كامل للخدمات العامة وأدى إلى حدوث نقص حاد في الإنتاج المحلي وتوقف شبه تام في إعادة الإعمار.
وخلال كل تلك السنوات ورغم الصعوبات تعايش في الاقتصاد قطاعان متمايزان، فإلى جانب القطاع العام كان هناك قطاع خاص حقيقي يوظف ثلثي اليد العاملة، إلا إن معظم تلك الوظائف كانت في اقتصاد الظل الذي تطور الذي تسارع نموه خلال التسعينات.
ومع أن العمليات العسكرية أحدثت ضررا ضئيلا بالبنية التحتية إلا إن أعمال السلب والنهب التي رافقت الغزو أحدثت معظم الخراب الذي طال هذه البنى. وفي ظل الظروف الصعبة التي برزت بعد الحرب مباشرة، أعدت سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومة العراقية المؤقتة تصورا لإعادة إعماره يرتكز على هدفين هما([1]):
· إعادة ترميم البنى الإنتاجية في قطاعات السلع والخدمات؛
· القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية لإرساء أسس اقتصاد السوق.
في ظل الاحتلال تدهور أمن المواطن واستبيحت حياته مجدداً. وبسبب فشل سلطات الاحتلال في ضمان الأمن والاستقرار شهد العراق انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وانتشرت أعمال القتل والإرهاب في معظم أرجاء العراق([2]). لقد غيَّر الاحتلال الراهن ونتائجه سلم أولويات المشكلات التي يعاني منها الشعب العراقي، وباتت التهديدات الأمنية هي أكثر المشكلات إلحاحا، بل باتت محور لمشكلات أخرى في وقت تحاول الدولة العراقية فيه اكتشاف قدراتها على العمل في بيئة شديدة الخطورة، وخلق نظام سياسي يمكنه أن يلبي متطلبات الناس على الصعيد الوطني.
فرضت هذه الظروف الاستثنائية على سلطات الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة مواجهة الفوضى الاقتصادية التي أنتجتها الحرب وتفاقم التدهور الأمني، وقادت الأخطاء السياسية والاقتصادية إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية. فالأهداف التي أعلنت من جانب سلطة الائتلاف لم تحقق فتدهور امن الإنسان وزادت حالات البؤس والفقر وتراجعت مؤشرات النمو الاقتصادي وتفاقمت حدة بعض المشاكل كالبطالة والنقص في الطاقة. كما إن السير المتعجل نحو اقتصاد السوق لم يؤد إلى زيادة فاعلية تخصيص الموارد، وإنما قاد إلى تدهور حاد الطلب المحلي على عناصر الإنتاج مع إغراق السوق المحلية بالسلع الأجنبية، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لان معظم الزيادة الحاصلة في الإنتاج القومي مصدرها إنتاج وتصدير النفط الخام في ظل الارتفاع المواتي في الأسعار.
تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، ذلك إن قطاعات الاقتصاد الأخرى لم تلحق بالنمو الذي حققه قطاع النفط حيث بلغ معدل نموها الحقيقي عام 2004 بحدود 8.4 % مقابل انخفاض بنسبة 28 % عام 2003. وقد يعود ذلك إلى استمرار حالة الصراع والتخريب وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي التي أثرت سلباً على توقعات رجال الإعمال والمستثمرين وعلى مجمل النشاط الاقتصادي([3]).
على ما يبدو أن العراق، ومنذ الغزو الأمريكي، قد ظهرت عليه أعراض «المرض الهولندي» مجددا بعد اختفائها بسبب العقوبات الاقتصادية، فقد أدى انتعاش الاقتصاد النفطي إلى زيادة الواردات الأجنبية، وفقد منتجو السلع الزراعية والصناعية قدرتهم على منافسة السلع الأجنبية الرخيصة، وأدى ذلك إلى منع نمو استثمارات خاصة داخل الاقتصاد، وقلص بالتالي إمكانية خلق فرص عمل جديدة.
لقد أثرت سياسة الانفتاح الاقتصادي غير المنضبط على العالم الخارجي إلى زيادة في الميل للاستيراد بسبب قصور العرض المحلي وتزايد الطلب على السلع والخدمات الجديدة. وقد قدرت نسبة زيادة الاستيرادات بحوالي 65.6 % عام 2004 مقارنة بعام 2002 دون أن ينعكس ذلك على حالة الإنتاج المحلي، وخاصة الصناعي، الذي استمر معطلاً بسبب الخراب الذي أصابه خلال الحرب وحالة النهب والسلب بعد ذلك من جهة، وعدم قدرته على المنافسة أو مواصلة الإنتاج لأسباب عديدة منها: الدمار الذي أصاب هذه المنشآت، وتقادم خطوط الإنتاج والمعدات الإنتاجية، وعدم توفر الأمان والاستقرار، وشح الطاقة الكهربائية، وعدم كفاية المنتج منها لسد حاجة الاستهلاك المنزلي من جهة ثانية([4]).
إن طبيعة الاقتصاد والحال التي وصل إليها هي أبرز مسبب لتفاقم أزمة البطالة في البلد، فالتدمير الهائل الذي أصاب الاقتصاد بفعل الحروب وسنوات الحصار العجاف، وتوقف عمليات الإنتاج، والتدهور الأمني أدى إلى توقف شبه كامل للإنتاج القومي، الأمر الذي أثر سلبا على نشاط الأعمال في اقتصاد استمرت الفرص والمبادرات الخاصة تضيق وتتقلص فيه باستمرار. فالاقتصاد العراقي يقدم صورة متطرفة للكيفية التي أدت فيها عائدات النفط في زيادة تخلف بينية القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وفي تشويه هيكل التجارة الخارجية.
ثالثا: مؤشرات البطالة في العراق
لعل الملاحظة التي تسجل على مسوحات التشغيل والبطالة المجراة منذ عام 2003 هو تباينها من حيث تعريف البطالة. فعلى سبيل المثال استخدم مسح الأحوال المعيشية تعريفا متحفظا لمعدل البطالة، يستند أساسا إلى معايير منظمة العمل الدولية (ILO) ، لذا قدر هذا المسح معدل البطالة بحوالي 10.5% مثلما قدم نسبة منخفضة لمعدل النشاط الاقتصادي مقارنة بمسوحات التشغيل والبطالة المنجزة قبله([5]).
واستنادا إلى تعريف منظمة العمل الدولية الأشخاص الذين يعملون أقل من 15 ساعة أسبوعيا على أنهم عاطلون عن العمل. ويعود جزء من الفارق بين التقديرات إلى طبيعة الأسئلة في استمارات الاستبانة الخاصة بكل مسح. ذلك أن مسح الأحوال المعيشية يسأل المستطلعين عن استجاباتهم حول نشاطاتهم خلال المدة المرجعية، بينما تسألهم مسوحات التشغيل والبطالة أن يصنفوا كمشتغلين أو عاطلين أو غير نشيطين، وهي ما تقود إلى قياس أعلى لمعدل البطالة حيث أن الشخص الذي يعمل أكثر من 15 ساعة يستمر في تصنيف نفسه كعاطل عن العمل إذا كان العمل غير نظامي، أو أن أجوره متدنية، أو لا يتناسب مع مهاراتهم، أو لأية أسباب أخرى. ويحصل العكس عندما يبلغ الشخص أنه يعمل في مسح التشغيل والبطالة يكون مصنفا كعاطل في مسح الأحوال المعيشية. وعليه يقدر بعض الباحثين أن ذلك قد أحدث فارقا بين التقديرات، فإذا اعتمدنا تعريف منظمة العمل الدولية في مسح الأحوال المعيشية فان معدل النشاط الاقتصادي سوف يرتفع من 41.4% إلى 44.9%، ويصل معدل البطالة إلى 18.4% بدلا من 10.4%. أما إذا اعتمدنا التعريفات المعتمدة في مسح التشغيل والبطالة (2003 و 2004) فان معدل النشاط الاقتصادي يرتفع إلى 44.9% والبطالة إلى 22.5%([6]). مع ذلك فقد جرى استبدال السؤال الخاص بالقوى البشرية الذي يسأل المبحوثين (( خلال الأيام السبعة الماضية ما هي الحالة العملية لـ(الاسم)؟ يعمل، عاطل يبحث عن عمل (سبق له العمل)، عاطل يبحث عن عمل (لم يسبق له العمل)، ربة بيت تعمل بدوام جزئي، عاطل لا يبحث عن عمل، طالب متفرغ، متفرغة للأعمال المنزلية، متقاعد يعمل، متقاعد لا يعمل، متغيب عن العمل، غير قادر على العمل، لا يرغب في العمل، أخرى))([7]) بالسؤال عن ((خلال الأيام السبعة الماضية هل عمل (الاسم) حتى ولو ساعة واحدة في أي عمل مقابل أجر سواء في مصلحة يملك جزءً منها أو في مصلحة للأسرة دون أجر (كالعمل في مزرعة أو بقالة،…) أو أي عمل آخر))([8]). رغم إقرار مسح الأحوال المعيشية بان اعتماد معدل البطالة القياسي لا يعبر عن حالة البطالة في العراق، وأن حالة البلد تقع ضمن ما يسمى بحالة البطالة المتراخية (relaxed) ((حيث يكون معيار البحث عن العمل متراخيا – ليعالج الحالات التي تكون الطرق التقليدية فيها للبحث عن عمل محدودة المعنى، وحيث يكون سوق العمل غير منظم أو مجاله محدود، وحيث يكون امتصاص العمال غير كاف حينها، أو أن يعمل جزء كبير من القوى العاملة لحسابهم الخاص))([9]). وقد يقع القارئ هنا في لبس أن تفاوت التقديرين (القياسي والمتراخي) هو ما أدى إلى هذا الاختلاف الكبير بين التقديرين، إلا إن الفحص يشير إلى إن الفارق بالدرجة الأساس إلى التعريف المتبنى للعاطل والسؤال الذي يوجه للمبحوثين([10]).
من جهة أخرى، فان تعريف المنظمة لا يشمل الأشخاص المحبطين، أي أولئك الأشخاص الذين لا يبحثون بجد واجتهاد عن وظيفة. ومنشأ الإحباط في حالة العراق ناتج عن فقدان الأمل في الحصول على وظيفة نتيجة نقص فرص العمل. كما التعريف أعلاه يهمل البطالة المقنعة([11]).
منذ عام 2003 أجريت العديد من مسوحات للبطالة أشارت إلى انخفاض معدلاتها العامة في البلد من حوالي 28% عام 2003 إلى 17.5% عام 2006. لكن هذه الأرقام تخفي تباينات مرعبة بين المناطق الحضرية والريفية وبين المحافظات، تبعا لمدى تأثر هذه المنطقة أو تلك بمفاعيل توليد البطالة، وطبيعة اقتصادها. لكن تبقى تلك الفروقات وعدم المساواة بين المناطق أكثر خطورة من انعدام المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية بكل ما يحمله تعبير «المرحلة الانتقالية» معنى يؤشر التحول العميق في البنى والمؤسسات والقيم.
جدول (1)
معدلات البطالة في العراق مقارنة بالمعدل العام حسب الجنس للسنوات (2003-2011)
|
مجموع |
||||
|
ذكور |
إناث |
مجموع |
||
|
2003* |
30.2 |
16.0 |
28.1 |
|
|
2004* |
29.4 |
15.0 |
26.8 |
|
|
2005** |
19.22 |
14.15 |
17.97 |
|
|
2006*** |
16.16 |
22.65 |
17.50 |
|
|
2007*** |
11.7 |
11.7 |
11.7 |
|
|
2008*** |
الربع الأول |
17.08 |
23.35 |
18.23 |
|
الربع الثاني |
15.08 |
19.47 |
15.93 |
|
|
الربع الثالث |
13.77 |
18.48 |
14.68 |
|
|
الربع الرابع |
11.32 |
17.40 |
12.49 |
|
|
متوسط عام 2008**** |
14.31 |
19.68 |
15.33 |
|
|
2011 |
7.00 |
13.00 |
8.00 |
|
* باستثناء إقليم كردستان.
**بأستثناء الأنبار وأربيل ودهوك.
*** بيانات الحضر للمراكز الحضرية.
*** احتسب المتوسط من قبل الباحثين
المصادر:
جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقرير حول نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003، كانون الثاني، 2004، جدول (1)، ص16
جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية الإحصاء الاجتماعي، نتائج مسح التشغيل والبطالة/ المرحلة الثانية، النصف الأول لسنة 2004، كانون الأول 2004، جدول (1)، ص12
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، تموز/ 2007، جدول (3-1)، ص25
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2008، المرحلة الأولى.
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2008، المرحلة الثانية.
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2008، المرحلة الثالثة.
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2008، المرحلة الرابعة.
الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية 2007، جدول 5-4، ص 326-327
تتميز معدلات البطالة في العراق طبقا لأحدث المسوحات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها([12]):
- تتباين معدلات البطالة بين المحافظات التي شملتها المسوحات فقد سجلت بعض المحافظات معدلات منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، في وقت استمرت محافظات تتصدر قائمة المحافظات الأعلى بطالة. ومن ملاحظة الجدول (2) نجد إن استمرت المحافظات من حيث ارتفاع معدل البطالة، تتصدر ذي قار تليها الأنبار ونينوى والمثنى والقادسية. فيما حققت البصرة أدنى المعدلات ثم واسط فالسليمانية وبابل وكربلاء وكركوك.
|
|
|
شكل (1): معدلات البطالة حسب المحافظات 2003-2008 |
جدول (2)
معدلات البطالة في النجف وترتيبها بين المحافظات
|
|
معدل البطالة |
الترتيب |
|
2003 |
18.1 |
13 |
|
2004 |
21.6 |
10 |
|
2005 |
23.7 |
4 |
|
2006 |
18.9 |
5 |
|
2007 |
10.7 |
10 |
|
2008 |
11.7 |
8 |
|
2011 |
8.0 |
11 |
يعود السبب الرئيس وراء ارتفاع معدلات البطالة في محافظة مثل ذي قار إلى طبيعة اقتصاد المحافظة المتمحور أساسا حول الزراعة والرعي ومحدودية النشاط الخاص فيها، وهو ما ينطبق أيضا على المثنى. كما إن عدم الاستقرار الأمني أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في كل من الأنبار ونينوى وديالى.
وفي المحافظات ذات المعدلات المنخفضة نسبيا من البطالة فان طبيعة اقتصادها يلعب دورا رئيسا في تحديد سلوك ظاهرة البطالة فضلا عن الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع به. فكبر اقتصاد البصرة ووجود المنشآت النفطية والميناء كلها زادت من فرص الحصول على عمل. كما ان الاستقرار الأمني ووجود المعابر الحدودية مع إيران قد أنعش اقتصاد واسط والسليمانية. أما كربلاء والنجف فإنهما يعتبران من أهم مناطق السياحة الدينية، كما إن كربلاء تعتبر منطقة زراعية نشطة نسبيا، بسبب طبيعة القطاع الزراعي القائم على المحاصيل الدائمة التي تشكل (69.11 %) من مجموع الحيازات الزراعية وحوالي (37.55 %) من مجمل الأراضي الزراعية في المحافظة، كما إنها تنتج (13.7 %) من التمور في البلد، وهي زراعات مستقرة مقارنة بأنماط الزراعات السائدة في مناطق أخرى من العراق التي تعتمد على زراعة الحبوب أو الخضار، لهذا فالقطاع الزراعي في كربلاء يشغل (10.13 %) من مجموع العمال الدائميين في العراق هو ما جعل كربلاء تقف بين المحافظات ذات البطالة المنخفضة نسبيا([13]).
2. غالبا ما تتركز البطالة بالفئة العمرية (15-24) ثم تبدأ بالانخفاض في الفئات العمرية اللاحقة، وبسبب الحجم الذي تشكله هذه الفئة العمرية من إجمالي قوة العمل (حوالي 30%) فإنها تحوز الحصة الأكبر من إجمالي العاطلين عن العمل. ففي عام 2004 بلغ معدل البطالة لهذه الشريحة 43.8 % منها 46% بالنسبة للذكور، و 37.2 % للإناث([14]). انخفضت النسبة إلى 34.89 % عام 2006، منها 36.91% للذكور و 27.37% للإناث. كما يلاحظ تركزها في المناطق الحضرية. في حين إن سلوك مؤشرات البطالة لهذه الفئة العمرية يكاد يطابق سلوك معدلات البطالة العامة. ويعود السبب في ارتفاع البطالة في هذه الشريحة العمرية ارتفاع البطالة بين الإناث بما يفوق مشاركتهن في قوة العمل بنحو ثلاثة أضعاف، في ظل انعدام فرص العمل في القطاع العام الذي كان يشكل الفرصة المثالية للعمل بالنسبة للمرأة.
3. إن الانخفاض الذي شهده معدل البطالة عام 2005 لم يكن نتيجة تبدل أوضاع سوق العمل، بل يعود بالدرجة الأساس إلى تبدل في آلية جمع البيانات الخاصة بالبطالة، واستبدال السؤال الأساس في المسح بما يتناسب مع معايير منظمة العمل الدولية من إن الشخص الذي عمل بأجر ولو ساعة واحدة في الأسبوع السابق للمسح لا يصنف عاطلا.
4. تتركز أزمة البطالة في المناطق الحضرية عنها في الريف، وهو ما يعود جزئيا إلى انخفاض بطالة الإناث في المناطق الريفية والذي سجل معدلات أدنى من 10 % للسنوات (2003-2006) مقارنة بمعدل يزيد عن 22% للسنوات 2003-2005 وعن 37 % لسنة 2006 بين الإناث في المناطق الحضرية. ويعود ذلك إلى شدة تزاحم العاملين في المناطق الحضرية على فرص العمل المتاحة للجنسين في وقت تتزايد أعداد المشاركات في سوق العمل من النساء. وفي الريف حيث تعمل النساء في القطاع الزراعي بأجور متدنية أو يعملن لدى أسرهن بدون أجر فانه يصبح لدى الرجال مجالات أوسع للعمل خارج القطاع الزراعي مما يوفر فرص لهم أكثر بكثير من تلك المتوفرة بالنسبة للحضر.
5. وعلى ما يبدو إن القطاع الزراعي عاجز عن توليد فرص العمالة الكافية للأعداد المتزايدة من سكان الريف، ويؤيد ذلك لجوء العديد من أبناء الريف إلى المدن للعمل في أنشطة خدمية وفي قطاع البناء والتشييد، ولذا تبرز الحاجة لتشجيع الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الزراعية في الريف لضمان توليد فرص عمل جديدة كما ستؤدي المشروعات الصغيرة التي ينبغي توجيهها إلى الريف إلى زيادة فرص توليد الدخل وفرص العمل للعمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضا زراعية .
|
|
|
شكل (2): معدل البطالة بين الإناث حسب البيئة (2003-2006) |
- تفاوت معدلات البطالة حسب الجنس حيث إنها مرتفعة بين الإناث، وهو ما يعود إلى سلوك مؤشرات البطالة وتركزها في الفئة العمرية دون (25) سنة، حيث تزداد كثافة مشاركة المرأة في قوة العمل مع انعدام فرص عملها في القطاع العام.
- تتناسب البطالة عكسيا مع ارتفاع المستوى التعليمي، حيث تتزايد في فئات الحاصلين على تعليم منخفض. فطبقا لنتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية 2007 شكلت نسبة العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الإعدادية فما دون (57.9%) من مجموع العاطلين عن العمل في حين بلغت نسبة العاطلين ممن يحملون شهادة أعلى من الإعدادية (29.1%). وتعكس النسبة العالية للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا (5.4%)، وشهادة البكالوريوس (13.9%) أزمة التعليم العالي في العراق وعدم ملائمته لاحتياجات سوق العمل.
- أما من الحالة العلمية للبطالة في الفئات التعليمية الأعلى من المرحلة الإعدادية فإنها تتركز عموما عند بعض الاختصاصات المهمة كالحاسبات والإدارة والاقتصاد بفروعها واللغات والقانون والسياسة فيما سجلت أدنى معدلاتها في التخصصات الطبية والفنون. وهو ما يعكس هيكل الطلب على هذه الاختصاصات والتزام الدولة بتعيين بعضها. لذا فان أكثر من نصف الأفراد النشطين اقتصاديا والحاصلين على شهادة الإعدادية فأعلى بينما يوظف أقل من خُمس قوة العمل غير المتعلمة. فيما يعمل حوالي نصف غير المتعلمين في الزراعة.
- وعلى الرغم من انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي أي مساهمة السكان في قوة العمل، ومحدودية نشاط المرأة فان حجم البطالة الحقيقي يمكن أن يتزايد مع تزايد معدلات النشاط.
- إن الخطر ليس في البطالة ذاتها، وإنما في البطالة طويلة الأمد، ذلك إن ضيق المجال وقلة الفرص في سوق العمل، وانخفاض معدلات النمو، والاعتماد الشديد على قطاع النفط، تجعل العثور على عمل خلال وقت قصير أمر عسير جدا.
رابعا: آليات توليد البطالة
إن الأسباب الهيكلية للبطالة في العراق تكمن في نمط النمو الاقتصادي المتمحور حول استغلال النفط وفي خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل. حيث يمتاز هذا السوق بالاعتماد شبه التام على القطاع العام في خلق فرص العمل، إضافة إلى نتائج الحروب والحصار وتحديات الأمن والإرهاب([15]).
يرجع تفاقم البطالة في العراق إلى العديد من العوامل أهمها؛ زيادة السكان في ظل سوء التخطيط الاقتصادي وبالتحديد سوء تخطيط القوى البشرية، وضعف مستوى التأهيل لمن هم في سن العمل، وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي، وسوء التخطيط التعليمي وعدم ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوى، هناك مجموعة من الآليات التي تساعد على توليد البطالة ورفع معدلاتها، على مستوى العراق، وهذه العوامل هي:
عدم الاستقرار الأمني
يؤثر الوضع الأمني على الاقتصاد العراقي بطرق عدة فهو يرفع تكاليف الإنتاج ويحول موارد الإعمار إلى نشاطات غير منتجة؛ كما انه يجبر الشركات الأجنبية الموجودة، والمنظمات غير الحكومية، على مغادرة العراق، ويقلل من فرص جلب رؤوس الأموال إلى البلد؛ كما يتسبب انعدام الأمن في أحداث نقص حاد في إنتاج الخدمات العامة وبخاصة الكهرباء والمشتقات النفطية ويؤدي إلى انتشار السوق السوداء، ويؤدي ذلك إلى تدهور شروط العيش وانخفاض القدرة الشرائية للأسر([16]).
لكن رغم جدية المشكلات الأمنية، فان الاقتصاد لم يتعطل كليا من جراء العنف، فقد تمكنت الأعمال التجارية الصغيرة من النمو والازدهار رغم الاضطرابات المحلية. وهو أمر يعود في جزء كبير منه إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست آثارها الايجابية على تحسن دخول موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وتحقيق الاستقرار النقدي فضلا عن النتائج الايجابية للإصلاحات المالية([17]).
هناك رؤى متمايزة حول العلاقة بين البطالة وعدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث يرى البعض أن البطالة هي السبب الرئيس وراء تفاقم الوضع الأمني، حيث قادت سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة القاضية بتسريح منتسبي بعض الوزارات إلى خلق جيش من العاطلين الذي يمد التمرد ضد الحكومة. في مقابل ذلك يذهب آخرون إلى تحميل الوضع الأمني مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة حيث يحاجج بان أعلى المعدلات سجلت في المناطق الساخنة وأدناها في المناطق المستقرة نسبيا. في حين يذهب فريق ثالث إلى القول بان العلاقة بينهما تبادلية ذلك أن ((انعدام الأمن يؤدي إلى انعدام إعادة الإعمار الذي يؤدي إلى انعدام الوظائف وهذا يؤدي من جديد لانعدام الأمن))([18]).
تباطؤ الإعمار
انطلقت حملة الإعمار بطيئة ومتعثرة بعد الغزو وخلال سنة تقريبا (منتصف عام 2003 وحتى منتصف عام 2004) عندما تم الشروع بتنفيذ (200) مشروع لإعادة, وبعد مرور تلك السنة كان هناك أكثر من 2500 مشروع بكلفة (5.7) مليار دولار تحت الانجاز, وتم تنفيذ أكثر من نصفها بكلفة بلغت (1.3) مليار دولار. ومنذ استلام السيادة في حزيران/ يونيو 2004, كان هناك أكثر من 2300 مشروع إنشائي بدأت بتشغيل أكثر من (155.000) عامل عراقي([19]).
إلا إن ذلك لا يعكس انطلاق عملية إعمار حقيقة، لان اغلب المشروعات كانت صغيرة جدا، كالقيام بإصلاح وترميم البنى والمؤسسات، كما أنها لم تقدم فرص عمل مستقرة ودائمة للعمال العراقيين. كما إن غالبية تلك المشروعات تم اختيارها من قبل الدول والجهات المانحة، ولم تؤخذ بنظر الاعتبار أولويات مشروعات إعادة الإعمار. كما إن كثير منها نفذ من دون علم الوزارات المعنية، فضلا عن أن معظم الشركات الأجنبية قد اعتمدت على الشركات الثانوية ، والتي بدورها اعتمدت على مقاولين ثانويين.
في عامي 2006 و 2007 لجأت الحكومة إلى الاعتماد على مواردها لإطلاق حملة اعمار، وقد بادرت إلى توزيع التخصيصات الاستثمارية على الوزارات والهيئات المركزية وعلى مجالس المحافظات وحكومة إقليم كردستان. وخلال عام 2006 فشلت هذه الجهات ما عدا حكومة إقليم كردستان في الوصول إلى نسب انجاز مقنعة للاستثمارات التي خططت لتنفيذها، وقد تدنت نسب الانجاز في بعض المحافظات إلى 10 %. أما عام 2007 فان نسبة الأداء الاستثماري تراوحت ما بين 40- 55 % في ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة، وتتفاوت نسب الانجاز ما بين الوزارات والمحافظات، ففي وقت حققت حكومة كردستان ووزارات الدفاع والصناعة والبلديات نسبة صرف 100 % من إجمالي المبالغ المرصودة لها، فان وزارة النفط لم تحقق سوى 33 % أما الصحة فلم تحقق سوى 43، في حين بلغ المعدل العام الذي حققته المحافظات 74 % من إجمالي المبالغ المرصودة لأغراض الاستثمار. وهنا يجب ملاحظة ان هذه النسب ناتج قسمة المبالغ المودعة إلى المخصصة للاستثمار، وقد تأثرت هذه النسبة ارتفاعا نتيجة سباق الهيئات والمحافظات على الصرف، أما نسب تنفيذ المشروعات والعقود فهي دون هذه النسب بكثير. وقد كشفت دراسة حديثة إن هذا التدني في نسب الأداء عام 2007 إنما يعود إلى مجموعتين كبيرتين من العوامل، منها: التأخر في تهيئة مواقع العمل للمشروعات، وغياب الأمن، وعدم تحديد مدة كافية للمنح والتحليل والإحالة بالنسبة للعقود، وعدم اختيار المقاولين الأكفاء، وعدم كفاءة الإشراف في الوزارة المعنية، وعدم وضوح المواصفات، وتأخر استلام التخصيصات المالية، وتأخر فتح الاعتمادات المصرفية، وغيرها من الأسباب([20]).
إن تباطؤ عملية إعادة الإعمار واستمرار توقف الكثير من منشآت القطاع العام أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة، وقد حاولت بعض مجالس المحافظات استخدام موازناتها الاستثمارية لتنفيذ مشروعات عامة تركزت في الغالب على إصلاح الطرق إلا إنها كانت أيضا خالية من المحتوى الذي يفترض إن تنطوي عليه عملية إعادة الإعمار الذي ينبغي أن يندرج في إطار خطة شاملة وإستراتيجية تتبناها الحكومة بمعونة المجتمع الدولي لإعادة تأهيل البنى والمؤسسات التي طالها التدمير بسبب الحرب وخلق الظروف المناسبة لنمو مستدام. لذا فان التخطيط الاستراتيجي ركن أساسي في عملية الإعمار لأنه يضمن اتساق الأهداف وعدم تعارضها خلال مراحل تنفيذ العملية.
من جهة أخرى إن استخدام بعض مجالس المحافظات لتلك البرامج الاستثمارية لتحقيق هدف القضاء على البطالة أو تقليص معدلاتها قد أبعدها عن أهدافها الاعمارية وحولها إلى سياسة للأشغال العامة في وقت لم تستطع تلك البرامج خلق فرص عمل دائمة ومستقرة للعاطلين عن العمل.
وفي ظل غياب المعلومات والبيانات عن آليات توزيع وتنفيذ عقود تلك المشروعات، فان اتهامات بالفساد تثور هنا وهناك، الأمر الذي يقلص كثيرا من العائد المتحقق من تلك المشروعات.
سياسة الاستيراد غير المنضبط
من بين النتائج التي أفرزها التغيير السياسي في العراق هو الانفتاح الاقتصادي على الخارج الذي يمكن وصفه بالانفلات فخلال السنوات الماضية تم تحرير الأسعار المحلية، وإلغيت جميع القيود النوعية على الاستيرادات ورفعت جميع أنواع الرسوم عليها، وفرضت نسبة واحدة واطئة (5%) على جميع الاستيرادات عدا الغذائية والأدوية.
إن هذا الانفتاح أدى إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المنافسة في الأسواق المحلية، وتكدس البضائع المستوردة وانخفاض أسعارها، وهو ما يمكن عده من المظاهر الايجابية بالنسبة للمستهلك المحلي. لكنه من جهة أخرى، أثر سلباً على المنتِج المحلي في قطاعي الصناعة والزراعة، وأصاب هذين القطاعين في مقتل خاصة وان المنتجين لم يتعودوا العمل في ظروف المنافسة والحرية الاقتصادية وتوقف معونة الدولة وحمايتها لهم ولمنتجاتهم. وقد أدت هذه السياسة إلى تفاقم مشكلة البطالة وتعطيل المزيد من طاقات الإنتاج المادية.
ان ابرز مظاهر الذي أنتجه الانفتاح غير المنضبط هو الاختلال البيِّن بين قطاعات الإنتاج السلعي وقطاعات الخدمات والتوزيع. فقد أصبح القطاع النفطي يؤلف (61 %) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت مساهمة القطاع الصناعي إلى حوالي (2 %) من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع الزراعي فان مساهمته بلغت (6.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات عام 2005 بعد أن كان يساهم بأكثر من ثلث ذلك الناتج قبل ثلاثة عقود. أما قطاع الخدمات فقد شكل حوالي (20 %) من مكونات الناتج المحلي الإجمالي([21]). وتتعمق صورة الاختلال التي أنتجها هذا الانفتاح إذا ما علمنا أن قطاع النفط لا يساهم في تشغيل قوة العمل إلا بنسبة منخفضة لا تتعدى 2 %، في حين إن النسبة المتبقية (98 %) من قوة العمل تركت لقطاعات لا تتعدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 30 % وتهيمن عليها النشاطات الخدمية الهامشية، الأمر الذي يترك تأثيرات سلبية على تكوين وتركيب سوق العمل والقدرة على التوظيف أو الاستخدام المنتج، فترتفع نسبة العمالة الناقصة فيهـا إلى أكثر من 10 % طبقا لتعرف متحفظ([22]).
|
|
|
شكل (3): الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية 2005 |
محدودية النشاط الخاص
أدى تزايد تدخل الدولة منذ منتصف القرن الماضي إلى اضطراب توزيع النشاط الاقتصادي بين القطاعين الخاص والعام. وتعرض القطاع الخاص لضربات عديدة في ظل الأجواء السياسية المضطربة التي تلت انقلاب تموز/ يوليو 1958، وكانت أقسى تلك الضربات عندما اتجهت الحكومة نحو تأميم النشاط الخاص عام 1964. وقد اثر ذلك القرار على طبيعة النشاط الخاص وقضى على الطبقة الرأسمالية الصناعية التي استغرق ظهورها ونموها عقودا طويلة.
ومع تزايد قدرات الدولة المالية بعد تأميم النفط بدأت وزارة التجارة ومنذ منتصف السبعينات تزاحم التجار الذين وجدوا في النشاط التجاري بديلا مناسبا عن النشاطات الصناعية ذات المخاطر العالية حينما تولت تجارة المواد الغذائية والحبوب واحتكرت استيرادها، لذلك تراجع حجم العمل التجاري وبخاصة خلال الثمانينات.
ومنذ مطلع التسعينات أعادت الدولة العراقية اكتشاف السوق تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي عقب غزو الكويت. إن سماح الدولة للقطاع الخاص بالعمل في المجالات التي كانت تحتكرها كان لمجابهة العجز في عرض السلع وضعف إمكانياتها وعدم مرونة حركة شركاتها، لذلك شهد القطاع التجاري انتعاشاً ملموساً، إلا إن تقلبات سعر صرف الدينار العراقي وتصاعد معدلات التضخم، وقلق الحكومة من ظهور طبقة رأسمالية تنافسها النفوذ على الاقتصاد قادت إلى الإطاحة بالناشطين الكبار من التجار فأعدم (42) منهم في أيلول/ سبتمبر 1992.
ومنذ الاحتلال 2003 تزايدت المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص، فأعمال النهب والسلب استهدفت كثيرا من المشروعات الخاصة، كما إن ظروف الانفتاح المنفلت أدى إلى إغراق السوق المحلية بسلع رخيصة جدا يصعب منافستها في ظل قدم طرق ووسائل الإنتاج المعتمدة وتدني مستويات الإنتاجية ونقص المواد الأولية والطاقة. كما أن الوضع الأمني قد ألقى بظلاله على أصحاب الأموال والتجار الذين تعرض الكثير منهم ومن أفراد أسرهم للخطف والقتل والابتزاز الأمر الذي اضطر كثيرا منهم لمغادرة البلد إلى الأردن وسوريا، حيث قدرت رؤوس الأموال التي دخلت الأردن بعد عام 2003 بحوالي ملياري دولار.
|
|
||||
|
شكل (4): مساهمة القطاعين العام والخاص في تكوين رأس المال الثابت |
إن ضآلة مساهمة النشاط الخاص في النشاط الاقتصادي إنما هي نتيجة حتمية لمجموعة الظروف الاستثنائية التي مرت بالبلد، والتي تعرض القطاع الخاص خلالها لقسط وافر من التخريب المعتمد. لذا فلا غرابة أن نجد إن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة لسنة 2005 بلغ (662) منشأة تشغل (2501) عاملا، وهو عدد صغير جدا من المجموع العام إذ يشكل (6.5 %) من مجموع المنشآت في البلد، و (6.8 %) من مجموع العاملين في هذه المنشآت في البلد. من جهة أخرى فان ضخامة حجم القطاع العام وهيمنته على حيز مهم من النشاط الاقتصادي أدى الى ضعف المنافسة والمبادرة في القطاع الخاص، إضافة إلى القصور الكبير في البنية التحتية الداعمة لنشاط القطاع الخاص وبخاصة الكهرباء، وضعف الخطوات المتبعة في إصلاح أسواق المال والمصارف، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وعدم وجود إطار قانوني مناسب لعمل القطاع الخاص، وأخيرا عدم وجود فصل حقيقي للعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية عن منطق المحاصصة. كلها أسباب تقف وراء تعويق عمل القطاع الخاص وازدهاره.
أما عن علاقة ذلك بمستوى البطالة فانه يبدو مناسبا القول إن طلب القطاع الخاص على العمالة هو دالة في نشاط هذا القطاع، إن محدودية النشاط الخاص في ظل محدودية الفرص المتاحة أمامه تقيد فرص نموه، مثلما تقيد نشاطه، فتراجع عرض منتجات القطاع الخاص نتيجة مزاحمة القطاع العام (وبخاصة في مجالي المواد الغذائية والطاقة) أو القطاع الخارجي (وبخاصة في مجال السلع الاستهلاكية والمعمرة) فادى ذلك إلى خفض احتياجاته من العمالة.
وعلى الرغم من إن الاقتصاد العراقي قد حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الأربع الماضية إلا إن مصدر النمو يرجع بالدرجة الأولى إلى: زيادة أسعار النفط تحقق معدل شبه مستقر لتصدير النفط الخام؛ والاستقرار النقدي؛ وازدياد معدلات التبادل التجاري فان ذلك لم ينعكس على واقع النشاط الاقتصادي بل سمح للحكومة بالاستمرار بمزاحمة النشاط الخاص.
إن تطبيق الإصلاحات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي على تبديل أولويات الإنفاق العائلي، بحيث أصبحت العوائل تنفق أكثر من نصف دخلها على الوقود والطاقة بسبب رفع الدعم الحكومي عنها. وهو ما يعني خفض الطلب العائلي على باقي المجموعات السلعية. وحيث إن قطاع الطاقة يكاد يكون شبه مغلقا على الحكومة فانه يمكن توقع الآثار الانكماشية لهذا الإجراء على النشاط الخاص.. أما بالنسبة للمواد الغذائية فان هذه المجموعة السلعية تؤلف ثاني أكبر المجموعات في إنفاق الأسر العراقية، وفي ظل التزام الحكومة بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتقديمها لحوالي (4) مليارات دولار سنويا فان توفير هذه المنتجات بات مرتبطا بنشاطات خاصة طفيلية أو فاسدة أو مرتبطة بالدولة..
وبعيدا عن الجدل الدائر حول مصير البطاقة التموينية، فإنها إضافة إلى الوقود تشكل ميدانا مربحا للنشاط الخاص في ضوء مرونة الطلب على سلعها.
البطالة المقنعة في القطاع العام
إن المفارقة التي أوجدها الاحتلال هو المزيد من الإفراط في نمو أجهزة الدولة وعدد العاملين فيها بمعدلات تفوق معدل النمو الاقتصادي. وهو أمر يجد تفسيره بعاملين أساسين، الأول: هو أن الدولة الجديدة قد ورثت، جهازا متضخما قياسا بالموارد التي يديرها والجماعات التي يُخضعها. وبعد الاحتلال عمدت سلطة الاحتلال والنخب الجديدة إلى المحافظة على اتجاه تضخم أجهزتها لتحقيق جملة من الغايات لعل أقواها امتصاص البطالة العالية واستيعاب أعداد متزايدة من البشر غير المؤهلين وغير المتسلحين بالمهارات الكفيلة بحصولهم على فرص عمل([23]). كما أن القطاع الحكومي يمكن أن يستوعب البطالة في سوق العمل لدمجها في بطالة أخرى مقنعة تخفي تناقضات المجتمع والاقتصاد. وهنا جرى الانتفاع من الشعور المتنامي في المجتمع العراقي بان الأوان قد حان للارتباط بالدولة والاستمتاع بجانب من الحقوق التاريخية المهضومة.
|
|
عدد موظفي الدولة |
|
1960 |
212500 |
|
1965 |
320000 |
|
1972 |
400833 |
|
1975 |
800000 |
|
1987 |
1073704 |
|
1994 |
831523 |
|
1995 |
854093 |
|
1996 |
853044 |
|
1997 |
860733 |
|
1998 |
853307 |
|
1999 |
854278 |
|
2000 |
880756 |
|
2001 |
924397 |
|
2004 |
1.047000 |
|
2005 |
1.14300 |
|
2006 |
1912605 |
|
2007 |
2060260 |
|
2008 |
2389901 |
|
2009 |
2320078 |
|
2010 |
|
|
2011 |
|
إن السنوات الانتقالية قد زادت من تضخم أجهزة الدولة، وزاد الوزن الخاص لبيروقراطية الدولة الجديدة في المجتمع. ولا يمكن لأي متتبع للشأن العراقي أن يغفل عن ملاحظة التضخم البيروقراطي بعد الاحتلال، فقد استمر نمو جهاز إداري مرتبك. وما زالت الوظائف داخل البيروقراطية العامة تزداد في وقت تضغط لزيادة الأجور والرواتب([24]). لقد ارتفع عدد الموظفين العاملين في الدوائر الممولة مركزيا من 1.047 موظفا عام 2004 إلى 1.143 موظفا عام 2005 ثم إلى 1912605 موظفا عام 2006. ليرتفع العدد في عام 2007 إلى 2060260 موظفا بزيادة والى 2389901 موظفا في عام 2008.
ولحل جزء من مشكلات القطاع العام بادرت وزارة الصناعة والمعادن باستحصال موافقة أمانة مجلس الوزراء في نهاية عام 2003 لتحويل بعض المنشآت التابعة لها إلى القطاع الخاص، حيث أعلنت رغبتها في تأجير بعض معاملها إلى القطاع الخاص، وتقوم حالياً على دراسة ملفات (8) شركات عامة من بين (59) شركة تابعة لها لتحويل مصانعها إلى شركات مساهمة خاصة وفق الإطار المحدد بموجب الفصل التاسع من قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997، وذلك لغرض تحويلها للعمل وفق أسس قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997، حيث تنوي الوزارة تقييم أصول وخصوم كل شركة للتوصل إلى القيمة النهائية لرأسمال الشركة وتوزيعها على عدد من الأسهم وتحديد حصة محدده تباع لشريك إستراتيجي وأخرى توزع على منتسبي المعمل أو الشركة ومنتسبي الوزارة وطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام، وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
|
|
|
شكل (5): تطور عدد موظفي الحكومة العراقية (2004-2008) |
لقد قبلت الحكومة بمعدلات عالية من البطالة المقنعة كبديل أقل وطأة من حالة البطالة السافرة، حيث يتيح ذلك حصول الأفراد على مستوى مرضي من الدخل والاندماج في المحيط والقبول بالسياسات العامة. إلا انه ومن وجهة نظر مجتمعية، فان البطالة المقنعة تفرض ضغوطا على حجم الإنتاج الكلي، وهدرا للموارد البشرية وتبديدا للاستثمار البشري الذي تحمله المجتمع قبل زجهم في سوق العمل.
رغم ضخامة الأصول الإنتاجية المملوكة لشركات القطاع العام فإنها تواجه مشكلة تدني قدراتها على الإنتاج، ووجود طاقات عاطلة بسبب تقادم خطوط الإنتاج وتعرضها للتدمير أو النهب فضلا عن تأخير عمليات الصيانة والإحلال. وفي الغالب فان منتجات القطاع العام لا تتماشى مع حاجة السوق المحلي بسبب عدم مرونتها تلك الشركات وضعف قدرتها على التكيف مع أنماط الطلب على منتجاتها.
يعدَّ الدخل العامل الأكثر أهمية لضمان الأمن الغذائي للأسرة والفرد، وإذ يمر العراق بظروف استثنائية فإن فرص نمو الدخل ترتبط بقدرة الحكومة على أداء الدور التوزيعي، لذا تؤدي الموازنة العامة للدولة دوراً مهماً في صياغة اتجاهات تطور دخل الأسر. وقد تضاءلت قدرة الاقتصاد على توفير الوظائف فأصبح القطاع العام رب العمل الأكبر في العراق، وهو الآن يشغل حوالي 2.7 مليون شخص طبقا لبيانات موازنة عام 2012. وبرغم انخفاض معدلات البطالة عام 2011 إلى حوالي 8% فان العمالة الناقصة قد استمرت مرتفعة (17%)([25])، الأمر الذي يؤثر في فرص كسب الدخل. لذا فإنَّ التحدي سيتمثل في دعم النمو المولد لفرص العمل في القطاعات كثيفة العمالة؛ وفي مقدمتها القطاع الزراعي وزيادة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وعليه فإنَّ أمام واضعي خطة التنمية الوطنية تحدياً جدياً يتمثل في إيجاد التوليفة المثلى من السياسات لتعجيل النمو الموفر لفرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر والتي تحقق الأمن الغذائي للأسر وضمان مستويات معيشة مناسبة و تعزيز دور الحكومة التوزيعي بحيث تنحصر التحويلات الاجتماعية للفئات الفقيرة و الهشة.
تخلف النظام التعليمي
وهناك سبب يدور مدار النتيجة، وهو وجود خلل جوهري بين سوق العمل وعملية التنمية من جهة وناتج التعليم من جهة ثانية. ينعكس في ضعف إنتاجية العمالة ووهن العائد الاقتصادي والاجتماعي على التعليم في الاقتصاد. فلا غرابة أن تتفشى البطالة بين المتعلمين، ولا يمارس العاملون منهم أعمالا تقع ضمن اختصاصاتهم وتتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم. ففي الوقت الذي نجد أن ناتج النظام التعليمي لا يستجيب على نحو مناسب لطلب سوق العمل، يعجز هذا النظام على تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية والكافية التي يطلبها أرباب العمل ويتزايد طلب سوق العمل عليها. الأمر الذي يقلل الطلب على المتخرجين الشباب، فترتفع معدلات البطالة بينهم.
إن تدني نوعية التعليم، ومحدودية برامج التدريب والتأهيل تعمل على زيادة الصعوبات بالنسبة للوافدين الجدد للحصول على عمل منتج. فلا غرابة أن ترتفع أعداد المتعلمين الباحثين عن عمل في ظل افتقارهم الخبرة للحصول على أعمال مناسبة. الأمر الذي يشكل تحدا بنيويا للحكومة بالذات، ويفرض عليها زيادة الاهتمام بتحسين نوعية التعليم وتزويد الطلاب بالمزيد من المهارات والمؤهلات الفنية، وبخاصة مهارات تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر المنتج الرئيس للفرص الاقتصادية في عالم اليوم.
تراجعت نوعية التعليم في العراق بشكل مستمر سيما خلال ربع القرن الماضي، مدفوعة بظروف الحروب والحصار. ومع جمود المؤسسات التي تحكم نظام التعليم فانه قد فشل حتى في الحفاظ على مستويات هيئات التدريس ونوعيتها وتدهورت بشكل ملحوظ فتدني الأجور وقلة الاستثمارات في مجال التدريب والاعتماد على معلمين غير مؤهلين ودهور البنية التحتية المادية للمؤسسات التعليمية كلها أثرت سلبا على جودة التعليم في العراق. فشل نظام التعليم في العراق في الاستجابة لاحتياجات الجيلين الأخيرين. وبات قلة من الطلاب هم من تتاح لهم فرص اكتساب المهارات اللازمة لتأمين الحصول على عمل مجزًّ ومتناسب مع مهاراتهم. لذا فان أعدادا متزايدة من الخريجين كانت تدخل في دائرة البطالة والفقر. فلم يتمكن نظام التعليم من إنتاج خريجين مؤهلين للعمل، ولم يفلح في إكساب الطلاب المهارات التي يحتاج إليها القطاعين العام والخاص بالتوافق مع مقتضيات التنمية الاقتصادية. وابتعد كثيرا عن تعزيز القدرات الإبداعية. وتمظهر ذلك الفشل في صورة معدلات عالية للبطالة والعمالة الناقصة، وبخاصة بين الخريجين والداخلين الجدد في سوق العمل، والنقص الواضح في المهارات وهبوط الإنتاجية. وفي ظل معدلات النمو السكاني العالية وزيادة عمالة النساء فان جانب العرض من سوق العمل يميل إلى الزيادة بما يفاقم مشكلة الخريجين الجدد. لذا فان معالجة هذا الواقع تعد أمرا ضروريا في إطار البناء المقصود.
إن أحد الأهداف الرئيسة للتعليم يجب أن يكون تمكين الناس من الوصول إلى عمل لائق. فالعمالة هي الوسيلة التي تترجم من خلالها عملية التعليم إلى نمو وتوزيع منصف لعوائد هذا النمو. وعندما تنقطع الصلة بين التعليم والعمالة تهدر الموارد وتتقلص العوائد على التعليم. يعد التعليم واحدا من أقوى الأسلحة ضد الفقر والبطالة، لذا فان استهداف القضاء على الفقر ينبغي له أن يهتم بتوفير التعليم الجيد القادر على تخفيف وطأة الفقر وتقليص حجم البطالة.
خامسا: الخاتمة: نحو سياسات لمعالجة البطالة
إن أية جهود للقضاء على البطالة ينبغي إن تبنى على أساس تقدير دقيق وواقعي لاتجاهات سوق العمل من حيث العرض والطلب عليه. ورغم إن الإحصاءات المتاحة لا توفر بيانات لسلوك مؤشرات البطالة وأوضاع سوق العمل في المستقبل، إلا انه يمكن الادعاء إن أعداد الداخلين إلى هذا السوق خلال السنوات الثلاث القادمة لن يختلفوا عن اقرأنهم الباحثين عن عمل في الوقت الحاضر، لأنهم نتاج النظام التعليمي نفسه. كما إن اتجاهات التوظيف ستستمر بالمنحى نفسه الذي كانت عليه خلال السنوات الأربع المنصرمة، في وقت سيبقى استثمار القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية على حاله ما لم يتم تحقيق انجازات كبيرة على الصعيد الأمني وإصلاح البنى التحتية وبخاصة الكهرباء.
تندرج جهود الحكومة في وثيقة رسمية هي وثيقة العهد الدولي حيث تعهدت الحكومة العراقية أنها سوف تعمل على تحقيق أهداف التنمية الألفية لغاية عام 2011 بطريقة كفوءة ومستدامة، لذا فإنها ستعمل على تخفيض نسبة البطالة إلى النصف ومضاعفة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة للقطاعات غير الزراعية([26]). لكن من دون أن يتضمن العهد شرحا للآلية التي ستحقق بها الحكومة هذا الهدف.
ينبغي أن تنصب الجهود على معالجة الأسباب البنيوية للبطالة، ومعالجة أسباب نقص فرص العمل أمام القوى العاملة. على أن يجري العمل على تنويع الاقتصاد العراقي ليمتد إلى قطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة. وينبغي أن تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض، وتوليد فرص اقتصادية أفضل في المناطق الريفية الفقيرة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص. كما يجب على الحكومة أن تبادر إلى وضع وتنفيذ إستراتيجية تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل. تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على أن تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
دعم النشاط الخاص
إن إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة في مجال مكافحة البطالة، ليس فقط لان الموارد الحكومية لا تكفي لتأمين حجم الاستثمار الضروري في المستقبل، بل لان هذا القطاع هو من يملك مفاتيح القضاء على البطالة.
إن إعادة تنشيط القطاع الخاص تتطلب: العمل على تسهيل انسيابية وتبسيط الإجراءات الحكومية على صعيد الأعمال في العراق؛ وإجراء إصلاحات على الصعيد التجاري والتنظيمي لتطوير إطار مؤسسي وقانوني شفاف ومبسط لتشجيع أعمال القطاع الخاص؛ ووضع أسس لإعادة تأهيل المنشات المملوكة للدولة تتصف بالتماسك والوضوح والشفافية والشمولية وبما يؤدي إلى تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. كما تتطلب تشجيعه لتنفيذ المشاريع المحلية على المستوى الوطني؛ وإعادة هيكلة المصارف الحكومية لتشجيع عملية الاندماج والخصخصة؛ وتوسيع مجالات الإقراض عن طريق منح القروض الصغيرة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وإكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإحياء الروابط التجارية الإقليمية؛ وإلغاء التقسيم الرقمي وزيادة إمكانية الولوج إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وأخيرا، إعادة تأهيل وتوسيع شبكة النقل الجوي والنقل بالسكك والنظر في إمكانية تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص([27]).
إصلاح النظام التعليمي
إن العمالة هي الآلية التي تترجم التعليم إلى نمو منصف موزع بشكل جيد، وبانقطاع الصلات بين التعليم والعمالة، تهدر موارد هامة وتتضاءل العوائد من التعليم. لذا فارتفاع نسبة البطالة بين الحاصلين على شهادات جامعية يعكس أزمة التعليم العالي في العراق. فنوعية التعليم في تراجع منذ الثمانينيات مع فشل المؤسسات التي تحكم نظام التعليم في تطوير مستويات هيئات التدريس والبنية التحتية المتعلقة بالتعلم والمناهج، أو حتى الحفاظ على المستويات نفسها ومنع تدهورها. والواقع أن حوافز هيئات التدريس ونوعيتها قد تدهورت مع اشتداد سنوات الحصار وما رافقها من موجات من التضخم الجامح وتدني مستويات الأجور الحقيقية وانعدام الاستثمار في مجال التدريب. فمعظم القوى العاملة العراقية كانت تلقت تعليما غير جيد، فباتوا غير قادرين على الاستقلال الفكري، ولم يتمكنوا من مواصلة التعلم إلى ما بعد الحدود التقليدية للتعليم المدرسي. كما أن التعليم في العراق فشل في تقديم مهارات سوق غير أكاديمية (كالتفكير الإبداعي، الابتكار، العمل الجماعي، الثقة بالذات، المبادرة، تحمل المسؤولية، الالتزام بالمواعيد، الأمانة…). لذا فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى طرق غير تقليدية في التدريس تضمن غرس هذه المهارات في مراحل مبكرة من عملية التعلم. إن عدم توفر المهارات الجيدة، يعني استمرار تخلف رأس المال البشري في العراق، الأمر يمكن أن ينعكس على عمليات البناء وإعادة الإعمار من خلال الفشل في اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وزيادة في حدة البطالة والفقر والتوتر الاجتماعي. وينبغي لعملية إصلاح التعليم بجميع مستوياته أن تركز على كلا من التعليم المهني والتقني وبخاصة المستويات المتوسطة منه.
يتوجب على النظام التعليمي استهداف العاطلين عن العمل إضافة إلى الفئات المهمشة الأخرى. ولهذا يجب تنفيذ برامج لإعادة تدريب العمال وإعادة تأهيلهم. ويجب أن تركز هذه البرامج على الفئات المعرضة لخطر الفقر، أي العمال غير المهرة والنساء. فهذه الفئات لا تملك المهارات التي تمكنها من المنافسة في سوق العمل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد تعتمد على التمويل الذاتي لرأس المال، يمكنها أن تشجع الادخار والتراكم الرأسمالي .
ستحدث تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثارًا ايجابيا في خلق فرص جديدة للعمالة، وبخاصة وإنها ستكون موجهة لأصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تمويل التوسع في القائم من المشروعات، أو إنشاء مشروعات جديدة. ويمكن توليد فرص العمل من خلال جعل أساليب العمالة الكثيفة من بين معايير اختيار المشروعات التي يجري تمويلها.
ثم بادر مجلس الوزراء إلى تبني برنامج القروض الصغيرة التي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفوائد منخفضة ومدة سماح جيدة يمكن أن يشكل داعما لخلق مشروعات صغيرة، إلا إن عيوب أساسية في هذا المشروع ترتبط بحجم القروض وشفافية عمل البرنامج، والاهم من وجهة النظر الاقتصادية أنه لا يضمن توجيه المشروعات بحيث تؤسس مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة الحجم بما يلبي احتياجات الاقتصاد في المناطق المختلفة. إذ يتعين على الجهة المشرفة على المشروع أن تتولى إعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن أن تمول.
وينبغي استخدام الدعم على شكل قروض ومساعدات فنية لتشجيع تأسيس أعمال جديدة ونمو الاستثمارات الناشئة، وبهذا الصدد، فإن من الضروري الاهتمام بشكل كاف بدور النساء في استثمارات كهذه([28]). ذلك أن الصناعات الصغيرة تتميز بخصائص أكثر ملائمة لمتطلبات معالجة البطالة، فإلى جانب انخفاض التكلفة فإنها توفر فرص العمل نتيجة استخدامها تكنولوجيا سهلة تتصف بأنها ذات تكلفة أقل واحتياجها للتدريب محدود، بحيث يمكن استيعابها بسهولة خلال مدة قصيرة؛ كما إنها تعتمد في الغالب على مواد أولية محلية.
إصلاح شركات القطاع العام
بادرت الحكومة الانتقالية منتصف عام 2004 إلى تشكيل هيئة لدراسة الخصخصة، وقد قامت اللجنة بالإعداد لقاعدة البيانات عن شركات القطاع العام، كما أعدت مشروع قانون لهيئة الخصخصة، إلا إن قراراً صدر في نيسان/ ابريل 2005 ألغى الهيئة دون ذكر أسباب هذا الإجراء. إلا إن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 آب/ أغسطس 2005 أعاد دراسة الموضوع وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الإنمائي عضوية وزير المالية والصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، لدراسة السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل لشركات القطاع العام حيث قدمت اللجنة (9) توصيات تتضمن أهمها ما يلي([29]):
1- تشكيل وكالة إعادة تأهيل الشركات العامة التي توكل إليها مهمة إعادة تأهيل الشركات بالنيابة عن جميع الوزارات القطاعية، حيث تتولى الوكالة إعداد وتنفيذ هذه المهمة بموجب برنامج وطني ويشرف على تنفيذه مجلس إدارة.
2- قيام الوكالة بتعويض العمال غير الأكفاء مقابل خدماتهم في الشركات الحكومية واستقالتهم وتشجيعهم لاستثمار هذه التعويضات في مشاريع صغيرة. وقد أوصت اللجنة بوضع ميزانية للتأهيل الاقتصادي لعام 2006 حيث يمكن لعمال يتراوح عددهم 50-70 ألف عامل الاستفادة من التخصيص المذكور.
3- تشريع قانون لتأهيل الشركات الحكومية يتم بموجبه تحويل ملكية الشركات الحكومية من الوزارات القطاعية المعنية إلى وكالة تأهيل الشركات الحكومية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهام الموكلة لها بما في ذلك بيع أسهم الشركات وحماية حامليها، وان تتم جميع أعمال وبرامج الوكالة بشفافية ومهنية وبما يحقق النفع العام.
4- يضم مجلس إدارة الوكالة ممثلين عن الوزارات القطاعية المعنية بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التخطيط وأخرى عن ديوان الرقابة المالية، وتكون مدة عمل الوكالة محدودة (3-6) سنوات.
إن جوهر إصلاح شركات القطاع العام الذي نطمح إلى تحقيقه في هذا الإطار هو تجنب الخصخصة في الوقت الحاضر، وإنما ينبغي أن يتجه الإصلاح إلى خلق أنشطة جديدة تساعد على امتصاص فائض العمالة بالتزامن مع رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه الشركات، خاصة وأن معظمها يفتقر إلى أنشطة التسويق الموجهة للسوق المحلية أو الأجنبية، ووحدات مراقبة الجودة التي تضمن توفق منتجاها مع أنماط الطلب عليها.
التركيز على التكنولوجيا والإنتاجية في المنشآت عن طريق اختيار التكنولوجيا المناسبة للإنتاج، وأشكال تنظيم العمل والإدارة السليمة لتعزيز احتمالات نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل إضافية.
وعلى صعيد آخر، ينبغي للإصلاحات أن تتجه نحو تطوير الإدارة والتنظيم داخل تلك الشركات عن طرق التوسع في أتمتتها وإخضاع منتسبيها لبرامج تدريب مكثفة على أساليب الإدارة الحديثة وسبل رفع كفاءة الوحدات التي يديرونها.
كما ينبغي العمل على رفع مستوى مهارات العاملين عن طريق إعداد برامج تدريبية متنوعة داخل وخارج الشركات التي يعملون فيها، على ان تصمم تلك البرامج لتلبية الاحتياجات الفعلية لشركات القطاع العام.
زيادة فرص التشغيل في القطاع الزراعي
ينبغي أن تركز جهود معالجة البطالة على زيادة فرص التشغيل في القطاع الزراعي، وتوسيع إنتاجه بشكل ملموس، وبخاصة وان الكثير من الأراضي المهملة أو المستغلة بشكل جزئي هي أراض ذات مردود مرتفع، كما إن التوسع في الإنتاج الزراعي مرحب به في ظل أوضاع الأسواق الزراعية. ومع صعوبة إعادة الاعتبار لهذا القطاع بعد سنوات الإهمال، لذا فهو اليم بحاجة إلى محفزات باهظة. لذا ينبغي العمل على:
· تشجيع الزراعات المدرة للدخل، وبخاصة الفواكه والخضر.
· تطوير البنى التحتية لهذا القطاع .
· تطوير شبكة الطرق الزراعية.
· استحداث فرص عمل جديدة مرتبطة بالقطاع الزراعي.
· العمل على ربط الزراعة بالصناعة وتشجيع الصناعات الزراعية لتصنيع المنتجات الزراعية المحلية وبخاصة التمور.
زيادة فرص التشغيل في قطاع السياحة
مما لا شك فيه إن قطاع السياحة يوفر فرصا واعدة للتوظيف، وبخاصة في ظل تحقيق حالة الاستقرار الأمني، فالمكانة الدينية والتاريخية لعدد من محافظة العراق تجعلها محط أنظار السائحين. وقد عانى هذا القطاع من صعوبات جمة نتيجة حساسيته للوضع الأمني في البلد وتأثر المحافظة الكبير بهذا الوضع. إلا إن النهوض بهذا القطاع يتطلب:
· الاستثمار في المرافق السياحية، وبخاصة خارج مراكز المحافظات الدينية لتوسيع النشاط السياحي.
· إيجاد جهة أو هيئة لتنسيق جهود القطاع الخاص السياحي تتمكن من فرض رقابة على جودة الخدمات السياحية واعتدال أسعارها.
· زيادة الاهتمام بالصناعات الحرفية.
· إنشاء معاهد خاص بالتدريب السياحي.
إحلال مفردات البطاقة التموينية
ينبغي أن تتجه الحكومة إلى إحلال مفردات البطاقة التموينية المستوردة بمنتجات محلية، حتى وان كانت تقوم على التعبئة والتغليف. فضلا عن أن كثير من مفردات البطاقة يمكن إنتاجها محليا، وبخاصة الدهون ومساحيق الغسيل والصابون وتوفير نسبة من الحبوب والبقوليات من الإنتاج المحلي.
تسريع النمو في قطاع البناء والتشييد
يعتبر هذا القطاع من القطاعات القليلة الناشطة في الاقتصاد العراقي، فقد استمرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تزداد منذ منتصف القرن الماضي، وقد وصلت تلك الزيادة ذروتها عام 1985 عندما ساهم بحوالي 8.5 من الناتج المحلي الإجمالي، إلا إن هذه المساهمة تدهورت في ظل العقوبات الاقتصادية وبعد الحرب الأخيرة وصلت إلى 0.72 عام 2003، ارتفعت إلى 0.97 عام 2004 إلى حوالي نصف مساهمته في الناتج مطلع الخمسينات! من جهة ثانية يشغل هذا القطاع نسبة كبيرة من القوة العاملة وصلت ذروتها عام 1990 حينما ساهم بتشغيل أكثر من 10 % من القوة العاملة. في حين بلغت مساهمته عام 2001 حوالي 1.17 % من مجموع القوة العاملة. من جهة ثالثة فان النشاط الخاص يكاد يهيمن بصورة مطلقة على نشاط هذا القطاع.
تقع أهمية تسريع النمو في قطاع البناء والتشييد في قلب سياسة معالجة البطالة، لان التركيز على هذا القطاع يحقق جملة من الأهداف إلى جانب توفير السكن للكثير من الأسر، بل لان هذا القطاع ينشط عددا كبيرا من الفروع الصناعية والخدمية المزودة لهذا القطاع بالمدخلات، الأمر الذي يزيد من فرص العمل ليس في هذا القطاع وحده وإنما في الفروع الأخرى.
وفي السنوات الأخيرة شهد قطاع البناء والتشييد نموا كبيرا نتيجة حركة الاعمار التي نشطت وبخاصة في ظل التحسن النسبي في الوضع الأمني وانخفاض أسعار مواد البناء جراء الأزمة العالمية، فضلا عن تحسن دخول الأفراد.
جدول (4)
ملخص الإجراءات الحكومية لمعالجة البطالة
|
السياسة |
الإجراءات الحكومية |
|
سياسات الاقتصاد الكلي |
* تضمين خفض البطالة في السياسات الاقتصادية الكلية. * تحفيز النمو الاقتصادي. |
|
السياسات القطاعية |
* زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني. * إعادة تأهيل البنى لتحتية واستكمالها بهدف العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وفرص العمل للقطاعات كافة. * دعم قدرات القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من العمالة . * إعادة تأهيل المشروعات الصناعية المعطلة. * ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. * دعم برامج التدريب والتأهيل المتطورة. * زيادة جودة التعليم، والتوسع في التعليم المهني. * زيادة كفاءة سوق العمل من خلال زيادة المنافسة فيه في ظل رعاية الدولة ورقابتها القانونية. |
|
سياسة الاستثمار |
* أن تتجه سياسة الاستثمار إلى تهيئة البيئة الملائمة لخلق فرص العمل. * ربط حوافز الاستثمار بقيام المشروعات الجديدة بتوفير فرص عمل دائمة. * زيادة الاستثمار في البنى التحتية الداعمة لعملية الإنتاج. |
|
دعم النشاط الخاص |
* تسهيل انسيابية وتبسيط الإجراءات الحكومية على صعيد الأعمال. * إجراء إصلاحات على الصعيد التجاري . * وضع أسس لإعادة تأهيل المنشات المملوكة للدولة تتصف بالتماسك والوضوح والشفافية والشمولية. * تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المحلية على المستوى الوطني. * إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتشجيع عملية الاندماج والخصخصة. * دعم المصارف الخاصة. * تطوير سوق رأس المال. * توسيع مجالات الإقراض * إحياء الروابط التجارية الإقليمية والدولية. |
|
زيادة فرص التشغيل في القطاع الزراعي |
* تشجيع الزراعات المدرة للدخل، وبخاصة الفواكه والخضر. * تطوير البنى التحتية لهذا القطاع . * تطوير شبكة الطرق الزراعية. * استحداث فرص عمل جديدة مرتبطة بالقطاع الزراعي. * العمل على ربط الزراعة بالصناعة وتشجيع الصناعات الزراعية لتصنيع المنتجات الزراعية المحلية وبخاصة التمور. |
|
زيادة فرص التشغيل في قطاع السياحة |
* الاستثمار في المرافق السياحية، وبخاصة خارج مراكز المحافظات الدينية لتوسيع النشاط السياحي. * إيجاد جهة أو هيئة لتنسيق جهود القطاع الخاص السياحي تتمكن من فرض رقابة على جودة الخدمات السياحية واعتدال أسعارها. * زيادة الاهتمام بالصناعات الحرفية. * إنشاء معاهد خاص بالتدريب السياحي.
|
الهوامش والمراجع
([2]) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، ص 33
([3]) الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2008، ص 115
([4]) فائق عبد الرسول، التحديات التي تواجه العراق مرحلياً (الإطار العام للأوضاع التنموية في العراق)، ورقة خلفية مقدمة إلى مشروع دراسة خارطة الحاجات الأساسية غير المشبعة في العراق.
([5]) اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا –الاسكوا، تقويم إحصاءات النوع الاجتماعي في العراق، الاسكوا، نيويورك، 2009 (دراسة غير منشورة)
([6]) Pal Sletten and Lauay H. Rashid, Comparison of Iraqi Labour Force Statistics, FAFO- Paper 2005:12, p10. Available at: (http://www.fafo.no/pub/rapp/776/776.pdf)
([7]) السؤال 8، في استمارة مسح التشغيل والبطالة لسنة 2003. (غير منشورة)؛ السؤال 7، في استمارة مسح التشغيل والبطالة (المرحلة الثانية) النصف الأول عام 2004 (غير منشورة). وجدير بالذكر السؤال نفسه ورد في استمارة التعداد السكاني لعام 1997(غير منشورة).
([8]) السؤال 9، في استمارة مسح التشغيل والبطالة لعام 2006
انظر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، المصدر السابق، الملحق (3)
([10]) اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا –الاسكوا، تقويم إحصاءات النوع الاجتماعي في العراق، الاسكوا، نيويورك، 2009
([12]) انظر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، تموز/ 2007
([14]) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، نتائج مسح التشغيل والبطالة 2004، ص 10
([15]) انظر: حسن لطيف كاظم الزبيدي، الفقر في العراق: مقاربة من منظور التنمية البشرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية (بيروت: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية)، السنة (18)، العدد (38)، ربيع 2007، ص 104
([16]) فريق أبحاث، ديناميكيات النزاع في العراق: تقييم استراتيجي، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد- اربيل- بيروت، 2007، ص36-37
([18] ) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (الشرق الأوسط)، إعادة أعمار العراق، التقرير رقم 30 للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (الشرق الأوسط)، عمان/بغداد/بروكسل، ص16
([19])الهيئة الستراتيجية لإعادة الإعمار، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، إستراتيجية التنمية الوطنية 2005-2007، ص 3
([20]) كمال البصري، مشكلة ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الحكومية عام 2007، ندوة المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي، بغداد 23 شباط/ فبراير 2008.
([21]) النسب محتسبة من: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية (2005-2006)، جدول رقم (5/14)
([22]) طبقا لمنظمة العمل الدولية فان العمالة الناقص تعرف بأولئك الذين يعملون ولكن يرغبون في الحصول على مزيد من العمل أو نوع آخر من العمل، ويكون معدل ساعات عملهم أقل من 23 ساعة أسبوعيا ويرغب في القيام بالمزيد من العمل.
انظر: الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مسح التشغيل والبطالة في العراق لسنة 2006، تموز/ 2007، ص21
[25] مسح شبكة معرفة العراق 2011، جدول (4-31)، ص 145




