حال التنمية البشرية في العراق: سجل التدهور
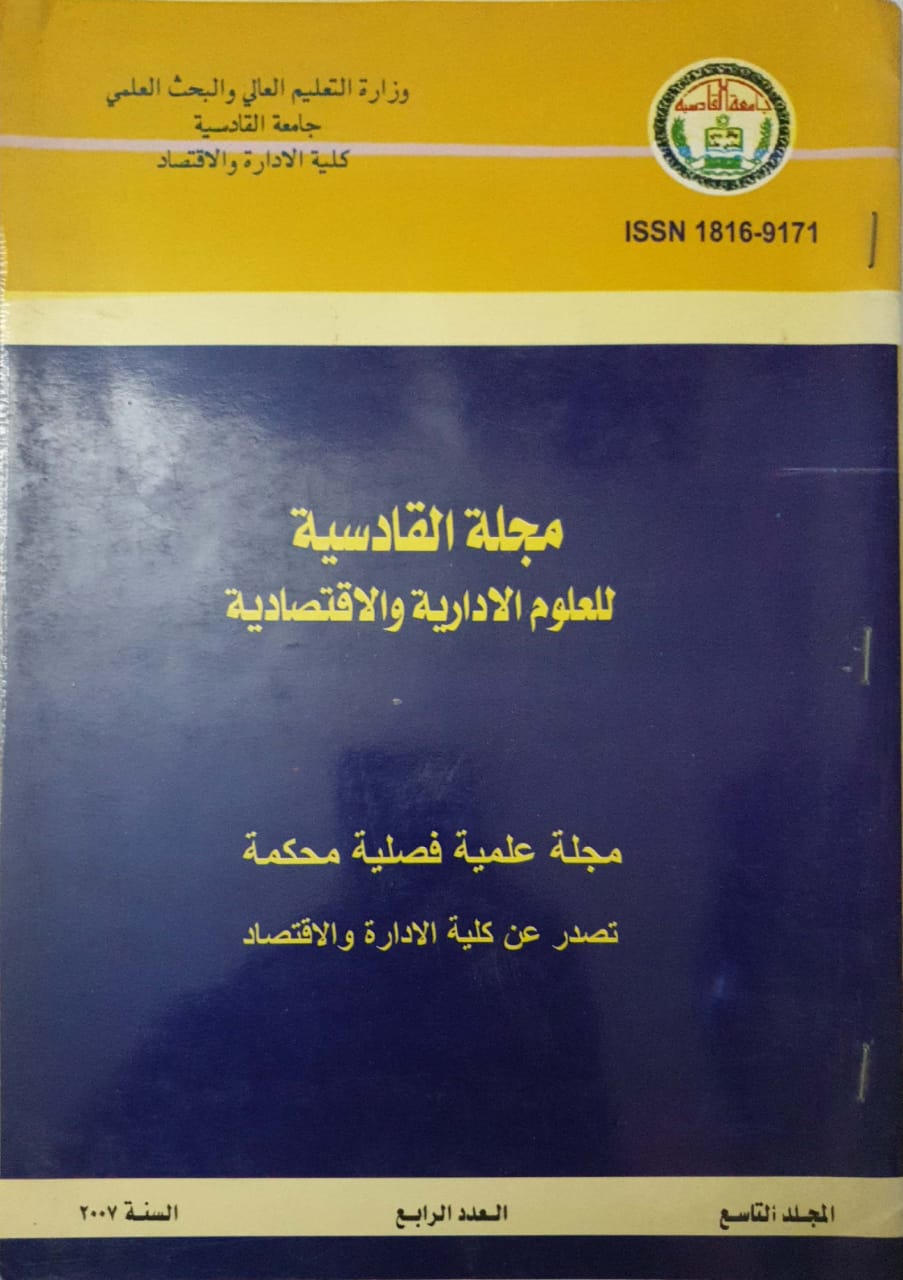
حال التنمية البشرية في العراق: سجل التدهور
|
الدكتور حسن لطيف كاظم الزبيدي مدرس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة الكوفة |
الدكتور عاطف لافي مرزوك السعدون معاون العميد للشؤون العلمية كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة الكوفة |
2007
المقدمة
تعد التنمية عملية مركبة فهي محصلة لتفاعل العناصر المرتبطة بحركة المجتمع، والتي تحدث تغيرات كمية ونوعية على حياة الناس في حقبة زمنية معينة. وقد توسع مفهوم التنمية من مجرد التركيز على النمو الاقتصادي، ليصبح جزءً من عملية التنمية المستمرة والمستدامة. عليه فالتنمية البشرية عبارة عن صيرورة تؤدي إلى توسيع الخيارات أمام الناس، عبر وضع البشر في صميم عملية التنمية وجعلهم هدفها وموضوعها، مثلما تدعو إلى حماية الخيارات الإنسانية لأجيال المستقبل والأجيال الحاضرة وتشمل هذه الخيارات الحياة الطويلة والصحية واكتساب المعرفة والتمكن من الموارد الضرورية للتمتع بمستوى عيش مناسب، يضاف إلى ذلك الحرية السياسية والتمتع بحقوق الإنسان واحترام الذات. وبهذا فمفهوم التنمية البشرية يجمع بين القدرة وتنميتها واستعمالها، ويتجاوز المفاهيم التقليدية كرأس المال البشري وإشباع الحاجات الأساسية، والموارد البشرية..الخ. وينبه مؤشر التنمية البشرية HID إلى المقارنة بين رأس المال والبشر، وبين الثروة الوطنية وعائدها التنموي.
تبرز أهمية البحث كونه يعالج واحدة من المفاهيم المهمة التي باتت مقولاتها رائجة في الفكر المعاصر، ويسعى البحث إلى توسيع دائرة النقاش حول أوضاع التنمية البشرية في العراق الذي عانى خلال العقدين الماضيين تدهورا في مجمل مؤشرات التنمية الأمر الذي انعكس سلبا على حال التنمية في البلد وتفاقم أوضاع الناس فيه.
لذا فان المشكلة التي يعالجها البحث هي أن أوضاع التنمية البشرية متدهورة إلى الحد الذي تعجز مؤشرات التنمية البشرية عن فضحها بصورة دقيقة، فالتبدلات السلبية في أحوال المجتمع والاقتصاد والسياسة أنتجت تشوهات في بنية التنمية البشرية يستلزم إصلاحها توافر الإرادة السياسية والمجتمعية التي تعمل على حشد الطاقات والجهود باتجاه تحسين الأوضاع الإنسانية.
وينطلق البحث من فرضية مؤداها: أن سنوات الحروب والحصار الاقتصادي والظروف غير الاستثنائية التي يمر بها البلد أدت إلى تدهور أوضاع التنمية البشرية كما تقيسها مؤشرات وأدلة التنمية البشرية.
إن الوصول إلى هدف البحث واثبات فرضية تفرض على الباحثين استخدام مجموعة واسعة من البيانات التي اجتهد الباحثان في تبويبها وجدولتها حتى تكون تعبيرا مختصرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لذا فان البحث جاء غنيا معززا بمؤشرات التنمية ومقاييسها بغية تقديم بيان إحصائي وتحليل واقعي لأوضاع التنمية البشرية في العراق.
خلفية تاريخية
مما لا شك فيه إن العراق ومنذ الثاني من أب 1990 وحتى 20 أيار/ مايو 2003 واجه ظروفا اقتصادية وسياسية قاسية وغير مسبوقة. فقد تفاقمت في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي مشكلات الاقتصاد العراقي. ومع وقف تصدير النفط العراقي أصبحت الدولة مواجهة بجدول أعمال كبير بدايته إعادة إعمار ما خربته الحرب وآخره إنجاز وعد التنمية وان كان مجمل الخطاب الاقتصادي للدولة يقوم على مواجهة التآمر المزعوم على استقلال ووحدة العراق. وكل ذلك كان في ظل اختفاء موارده من النفط استمر حتى عام 1996 الذي شهد توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء. وإجمالا يمكن القول بأن الوضع المالي لم يكن ملائما للقائمين بالسياسة الاقتصادية حتى ذلك الحين، فمع تعطل القطاع الخارجي وانكسار دورة النقد الأجنبي في الاقتصاد هبطت الإيرادات النفطية التي كانت تشكل نسبة كبيرة تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال المدة (1970–1989)، وبسبب حرب الخليج الثانية والحصار لم يستطع البلد خدمة ديونه فتراكمت متأخرات السداد حتى أصبحت الديون الخارجية 126 مليارا في نهاية عام 1998([1]). ولهذا كان لا بد من اللجوء إلى السلطات النقدية للاقتراض، ففرضت مشكلة التضخم نفسها الأولى في قائمة مشاكل الاقتصاد المزمنة. إذ تؤشر معدلات نمو المخفض الضمني خلال سنوات الحصار موجة من التضخم تخرج عن حدود السيطرة.
وعلى الرغم من أن معظم الاخفاقات التي واجهها الاقتصاد العراقي قد نتجت عن أوضاع الحصار الاقتصادي خلال عقد التسعينات، إلا إن جزءً منها نتج عن فشل برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق المعدلات المستهدفة من النمو، وتنوع الهيكل التصديري خلال عقد السبعينيات والثمانينيات، بسبب جنوح التوزيع النسبي للإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي نحو متطلبات الحرب في عقد الثمانينيات، مما ترتب عليه أن يتسم الاقتصاد العراقي آنذاك بحساسية عالية تجاه الصدمات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتأتية من التغيرات السعرية للسلع في السوق الخارجية، والتقلبات في أسعار النفط خلال العقد المذكور([2]).
إن حال التنمية البشرية في العراق مدعاة للقلق الشديد، فالبيانات المتاحة برغم قلتها وقصورها تدلل على تدهور أوضاع التنمية واتساع نطاق الفقر رغم ما توافر له من إمكانات مادية وبشرية طوال العقود الماضية، ورغم ما تختزنه أراضيه من ثروات وضعت بلدانا أخرى في مقدم الركب التنموي. ولعل هذه النتيجة أمر متوقع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بالعراق فقد عرف نصف القرن الماضي من تاريخه أحداثا جسام كانت كوارث حلت بالتنمية البشرية وأوقفت خطاها، بل دمرت مكتسبات كانت قد تحققت في أوقات ماضية.
وتكشف مراجعة مؤشرات التنمية البشرية في العراق عن تدهور كمي ونوعي فيها. نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة الحروب الداخلية والخارجية وسنوات الحصار الطويلة، فتأثير تلك الظروف أعمق من أن تقيسه مؤشرات وأرقام تتسم بقدر عال من التجريد والعمومية. كما أن هذه الظروف سترافق آثارها وانعكاساتها السلبية مسيرة التنمية القادمة والمستوى الذي يمكن إن تصل إليه التنمية البشرية. أن ذلك يعني أن البيانات لا تعكس حقيقة وحجم التراجع الذي حصل في بنية التنمية البشرية وجوهرها. مثلما تفشل في إعطاء صورة التراجع في البنى المؤسسية الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع. لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ الاحتلال الأمريكي للعراق (نيسان/ ابريل 2003)، وقد كان الاحتلال قد أحدث صدمة هائلة تبعها انقلاب واضح في النظم والمؤسسات والقيم, مع ذلك لا يمكن عد حالة التنمية البشرية اليوم نتاج آلي لتلك اللحظة من تاريخ العراق، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإنجاز والفشل، البناء والتدمير، ومن السلم والحرب…
إن الهدف الأساس من البحث هو رسم صورة لأوضاع التنمية البشرية في العراق وما انتهت إليه سنوات الحروب والحصار والتدمير من أوضاع مأساوية جعلت الإنسان العراقي بين أكثر البشر معاناة على وجه الأرض رغم أن الأرض من تحت قدميه تختزن ثاني أكبر ثروة نفطية في العالم.
تدهور دليل التنمية البشرية
أن مفهوم التنمية البشرية أوسع من أي مقياس يمكن أن يقاس به ويصعب أيجاد مقياس شامل له، لأن هناك العديد من الأبعاد الحيوية للتنمية البشرية لا يمكن حصرها مثل المشاركة. فاختيارات البشر لا تحدها نهاية، وتتبدل مع الزمن، مع ذلك فان هناك ثلاث اختيارات أساسية تسمح للأفراد بحياة مديدة وصحية، يكتسبون خلالها المعارف، ويحصلون فيها على موارد تسمح لهم بمستوى معاشي لائق. ويقيس مؤشر التنمية البشرية هذه الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية. لكن يبقى مفهوم التنمية البشرية أعم وأشمل من أن تحتويه مقاييسها ومؤشراتها. مع ذلك فان ابرز الإسهامات التي سـاهمت بها تقارير التنمية البشرية في مجالها التنموي هو دليل التنمية البشرية (HDI) الذي يستخدم لقياس الإنجازات التنموية الخاصة بالقدرات البشرية ويحوي في طياته إمكانات واسعة للتطوير قد يجعله الأفضل حالياً([3]). ويتضمن الدليل ثلاثة مكونات رئيسية هي: (1) البعد الصحي ممثلا بالعمر المتوقع عند الولادة؛ (2) البعد التعليمي ويقاس بنسبة القراءة والكتابة لقياس؛ (3) مستويات المعيشة أو التحكم بالموارد بالصورة التي يجعل التمتع فيها بحياة كريمة لقياس بعد الدخل. وقد أجريت بعض التعديلات في استخدام هذه المؤشرات.
وطبقا لتقرير التنمية البشرية في العراق لعام 1994 فان محصلة العقوبات الدولية على التنمية البشرية أفضت إلى تراجع النمو الاقتصادي لما يقرب من أربعة أعوام لكل عام من أعوام تنفيذ العقوبات([4])، وهو ما يعني تراجعا في التنمية الاقتصادية بحوالي نصف قرن.
يشير الجدول رقم (1) إلى إن العراق قد حقق تحسنا بنسبة 0.235 في مؤشر التنمية البشرية الخاص به بين عامي 1960 و1998، حيث زاد هذا المؤشر من 0.348 إلى 0.58 وهي زيادة تقل عن نصف ما حققته البلدان العربية الخليجية المجاورة للعراق. وعلى الرغم من إن جميع بلدان العالم قد حققت تحسنا ملموسا في هذا المؤشر إلا إن أداء العراق كان من بين الاداءات المتواضعة قياسا لما يتمتع به من إمكانات، ومرد ذلك هو طبيعة الظروف القاسية التي مر بها العراق خلال سنوات الحرب والحصار. وقد يكون الجزء الأكبر في هذا التدهور يعود إلى التراجع الكبير في متوسط نصيب الفرد بتعادل القوة الشرائية بسبب تدهور قيمة الدينار العراقي وانخفاض إيرادات الدولة مع توقف صادرات العراق النفطية.
وطبقا لمقياس التنمية الإنسانية العربية الذي يقوم على توسيع مقاييس التنمية البشرية والمفاهيم الداخلة فيه فإن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العربية تعاني من نواقص ثلاثة تفت من عضد التنمية الإنسانية في الأقطار العربية هي: نقص الحرية، نقص تمكين المرأة، ونقص القدرات الإنسانية قياسا إلى الدخل خاصة القدرة المعرفية([5]). وتأسيسا على هذا المقياس نجد إن ترتيب العراق في دليل التنمية البشرية المقدم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تراجع من 80 إلى 110 أي انه تراجع ثلاثين مرتبة ولا تتفوق عليه في ذلك إلا سوريا التي تراجعت 33 مرتبة([6]).
|
الشكل(1) دليل التنمية البشرية في العراق |
|
|
|
الشكل من إعداد الباحثين بالاستناد United Nations Development Program [UNDP] ,Human Development Report, several reports. |
الجدول (1)
تطور دليل التنمية البشرية في العراق
|
السنوات |
قيمة دليل التنمية البشرية |
العمر المتوقع عند الولادة |
معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين |
نسبة القيد الإجمالية في التعليم الأولي والثانوي والعالمي معا |
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية |
دليل العمر المتوقع |
دليل التعليم |
دليل الناتج المحلي الإجمالي |
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية |
|
1960 |
0.348 |
48.5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1970 |
0.489 |
55 |
30 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1980 |
0.581 |
— |
— |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1985 |
0.661 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1990 |
0.589 |
65 |
89 |
— |
— |
0.37 |
0.13 |
0.23 |
76 |
|
1992 |
0.614 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
100 |
|
1993 |
0.599 |
66.1 |
55.7 |
55 |
3413 |
0.68 |
0.55 |
0.56 |
109 |
|
1995 |
0.538 |
58.5 |
58 |
52 |
3170 |
0.560 |
0.560 |
0.490 |
127 |
|
1997 |
0.586 |
62.4 |
58 |
51 |
3197 |
0.62 |
0.56 |
0.58 |
125 |
|
1998 |
0.583 |
63.8 |
53.7 |
50 |
3197 |
0.65 |
0.520 |
0.850 |
126 |
|
2007 |
0.623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
United Nations Development Program [UNDP],Human Development Report, several reports.
بالرغم من إن الكثير من المهتمين بشؤون التنمية البشرية يشيرون إلى غلبة التحليل المقارن على هذا المؤشر كونه يعكس وبشكل أساس موقع العراق بين أقرانه من البلدان النامية، إلا أنه يقصر في كشف التفاوت داخل البلد. والمفارقة التي نسجلها هنا هو العجز الواضح عن سد الفجوة بين النمو الاقتصادي والإنساني رغم ما أتيح للعراق من موارد ضخمة انعكست في اطراد نمو الناتج المحلي للفرد في خلال الستينات والسبعينات، ورغم تدنيه في الثمانينات وانخفاضه في مطلع التسعينات إلى مستويات ما كانت في الستينات، رغم أن سكان العراق قد تضاعف مرتين عما كان عليه عام 1960.
أما خلال التسعينات فقد تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 15.9 مليار دينار عراقي عام 1988 إلى 3.5 مليار دينار عام 1994 (بأسعار عام 1980). وترتب على ذلك تقلبات واسعة في متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي، فقد بلغ نحو 564 دولار في مطلع عقد التسعينات، وأقصاه نحو 1586 دولار في مطلع الثمانينات، ثم أخذ بالتراجع إلى نحو 161 دولار في منتصف عقد التسعينات([7]). وكانت مستويات معيشة الأفراد والأسر هي الأكثر تضررا بشكل عام، وخصوصا الأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط. وطبقا لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية لعام 1995 فقد انخفضت مستويات الدخول والمعيشة لثلثي سكان العراق، وأصبح دخل الأسرة يقارب ثلث دخلها مقارنة لعام 1988([8]). ورغم ذلك استمر الإنفاق العسكري يحتل الأولوية على الرغم من توقف الصادرات النفطية الرسمية، وأصبح العبء المالي والاجتماعي الذي يمثله الجيش خطرا لا يستهان به. والذي أضيف إليه جيش آخر أكثر عدة واستنزافا للموارد، هو الحرس الجمهوري الخاص، فضلا عن القوات غير الرسمية مثل جيش القدس، وما تطلبته إدامتها من مبالغ ومصاريف، وما كانت تتركه الخدمة فيها من آثار على العمل في أجهزة الدولة الأخرى والمؤسسات الخدمية (وحتى القطاع الخاص)، حتى صارت هذه المؤسسات والتشكيلات الملحقة بها تمثل عبئاً على الاقتصاد والمجتمع العراقيين([9]).
ويظهر مؤشر النوع الاجتماعي بوضوح الفجوة في مؤشر التعليم بين الإناث والذكور، وما يتعلق بالتمكين السياسي والمشاركة الاقتصادية. وهو ما يتطلب وضع السياسات الكفيلة بتضييق هذه الفجوة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بعد أن تحسن موقع المرأة في مجال التربية والتعليم في عقد السبعينات تراجع بشكل مثير خلال العشرين سنة الماضية حيث إن 47 في المائة من النساء في العراق يعيشون حالة الأمية الكلية أو الجزئية. وطبقا لمسح أحوال المعيشة فان الفجوة حسب الجنس هي الأعلى في إقليم الشمال حيث تقل نسبة التعليم للنساء بـ 20 في المائة عن الرجال، كما انه يوجد اختلاف إقليمي واضح في تعليم النساء. ففي السليمانية ودهوك والمثنى هناك أكثر من 60 في المائة من النساء بعمر 15 سنة فأكثر يملكون أقل من مستوى التعليم الأساسي مقارنة بـ 32-38 في المائة في بغداد والبصرة على التوالي([10]).
الجدول (2)
دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس في العراق
|
السنة |
الترتيب حسب دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس |
العمر المتوقع عند الولادة |
معدل معرفة القراءة والكتابة بين الكبار |
نسبة القيد الإجمالية في التعليم الأولي والثانوي والعالي |
الحصة من الدخل المكتسب (في المائة) أو القيمة |
قيمة دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس |
||||
|
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
|||
|
1995 |
127 |
59.7 |
57.3 |
45 |
70.7 |
45.4 |
55.1 |
13.9 |
86.1 |
0.443 |
|
1997 |
– |
63.9 |
60.9 |
— |
— |
44 |
57 |
970 |
5347 |
— |
|
1998 |
107 |
65.3 |
62.3 |
43.2 |
63.9 |
44 |
57 |
— |
— |
0.548 |
United Nations Development Program [UNDP], Human Development Report, 1997
أن تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين النساء يعد من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية البشرية. لكن هذه القضية تكتسب خصوصية تنبني على طبيعة المجتمع العراقي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي أثرت وتؤثر في صياغة شكل وطبيعة العلاقة الجندرية. ومهما يكن من أمر فان للنوع الاجتماعي أثره في توصيف المشهد التنموي في العراق وبخاصة وانه لم يجر حتى الآن تفحص وتحليل نظري وعملي شامل ومعمق لقضايا النوع الاجتماعي في البلد، ولم تول أدبيات التنمية البشرية في العراق اهتماما ذا بال بمقولة النوع الاجتماعي، بل اكتفى التحليل على أساس الجنس وهو تحليل أدنى من تحليل النوع الاجتماعي واقل سعة وشمولا.
تشكل الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع العراقي حوالي 11 في المائة من مجموع الأسر المسجلة في دراسة مسح الأحوال المعيشية في العراق. ومن بين تلك الأسر هناك 73 في المائة تعيلها الأرامل([11])، تتفاقم بين صفوفها ظاهرة الفقر.
كان العراق من أوائل البلدان التي حصلت فيها النساء على فرص للعمل في مجالي التعليم والتمريض وبخاصة بعد تأسيس الدولة العراقية. وخلال الثلاثينات نشطت الحركات النسوية الداعية إلى تحرير المرأة متأثرة بالحركة الشيوعية التي طغت على تلك الحقبة. وفي عام 1959 شغلت أول امرأة في العراق منصبا وزاريا([12]). وفي السبعينات بادرت سلطة البعث إلى زج المرأة في خططه السياسية وشهد العراق صعودا في الحركة النسوية في حدود ما سمحت به الدولة. وفي سنوات الثمانينات ومع انشغال الرجل بالحرب كان للمرأة أن تملأ الكثير من الفراغات التي خلفها الرجل بعد انخراط ما يزيد على مليون رجل في القوات المسلحة إبان الحرب العراقية الإيرانية. مع ذلك ظلت مساهمة النساء في سوق العمل خلال الثمانينات منخفضة، زادت تدهورا خلال التسعينات الذي اتسمت سنواته بانخفاض حاد في الأجور الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إن تزايدت انسحابات النساء من العمل.
غالبا ما تستخدم المشاركة في قوة العمل كمؤشر مهم على واقع النساء الاقتصادي. وتظهر الإحصاءات نسبة منخفضة من النساء اللاتي يعمل خارج البيت، ففي عام 2004 كان عدد النساء في قوة العمل 1.1 مليون امرأة من مجموع 6.7 مليون شخص هم في سن العمل. أي إن نسبة مساهمة النساء لا تتجاوز 13 في المائة، تتركز معظم هذه النسبة في المناطق الريفية([13]). من جانب آخر فان نسبة البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال([14]) (24 مقابل 17.2 في المائة)([15]) وهو ما يشير إلى البطالة والأعداد الكبيرة من النساء اللاتي يحاولن دخول قوة العمل.
من جهة ثانية، فان المرأة الريفية تعاني من مشاكل كثيرة، وتحمل أعباءً إضافية بسبب دورها الإنجابي ونشاطها الإنتاجي غير المأجور، وعدم المساواة في الحصول على الأرض والدخل والأسواق. ففي العراق نجد أن الحيازات الزراعية مملوكة للرجال، إذ تمتلك النساء أقل من 5 في المائة من مجمع الحيازات الزراعية عام 2001([16]) لكن النساء أكثر حظا من ذلك في ما يتعلق باستخدامهن كعاملات ذلك أن حوالي 35 من العمال (الدائميين والمؤقتين) في الحيازات الزراعية هم نساء([17]).
إلى جانب المشاركة في قوة العمل، يعتبر التعليم مؤشرا رئيسا على أوضاع المرأة، وعاملا حاسما فيها، لان الوصول إلى المستويات التعليم سوف يزيد بشكل عام أدوار اتخاذ القرار التي تضطلع بها النساء، ويجعلهن مرشحات أكبر في قوة العمل، ويمكنّهن من اتخاذ قرارات متنوعة بشأن الخصوبة والرعاية الصحية. كما أن التعليم يعتبر أساسي لزيادة وعي النساء بحقوقهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية([18]). وتبرز هذه الحقيقة من خلال معرفة إن التعليم قد زاد من نسبة مساهمة النساء في قوة العمل، إذ ترتفع المشاركة مع زيادة مستويات التعليم، فتنشط النساء المتعلمات لمدة أطول([19]). مع ذلك تبلغ نسبة النساء اللاتي لم تلتحق بالتعليم حوالي 31 في المائة في حين هناك 8 في المائة من النساء أكملن دراستهن الجامعية([20]). كما تعتبر نسب التحاق الإناث في المدارس الابتدائية منخفضة جدا مقارنة بالذكور. وقد أصبحت فجوة النوع الاجتماعي أكبر بكثير في المناطق الريفية، فحوالي 40 في المائة من الإناث في هذه المناطق غير ملتحقات بالمدارس الابتدائية، مقارنة بحوالي 20 في المناطق الحضرية([21]).
تدهور النظام الصحي
قطع التقدم الصحي في العراق خلال النصف الثاني من القرن العشرين شوطا طويلا ساعد على تزايد نسب السكان بشكل واضح. وتمثل أحد أبرز سماته التحسن في الحد من تأثير عدد من الأمراض السارية والمتوطنة وأمراض الأطفال (الإسهال، الحصبة، الكزاز..الخ). وتجسد التحسن الصحي بتوسع استخدام الأنواع العديدة من لقاحات الأطفال([22]). وفي ثمانينيات القرن الماضي كان العراق يمتلك أفضل نظام رعاية صحية في المنطقة، بأساليب متطورة وباستخدام التقانة (التكنولوجيا) المختصة في مجال الرعاية، كما أنه كان يتمتع بشبكة شاملة من الرعاية الطبية الأساسية([23]). وكان العراق يمتلك حوالي 1800 مركز صحي قبل حرب عام 1991، انخفض هذا الرقم إلى 929 عام 2001 وكان ثلث هذه المراكز بحاجة إلى إعادة تأهيل([24]). نتيجة تدهور نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الإنفاق العام لصالح زيادة الإنفاق العسكري إبان الثمانينات والتسعينات مدفوعا بظروف الحرب وتزايد زخم الهاجس الأمني في الأداء الحكومي.
منذ بدء الحصار بدأت المشكلات تظهر على قطاع الخدمات الطبية، ومع انهيار نظام الخدمات المدنية ترافق انهيار النظام الصحي في ظل ضعف قدرة المواطنين على اقتناء مواد التلقيحات من السوق التجارية، مما أدى إلى تزايد الالتهابات المرضية والأمراض وخصوصا بين الأطفال دون سن الخامسة. واتسمت المراكز الصحية والمستشفيات بندرة الخدمات العلاجية كالعمليات الجراحية ومختبرات التحليل والأجهزة الملحقة كالأشعة والتجهيزات والمعدات الطبية بالإضافة إلى النقص الشديد في الأدوية، وتقلص عدد الأطباء بشكل واسع، فضلا عن تدهور أوضاع التعليم الجامعي والمهني للعلوم الطبية والإرشاد الصحي، وتراجع نصيب القطاع الصحي من التخصيصات المالية إلى 5 في المائة قياسا لحجم التخصيصات لعام 1989. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن خمس سنوات من الحصار أفرز تراجع القطاع الصحي لنصف قرن إلى الوراء.
وطبقا لمنظمة ميداكت MEDACT الطبية العالمية المستقلة فان الصحة العامة للشعب العراقي تدهورت منذ حرب الخليج الثانية عام 1991. فقد خلفت العقوبات والحروب آثار على تركيبة البلد البنيوية، وتفككت التركيبة الاجتماعية أيضا بسبب القمع والاضطهاد، والفقر والعنف، والبطالة، وطبيعة العلاقات العائلية، وهي عوامل أثرت في الصحة العامة للمجتمع وفي تطور الفرد العراقي. كما أضرت هذه الحرب بالشعب العراقي الذي كان وما يزال هشا بقدراته لبناء مجتمع جديد، ناهيك عن تحمل صدمة حرب جديدة. وتؤكد المنظمة أن الحرب قد أدت إلى مقتل وإصابة الألوف من العراقيين المدنيين والعسكريين، وسببت تدهور الصحة العامة إلى الأسوأ، كما ساعدت على انتشار الأمراض واختلال التوازن البيئي. وفي ظل زيادة العنف وعدم الاستقرار، فان المخاطر تزداد خصوصا على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. وبقطع النظر عن التأثيرات المباشرة، أدت الحرب إلى تحطيم شبكات المياه والمجاري والكهرباء والإسكان، واستمرار دمارها. وسببت شحة المواد الغذائية استمرار معاناة الشعب على المديين القريب والمتوسط. وهناك مخاوف من زيادة البطالة وتأثيراتها في انتشار الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي([25]).
ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة سببها الحرب بحوالي 223000 فرداً، وفي الحرب الأخيرة أصبح عدد الأطفال وكبار السن والنساء، الذين أصيبوا بعجز، أكبر من العدد الذي خلفته الحروب السابقة([26]). إذ ما يزال ربع أطفال العراق يعانون من سوء التغذية، في حين يولد ربع المواليد الجدد بوزن تحت الوزن الطبيعي، وتصل نسبة تفشي سوء التغذية الحاد (الوزن منخفض نسبة إلى الطول) أعلى مستوياتها في الجنوب وبشكل خاص محافظة القادسية حيث يعاني 17 في المائة من الأطفال من سوء التغذية الحاد([27]). في حين قدرت الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعانون من تبعات الاضطرابات النفسية والعقلية بأكثر من نصف مليون شخص عام 1998 بعد أن كان حوالي مائتي ألف مطلع التسعينات([28]). كما أن أطفال العراق هم ((الأكثر معاناة بين أطفال الحروب))([29]) فغالبيتهم سيعانون من مشكلات نفسية شديدة في حياتهم([30]). ويبدو أن الزمن لن يرحمهم، فالحرب وما تبعها من نتائج وأحداث تبدو ذات أضرار وأخطار أكبر على هذه الفئة الحساسة من السكان. كما اضطرت النساء العراقيات اللاتي فقدن الأزواج أو الأبناء أو الأشقاء في الحروب إلى تحمل عبء ثقيل، فأكثر من 10 في المائة من العراقيات أرامل، وغالبا ما يكن الوحيدات اللاتي يحصلن على أجر في العائلة. لقد فاقمت العقوبات من حالة الضعف الاقتصادي للنساء وزاد من المشكلات الصحية والنفسية لديهنَّ([31]).
لقد ترتب على الحروب وتأثيراتها في متغيرات التنمية البشرية انعدام التماسك الاجتماعي بين السكان، والذي كان بدوافع نفسية، وقد تجلت مظاهره في نواحٍ عديدة، أهمها: ارتفاع نسبة الطلاق، تزايد حالات اشتغال الأطفال في سن مبكرة، استفحال ظاهرة التسول والاحتيال وتصنع العوق والإصابة، وبينهم أعداد غير قليلة من الأطفال. ارتفاع معدلات الجرائم، ومنها الجريمة المنظمة، وجنوح الأحداث والسرقة، حيث زاد عدد المودعين في الأقسام الإصلاحية بنسبة 217 بالمائة عام 1998 قياسا لعام 1990. تفشي الدعارة ولا سيما بين الشباب من الجنسين. شعور عام باليأس والقلق حيال المستقبل، تدهور الحالة الثقافية والتعليمية، تضاعف الإحساس بالعزلة بغياب الاتصال مع العالم الخارجي، تفاقم ظاهرة الرشوة والفساد الإداري، وتطور اقتصاد غير متوازن مفعم بالاستغلال والإجرامية([32]).
وبالاستناد إلى المؤشرات الأكثر شيوعا وتركيبا في ما هو متوفر منها ويوفر دلالة مناسبة في المجتمع العراقي سوف نركز على مؤشرات التنمية البشرية بغية الوقوف على أداء التنمية البشرية. لقد تم تركيب مؤشر التنمية البشرية ليربط بين أعمار الناس (مقاسا بالعمر المتوقع عند الولادة) ومعارفهم (توليفة من معدل القراءة والكتابة بين البالغين ونسبة القيد الإجمالي في التعليم الابتدائي والثانوي) ومستويات معيشتهم (مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما قد يخضع للتغير من سنة لأخرى.
تراجع المستوى العمري
تشير المعطيات إن توقع الأعمار عند الولادة في العراق قد ارتفع من 44 عاما للمدة (1950-1954) إلى 62 عاما للمدة ما بين (1985-1990)، ما يعني أن معدل الزيادة السنوية لتوقعات الأعمار تزداد 0.52 عاما سنويا. وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فانه كان مقدرا للمعدل العمري في العراق أن يصل إلى 68 سنة في نهاية القرن العشرين. وتلك التوقعات كانت مبنية على معدلات الزيادة السنوية لانخفاض نسب وفيات الأطفال عند الولادة وأعمار الأطفال دون سن الخامسة من العمر للحقبة ما قبل الحصار. غير أن ملامح تلك الصورة قد تبدلت بسبب التطورات التي طالت حياة الإنسان بعد فرض العقوبات الاقتصادية. فالمقياس الأساسي لمعرفة تطورات عمر الإنسان عند الولادة قد تغير بسبب ارتفاع معدلات وفيات الأطفال([33]). وطبقا لتقرير التنمية البشرية في العراق، فان العمر المتوقع للإنسان قد انخفض إلى 60 عاما عام 1993، وهو ما يقارب مستويات الأعمار عند الولادة عام 1975. في حين قدر تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي المعدل بـ 57 عاما عام 1997، ورجحت تقديرات أخرى انخفاض العمر إلى 55 عاما عند نهاية القرن العشرين، وهو ما يقارب معدل عمر الإنسان عند الولادة لعام 1965، وأدنى من المعدل لسكان العالم العربي بحوالي سبع سنوات([34]). وإذا ما قارنا بين معدلات الأعمار في حالة استمرار انخفاض الوفيات قبل الحصار، وتوقع أنها ستصل إلى 68 عاما في نهاية القرن الماضي، وبين توقع انخفاضه إلى حوالي 55 عاما مع استمرار الحصار، نرى أن الفرق الزمني يصل إلى ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف من التراجع. ولكي تعود معدلات الإعمار إلى ما كانت عليه حتى عام 1990، فان ذلك يتطلب وفقا لمعدلات الدول النامية في الإضافة السنوية لزيادة معدلات توقع العمر تقدر بـ 0.48 عاما في الأوضاع الطبيعية، فانه يحتاج إلى 18 عاما على الأقل. ومع أخذ مجموع الخسائر التي تشتمل على التراجع الزمني وما يتطلبه تعويض ذلك التراجع، فإن كلفة التراجع الإجمالي تتجاوز النصف قرن من التاريخ العراقي الحديث. الأمر الذي يعكس الحالة الحرجة للتنمية البشرية وعنصرها الحساس العمر المتوقع للإنسان عند الولادة([35]).
وتشير تقديرات احتمالية موت الأطفال في العراق إلى أن الأطفال العراقيين الذين ولدوا خلال الحقبة (2000-2005) سيبلغون منتهاهم قبل بلوغهم سن الأربعين بحوالي 18 في المائة، وينضوي تحت هذا الاحتمال حوالي ثلاثة أضعاف المستوى المقدر في الأردن وسوريا ([36]).
لقد ازدادت معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع من 40 لكل حالة ولادة عام 1990 إلى 107 مولود لكل 1000 مولود حي عام 2001([37])، والى 193 عام 2004، وهي معدلات أعلى مما كانت الحال عليه في العراق عام 1960. وان نسبة وفيات المواليد (حالات وفاة الأطفال دون السنة لكل 1000 من المواليد الأحياء) هي 32 في المائة. في الجانب الصحي نلاحظ وفيات الأطفال الرضع في الجنوب هي أعلى المعدلات في العراق فقد بلغت في البصرة (1479) وبابل (498) وكربلاء (399) والقادسية (289) وهذا دليل على مدى التدهور الصحي في هذه المناطق. ويمكن تتبع هذا التدهور من خلال عدد المستشفيات والعيادات الشعبية فقد بلغ عددها 79 مستشفى وعدد الأسرة فيها 10880 سرير وما نسبته 38 في المائة من عدد الأسرة في العراق.
|
الشكل (2) وفيات الأطفال الرضع لعام 2003 |
|
|
|
الشكل من إعداد الباحثين بالاستناد إلى البيانات الواردة في الجهاز المركزي للتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية 2004 |
خلال السنوات الأربع الأولى من الحصار تضاعفت معدلات الوفيات بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة ست مرات عند نهاية السنة الرابعة من الحصار([38]). واستمرت بالارتفاع حتى وصل إلى 107 لكل 1000 مولود حي عام 2001. وتبلغ نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 من المواليد الأحياء حوالي 40 في المائة الأمر الذي جعل العراق في مؤخرة دول العالم من حيث تخفيض معدلات وفيات الأطفال([39]).
أما خلال العقد الماضي، فقد تضاعفت معدلات وفيات الأمهات في العراق ثلاث مرات فبلغت 370 وفاة لكل (100000) من المواليد الأحياء. وكان ما يناهز 70 في المائة من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، مما يعرضهن لخطر الوفاة والاعتلال. وعلاوة على ذلك أعربت وكالات المعونة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع مستوى حالات الإجهاض والمواليد الميتين، الذي زاد من حدته ارتفاع مستويات الإجهاد وقلة العناية السابقة للولادة ورعاية التوليد في الحالات الطارئة([40]).
وطبقا لنتائج المسح المشترك بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية عام 1995 لأوضاع الأطفال دون سن الخامسة من العمر فان حالات إعاقة النمو والتشوهات البنيوية ازدادت من 12 في المائة عام 1991 إلى 28 في المائة عام 1995، كما ازدادت نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض من 7 في المائة إلى 29 في المائة، وتضاعفت حالات الهزال أربع مرات أي من 3 في المائة إلى 12 في المائة للمدة نفسها. أما أعراض سوء التغذية للأطفال دون سن الخامسة من العمر، فقد بين تقرير منظمة الغذاء والزراعة عام 1995 أن حالة الأطفال في العراق تبدو مروعة. فحالات الخواء وأعراض نقص الغذاء ازدادت بنسبة 50 مرة في السنوات الأربع الأولى من الحصار.
ومن الناحية الأخرى، تعد النساء بمختلف الأعمار شديدة الحساسية لنقص الأغذية، وخصوصا خلال مدة الحمل والرضاعة. فيمكن أن تنقل الأمهات الحوامل أعراض سوء التغذية للولادات الجديدة، وينعكس ذلك بإحدى صوره بالولادات المنخفضة الوزن. وفي حالة استمرار الظروف الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية نفسها، فمن شأن ذلك أن يجرد الأطفال من قدراتهم العقلية والجسدية([41]). على أن تفشي ظاهرة نقص التغذية لدى الأمهات وعلاقتها بتنامي وفيات الأطفال الرضع يعكس الحالة الصعبة للأمهات في مواجهة أوضاع الحصار. ومن المؤلم أن الإجهاض لحالات الحمل يعد هو الآخر واسعا ويفضي إلى تعدد إسقاط الأجنة الميتة. كما أن انتشار نسبة الوفيات للأمراض الوراثية (MMR) وارتفاع معدلاتها منذ عام 1991 وتشوهات خلقية أخرى أمر يثير الهلع حول مستقبل الطفولة في العراق([42]).
أما الأمراض الوبائية فقد وجدت طريقها يسيرا للانتشار السريع في ظل غياب الوقاية المناسبة. فالملاريا التي كانت محدودة الانتشار قبل عام 1990 بدأت بالظهور عام 1992 وأخذت شكل موجات في مختلف المناطق العراقية عام 1994، حتى تضاعفت نسبة أمراض الملاريا بأكثر من 12 مرة عام 1994 قياسا لعام 1989 في المحافظات الوسطى والجنوبية وأكثر من 20 مرة في المحافظات الشمالية الثلاث. وتزايدت بشكل واسع أمراض الولادات الوراثية، والأمراض الجلدية والتهابات الأمعاء. أما أمراض الكوليرا والتايفوئيد فقد تضاعفت الأولى إلى ما يقرب من ثمان مرات في حين تضاعفت الثانية بأكثر من 12 مرة، وتزايدت بنسب كبيرة أمراض شلل الأطفال والسعال الديكي والخناق والحصبة والتهاب السحايا وبنسب مقاربة لنسب تزايد الأمراض السابقة([43]).
تدهور خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
كانت منظومات خدمات الماء والصرف الصحي للحقبة التي سبقت عام 1991 تعمل بفاعلية، إضافة إلى إن نسبة السكان الذين يحصلون على الماء الصالح للشرب كانت تصل إلى 95 في المائة في المناطق الحضرية و75 في المائة في المناطق الريفية، أما عدد وحدات معالجة المياه فكانت (218) وحدة رئيسية في عموم البلاد و 1.191 وحدة مجمعة. في حين كانت خدمات الصرف الصحي تغطي 75 في المائة في المناطق الحضرية و 50 في المائة من المناطق الريفية([44]). مع ذلك فقد اتسم الإنفاق الحكومي لتوفير مياه الشرب النقية للسكان بالضآلة قياسا بأهميته، فهو لم يتعد 0.35 في المائة من مجموع الإنفاق الحكومي خلال المدة (1980-1990). أما نصيب الفرد من الماء الصافي فقد بلغ 46 متر مكعب عام 1980، ليصل إلى 70 متر مكعب عام 1992 بعد إصلاح مشاريع تصفية المياه. غير أن نوعية مياه الشرب تعد منخفضة بسبب نقص مادة الكلور حيث نقصت كمية الاستخدام من 5 ملغم للتر الواحد إلى ملغم واحد للتر الماء. والمشكلة الأكثر جدية تحملها مشاريع المجاري والصرف الصحي للغالبية الساحقة للمدن والمجمعات السكانية. وتشمل المشكلة جميع خدمات الصرف الصحي كالمجاري الرئيسية ومحطات الضخ، ومراكز التصفية سواء في الريف أو المدينة([45]).
أما في الحقبة التي تلت عام 1991 فقد بدأ التراجع في مستوى هذه الخدمات ومستوى أدائها. ومن خلال مقارنة رقمية لمفاصل هذه الخدمات نلاحظ مدى التراجع الحاصل فيها حيث تشير الدراسات الحديثة والمسوحات للسنتين الأخيرتين إلى إن هناك 34 وحدة فقط لمعالجة المياه تعمل بشكل جيد من اصل 177 وحدة. كما إن خدمات تجميع مياه المجاري ومعالجتها وان كانت تشمل 80 في المائة من سكان مدينة بغداد إلا إنها تتراجع في المناطق الحضرية المحيطة ببغداد لتصل تغطيتها إلى 9 في المائة فقط من هذه المناطق. في حين لا توجد خدمات للصرف الصحي في المناطق الريفية في عموم القطر وبالأخص المناطق الشمالية. وإزاء هذا الوضع المتردي فان خدمات الصرف الصحي أصبحت تشكل خطورة بيئية وصحية كبيرة, تثقلها وتزيد خطورتها ما يصيب مفاصلها الرئيسية كتآكل أنابيب المجاري وضغط المياه الجوفية والطفح والانسداد لأغلب خطوطها مما يتسبب في تلوث الماء الصالح للشرب وما ينعكس عن ذلك من تفشي للأمراض الخطرة والانتقالية منها، ومن الملاحظ إنه لا توجد وحدات فعالة لمعالجة المياه المصرفة حيث إن 50 في المائة من المياه المصرفة توجه إلى الأنهر والممرات المائية مما يحمل آثارا خطرة على الإنسان والحيوان وتساهم بغداد وحدها بما نسبته 75في المائة من هذا التلوث وما يرتبط به من مشاكل بيئية وصحية([46]).
وتواجه معظم المدن العراقية الآن خطر انهيار الخدمات، فشبكات الصرف الصحي تعاني من التدهور وانعدام الصيانة، وعدم السيطرة على عمليات الطفح وانهيار وتحطم الأنابيب.
لقد التزمت الحكومة باستعادة المواصفات ومستوى أداء خدمات الماء والصرف الصحي التي كانت موجودة قبل عام 2003 من خلال سعيها لتوسيع إمكانية الحصول على الماء بصورة دائمة, ومن بين المجالات المستهدفة لتحقيق ذلك وكأنشطة طارئة هو توفير صهاريج نقل المياه إلى المناطق الأكثر حرمانا وخاصة في المدن الجنوبية. كما جرى التأكيد على ديمومة الرقابة على نوعية المياه في عموم القطر, وتوفير المستلزمات الكيماوية لمعالجة المياه ومستلزمات جمع النفايات([47]).
تحميل البحث كاملا (https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13847)

